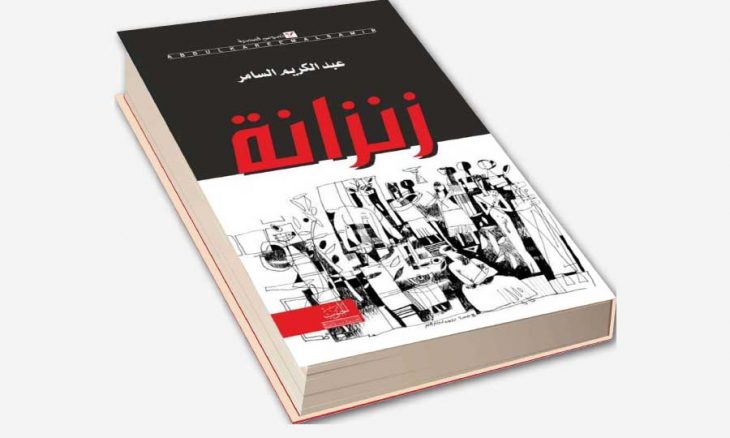
رؤى عامّــة
سؤال يحضر عند كل مقروء في حقل الأدب، وهو من أسئلة الثقافة والمعرفة، القصد منه تجلي الانعكاس الذي يتركه النمط في الكتابة من أثر في القارئ، لاسيّما القارئ الناقد. السؤال لماذا؟ وكيف ينبثق النمط؟ وما هي مبررات ظهوره؟ ثم الصيغة الجديدة التي أتى بها؟ إنها أسئلة فرضها كتاب القاص عبد الكريم السامر المعنوّن «زنزانة». ولم يذكر تعريفاً لنصوصه، لكن ما احتواه من عتبات أشار إلى أنه ينتمي إلى قصة الومضة. فالنمط حين يظهر تتسبب في ظهوره عوامل موضوعية، لعل البنية النفسية أهم المؤثرات. فالتباس الواقع بجملة ظواهر قاهرة، تُغيّر المزاج وتحيله إلى حالة من الاستقبال جديدة، غير رافضة للأنماط الأُخرى، بقدر ما تستهوي النمط الذي يوجه الحقيقة، أو الصورة بأقصر الطُرق، لأن الزمن رغم اتساعه، إلا أنه مضغوط بجملة عوامل محبطة للذات، وهو شأن يبرر الأُسلوب والنمط. كما أن ظهور إشكال الكتاب، الذي يعتبر ناتالي ساروت هي أول من ابتكر نمط القصة القصيرة جداً مثلاً، يقع في الإشكال، ذلك أن هذا النمط، ووفق كل الاشتراطات، كان يمارسه الحكيم (إحيقار) الآشوري في كتابة نصوص قصيرة على لسان الحيوان، أو يضمّن بعضها الحِكَم والأمثال والرؤى الفلسفية. كما لابد من التأكيد على أن ظهور النمط، لا يُلغي بقية الأنماط، بل هو مستقل بذاته، خاضع لذائقة معينة، وللنصوص الأُخرى وفق أنماطها كذلك. لذا فجدلية الوجود المعرفي تُحتم هذا الظهور. فنص الومضة، نص فيه تعقيد، يندرج في القدرة الذاتية على صياغته، وإلا كان نوّعاً من المودة في الكتابة المكللة بالانفعال، وليس الضرورة الموضوعية والفنية.
في ما يخص كتاب السامر، أكد الناشر على خصوصية هذه الكتابة، ونؤكد أن الكاتب بدأها في «ثلاثية الشجرة»، وكان لنا رأي في حينه. فالنصوص أتت على جملة خصائص، منها على سبيل المثل لا الحصر:
ــ العنوان، فهو جامع لكل النصوص من باب مجموع الظواهر في مفارقاتها وتناقضاتها. أما من باب النص، فيشهد لذلك آخر النصوص الذي عنون بـ«زنزانة». ونرى أنه بهذه الصيغة من إلغاء (أل) التعريف، أكد على الشمول لا الحصر. فلو كان (الزنزانة) لكان القصد إنها الوحيدة المعنية، وهذا احتمال، فهو تخصيص لمكان وزمان، وبدون التعريف اتسعت دائرته، لتصبح كل الأمكنة (زنزانات). النص يقول «خارج الزنزانة، العالم يتسع». هذا ما يخص النسق اللغوي للنص، فهو قد عرّف المكان، ليضعه معادلاً لخارجه، فبين الضيق والسعة مسافة لا تقدر برقم ما. غير أن عتبة النص كانت شمولية، كما هي عتبة الكتاب القصصي.
ــ كان قربها من الواقع واضحاً وجلياً، أي أنها لا تجنح إلى المخيلة في صياغة الظاهرة، وإنما تتلمس الظاهرة بحس الواقع، لذا ـ كما سنرى ـ إن جملة النصوص عالجت ظواهر نعرفها ونتلمس نتائجها وتأثيراتها علينا عبر أقصر الأزمنة.
ـ نمط الاقتصاد في تركيب الجُمل واضح أيضاً. وهو نوّع من الاقتصاد الذي يوحي بالمعنى في أقصر السبل. كما أنه معني بعكس الظواهر وفق أنماطها التي فرضها الواقع. فبدون التفاصيل لا يعني عدم إرسال المعنى، بل إنه يُحرك الذهن ويُنشط العقل، لغرض مداولة المطروح في الجمل القصيرة هذه. أي أن ـ الاقتصاد ـ عمل بدور الحرث في الذاكرة والفعل الآني المرتبط بمجموعة ظواهر. لذا يستحق أن يكون فعلاً تحريضياً.
ـ الدهشة ليس من باب كشف الظاهرة بأقصر الجُمل، وإنما فرادة حراك الذهن في التقاط الصوّر. ففي كثير من الأحيان يذكر المتلقي؛ أنه يرى كل هذا، لكنه لا يستطيع التعبير عنه. إذن القاص هنا أمسك بالقارئ حيث تكون إرادته ورغبته في التلقي. وبالتالي قدرته على التأويل. لأن التأويل لا يقتصر على كُتل المعرفة، بل على حذاقة المتلقي وسرعة بديهيته في فهم ما يراه.
ـ الحدث هنا مقتضب، وربما يأخذ من الأكبر هامشاً، ومن الهامش جزءاً. لذا نرى في أحداث النصوص مستلات ذهنية فائقة الحذاقة والفطنة، وذات قدرة على إنجاب الحراك الذهني عند الآخر. حدث مقتضب لماح ومركز، لكنه دال على سعة المعنى. وهذا يتوقف على المستقبِل حصراً، وإمكانياته العقلية في التفسير والمقاربة.
ما نعنيه بالخاصّة، تلك التركيبات اللغوية «قصة الومضة»، وما ترسله من معان عبر تشفير في منتهى الاقتصاد والشعرية. إن الذي ينتظم داخل كل نص، هو مقدار الدلالة المرتبطة بالظواهر الاجتماعية والسياسية والنفسية.
ـ في ما يخص الزمان والمكان، فقد أكد المؤلف في مقدمته على إلغائهما في النص. ونؤكد على (في النص)، لكنهما مؤثران بشكل غير مباشر، اعتماداً على حقيقة، أنه لا حدث بدون زمان ومكان. ففي ما يقصده الكاتب ونقصده نحن، هو عدم وجود التفاصيل التي تُعين النص على النهوض، لكنه وفق شروط قارّة، يعتمد على مؤثرات الزمان والمكان فقط.
رؤى خاصّـة
ما نعنيه بالخاصّة، تلك التركيبات اللغوية «قصة الومضة»، وما ترسله من معان عبر تشفير في منتهى الاقتصاد والشعرية. إن الذي ينتظم داخل كل نص، هو مقدار الدلالة المرتبطة بالظواهر الاجتماعية والسياسية والنفسية. فنص الكاتب حمّال وجهين تفصل بينهما تعبيرياً فاصلة دقيقة لا تُبعد طرفا عن آخر، بقدر ما تعمل على تآزر الطرفين ببلاغة لغوية. ولنر:
ـ فـ(عندما يكتب يرسمه القلق) تعني بالعلاقة الجدلية بين الكتابة وظاهرة القلق. فهو قلق موجب، يقصد به عدم الاكتفاء بطرح معيّن، وإنما يحدث، حين تدور الأفكار وتتناغم، وتتناقض لترسم صورة أكثر حيوية للمكتوب من أجله. لذا عنى النص بالظاهرة الأكثر هيّمنة على الكاتب، ونعتها بالقلق، يعني الحراك الذهني الذي ترسله العواطف والأحاسيس والعقل، باحثة عن الاستقرار. وهذا بحد ذاته سمة تفتح مجالات للنص لكي تتسع مساحته.
ـ (وصل إلى الصفحة الأخيرة، رماه). وهنا واضح المعنى، فالكتاب يخضع للقيمة، القارئ مخيّر وفق خصائصه الذاتية إزاء محتواه. فالذي قاله النص، هو رفض المقروء. وهذا بحد ذاته يدعو للتفكير من قبلنا وفق أسئلة موجبة: لماذا رماه؟ وهل كان محتواه سيئاً؟ وإذا كان كذلك، فأين يكمن السيئ؟ وكثير من الأسئلة التي خلقها محتوى الكتاب، إنه نص تنفتح صفحاته للتحاور.
ـ (نظر إلى الهدف، سبقه الخوف) وهو القلق نفسه إزاء الكتابة، لكن الكاتب هنا معني بالأهداف مهما كان نوعها. هذه النهايات المقتربة من بعضها تخلق خوفاً، بل حرصاً على النتائج.
ـ (أطلق فرَحَهُ، ساقوه نحو الجبهة)، عالم مشتبك يرتبط بالتاريخ العراقي الذي شهد حروبا عدّة. فعبر جملتين لخّص الكاتب ظاهرتين في التاريخ البشري. وهو قدر العراقي أن لا يستقر وينعم بالراحة طالما تتعاقب على دفة حكمه سلطات جائرة. أليس هذا متسع لحضور ما حفظته الذاكرة من ويلات ومحن؟
ـ (رأى صورته على الماء، نسي الرحيل)، ولهذا علاقة بالإخصاب، فالماء يرتبط بالنهر، والنهر بجريانه يُخصّب كل الموجودات في الطبيعة. فبين الرحيل والنسيان مسافة واهنة في النص. فالصورة تقترب من مرآى (دينوسيس) وهو يرى وجهه لأول مرة على صفحة ماء النهر فيعشقها. في النص كان الماء داعيا لاسترداد القيمة الذاتية أيضاً. لكنها هذه المرة كانت الصورة دافعاً لعدم المغادرة والبقاء الأزلي على البقعة الأُم.
ـ (فقدتُ البوصلة… تاه البحر عنّي)، وهنا ثمة مفارقات عدة. فبدلاً من أن يقول (ضعت) مثلاً، أو (ضيّعت الرؤية) أو الطريق. قال (تاه)، كذلك لم يقل (تهت)، بل (تاه البحر)، وهنا تكمن بلاغة النص. فالمتسع والمطلق يضيع عن مرمى الرؤية. هذه المفارقة ما بني عليها النص.
ـ (حين أنظر إليها، ألمح ظلي)، وهنا تكمن صورة الاتحاد العاطفي. فالظِل شبيه الأصل ودالّة عليه، فهو ملازم للشخصية. فالتشبيه هنا بليغ جداً، ويكشف عن قوة العلاقة بين كائنين.
ـ (حين لاح النصر، حاصرتهم الخيانة)، هذا النمط من التوالي يخص البنية السياسية. والقاص يختصر جملة الحقب من التاريخ، حيث يكون الخطاب السياسي ندّاً للانتصار، بل خالقاً للإحباط والخيانات بتعدد أوجهها.
ـ (كلما اشتقت إليها، قبّلت شاهدتها)، وهنا اختصار لجملة من المشاعر التي تربط بين الموجود والراحل. هذه العاطفة اختصرت الصراع الذي يداخل المحب حين يتذكر حبيبته. فهو اختصار واكتفاء بزيارة قبرها وتقبيل شاهدته، هو الدليل الأسمى والأرفع عن كل التفاصيل. وتلك وظيفة قصة الومضة بحق.
ـ (غاب عنها، تمسكت بظله)، وهي لا تختلف عن سابقتها، بل تعمّق ظل الشخص الذي هو دالّة عليه.
ـ (عبر الحلم، وجد الوطن ممزقاً)، وهنا ثمة مرميين، الأول متعلق بالأحلام، سواء أحلام اليقظة أو النوم. فهما حالتان تُبعدان المرء عن واقعه. في النص كانت الكارثة التي كشفت عن دمار الوطن. فبين الحلم والواقع بون شاسع. هذا ما أرد النص قوله، حيث تتسع المسافات والدوائر.
ــ (عندما صفق الجمهور، نسي القصيدة)، وفي هذا تكمن علاقة الشاعر بجمهوره. والنسيان هنا ليس نوعا من السلب، وإنما دال على إيجابية، لأنه يعني الانغمار بسيّد المشهد، هو الجمهور الذي لم تقله القصيدة. فالنسيان مركب أتى من الاتحاد الصوفي بأصوات الجمع، وهو ما ينتظره الشاعر من قصيدته.
ـ (حين يرهقه الشوق، يُقبل الوسادة)، وهنا تكون الوسادة بديلا عن شاهدة القبر، ودليل عمق العلاقة بين اثنين.
من كل ما تداولنا من نصوص وغيرها، تستوقفنا لازمة واحدة تتشعب بالتداول إلى لوازم عدّة، إن نصوص القاص حمّالة وجهين، يفرزان صوّرا عديدة تكشف عن ظواهر اجتماعية وسياسية ونفسية مشتبكة. هذا الجمع والتلميح هو سر قيمة نص الومضة، الذي لم يُشكل الكاتب في أُسسه، وإنما اجتهد في صناعة عوالمه، وخلق الاتساع الممكن الذي يواجه المتلقي، لذا فهي نصوص محركة لذهنية المستقبل لها.
٭ كاتب عراقي
يعد الجنس الأدبي مبدأ تنظيميا ومعيارا تصنيفيا للنصوص ومؤسسة تنظيرية ثابتة تسهر على ضبط النص وتحديد مقوماته ومرتكزاته وتقعيد بنياته الدلالية والفنية والوظيفية من خلال مبدإ الثبات والتغير وهنا تكمن اهمية الجنس الادبي وهو ليس بدعة