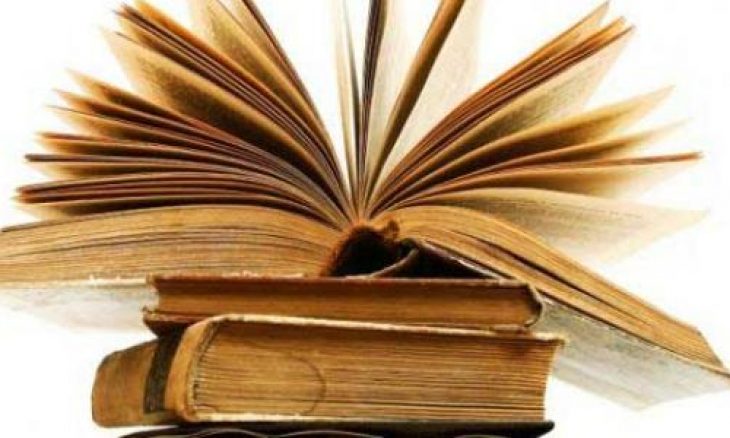
يحفل كثير من الشعر العربي الحديث، بأسماء أعلام عرب وأجانب؛ وبعضها سائغ مقبول، يقوم له سند من القصيدة، وينمّ عن قوّة الصنعة وانبعاث مادّة الشعر. وبعضها حشو لا يسوّغه النصّ، ولا موجب له؛ ولعلّ مردّه عند طائفة من الشعراء إلى نوع من الإيهام بالمعرفة، أو ادّعاء الشاعر ما لا يملك. وعند هؤلاء قد يسهل استبطان ما يجري في نفس الشاعر وهو ينشىء قصيدته كلّما وقفنا على أنّها ليست أكثر من تأليف لعناصر منفصل بعضها عن بعض؛ وأنّ هذه الأسماء ليست أكثر من حلية أو زينة، أو هي طاق زخرفيّ هو مجرّد رسم في جدار قائم؛ أعني نافذة مرسومة لا تفتح على شيء ولا على فضاء.
على أنّ ظاهرة الأسماء قديمة في الشعر العربي، وكانت إحدى قضايا النقد. ولنا في هذه الأمثلة القليلة أن نتبيّن ما إذا كان الشاعر يسوق الاسم عفوا، أو هو يثبته بعد إحكامه في نفسه؛ أو هو من عيوب الصنعة ونقصها البيّن، أو أنّ الأمر بديهة وارتجال؛ والبديهة تقتضي أن يفكـّر الشاعر يسيرا ويكتب سريعا، إن حضرت آلة الكتابة “لأنّ البديهة فيها الفكر والتأيّد”، على حين أنّ الارتجال انهمار في الكلام وتدفـّق، لا يتوقـّف فيها قائله. ويذهب الجاحظ إلى أنّ كلّ شيء للعرب بديهة وارتجال أشبه بالإلهام، “وليست هنا ك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة ولا استعانة…فما هو إلاّ أن يصرف [العربي] وهمه إلى جملة المذاهب… فتأتيه المعاني إرسالا، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا ؛ ثمّ لا يقيّده على نفسه…وكانوا أمّيين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلّفون…” والحقّ ليس من اليسير الإقرار بأنّ كلّ ما هو بديهة وارتجال طبع، وكلّ ما هو معاناة ومكابدة، صنعة؛ إذ بإمكان الشاعر أن يرتجل، لأنّ عمله أعدّ “شفويّا ” أو ذهنيّا في صمت، تحت رقابة “الأذن الدّاخليّة”.
وقد أوردت في مقال سابق حكاية أبي تمّام حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة الكندي فيلسوف العرب:
إقدامُ عمْرٍو في سماحةِ حاتمٍ / في حِلْم أحنفَ في ذكاءِ إياسِ
فقال له الكندي : ” ما صنعت شيئا، شبّهت ابن أمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين بصعاليك العرب. ومن هؤلاء الذين ذكرت ؟ وما قدرهم ؟ “
قال ابن رشيق : ” فأطرق أبو تمّام يسيرا وقال:
لا تنكروا ضربي له من دونه / مثلا شرودا في النّدى والباسِ
فالله قد ضرب الأقلّ لنــوره / مثلا من المشكاة والنّـبراسِ
وعلّق : “فهذا أيضا، وما شاكله هو البديهة. وأعجب ما كان البديهة عند أبي تمّام لأنّه رجل متصنّع، لا يحبّ أن يكون هذا في طبعه”.
وممّا يعزّز ذلك في السياق الذي أنا به سعيه إلى التوافق بين القافية واسم الممدوح أو المرثيّ أو المهجوّ أو المتغزّل به. وهو أقرب ما يكون إلى ما أسماه ابن رشيق ” الاطّراد:”ومن حسن الصّنعة أن تطّرد الأسماء من غير كلفة، ولا حشو فارغ؛ فإنّها إذا اطّردت دلّت على قوّة طبع الشّاعر”. وأورد فيه شواهد تشغل الأسماء في بعضها، البيت كلّه؛ وفي بعضها جزءا منه. يتّسع هذا التوافق بين الاسم والقافية عند أبي تمّام لسائر الأغراض، ولكنّه يتجلّى كأظهر ما يكون في المدح.
فمثلما ألبس الله نوحا فضل نعمته، لأنّه كان عبدا شكورا ؛ يثني الشاعر على ممدوحه، لما أولاه من المعروف وقلّده من النعم. وعليه فإنّ اسم الممدوح في هذه القصيدة، لم يكن إلاّ ذريعة لاستدعاء الاسم الرّمز في سياق المعنى القرآني (لشّكر وما يقترن به من المعاني الحافّة).
وأمثلة هذا التّوافق، أكثر من أن نتتبّعها، ولكنّنا نسوق منها أبلغها دلالة على ما نحن فيه من أمر هذه الظاهرة:
إن كان مسعودٌ سقى أطلالـهم/ سبلَ الشّؤون فلست من مسعودِ
وقد أثارت عليه، بعض هذه الأسماء، خصومه من الذين رأوها من معايبه. من ذلك اسم “مسعود” في البيت الثّاني، فقد ذكر الآمدي أنّ شيوخ البغداديّن يزعمون أنّهم لا يعرفون شاعرا يسمّى بمسعود غير مسعود أخي ذي الرّمّة، ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الأطلال، وليس في أسلاف أبي تمّام من يسمّى بمسعود حتّى يقول ما قال. و”كنت أسمعهم دائما يقولون : فأين مسعود هذا؟ أفي السّماء هو أم في الأرض ؟ ويزعمون أنّه إنّما جاء بمسعود من أجل القافية”.
وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء أيضا، فقد عدّ ذكره مسعود، من ” الإلجاء” أي من متطلّبات القافية ما دامت هي التي أحوجت إليه. والحقّ أنّ الأمر ليس على ما توهّم كلّ هؤلاء، فثمّة في شعر الطّائي، غموض يكاد لا ينضب، وغرابة تلوح وكأنّها مستبهمة النّشأة، تترامى من أكثر من ناحية من نواحي القدم. وقد وقف الآمدي، بين كلّ هؤلاء، مفسّرا شارحا، وكان له صبر على النصّ، عجيب، إذ تتبّع أسماء المساعيد ( جمع مسعود ) من شعراء القبائل،ولم يجد فيهم أحدا بكى على الدّيار.قال : “فأعياني معنى البيت مدّة طويلة، حتّى قرأت في شعر ذي الرّمّة :
عشيّةَ مسعودٌ يقول وقد جـرى/ على لحيتي من واكف الدّمع قاطرُ
فعلمت أنّ أبا تمّام إنّما أراد مسعودا هذا أخا ذي الرّمّة، لأنّه كان ينهى ذا الرّمّة عن البكاء على الديار. وفي هذا ما يدلّ على أنّ الاسم يعقد على الإسم، وأنّ الشعر يصدر عن الِشعر. وفضلا عن ذلك، فهذا من المتخيّل الطللي حيث الشاعر أحوج ما يكون فيه إلى اسم علم أو رمز يكنّي به عن حال من أحوال نفسه.
وقوله:
لم يلبس الله نوحًا فضل نعمــته/ إلاّ لما بثّه من شــــكره نوحُ
وقد عدّ المعرّي هذا الضّرب من التّقفية ” إلجاء”، وعلّل رأيه بأنّ “القصيدة لو كانت على السّين لصلح أن يجعل مكان “نوح” “موسى”، ولو كانت على الدّال لصلح أن يجعل مكانه “هودا “.
ولكن يصعب أن نأخذ برأيه في أنّ اسم ” نوح ” ذكر للقافية لا أكثر ولا أقلّ ؛ لسبب لا ندري كيف غاب عن أبي العلاء، خاصّة أنّ أبا تمّام يريد الآية الثالثة من سورة الإسراء “ذرّية من حملنا مع نوح إنّه كانَ عبدا شكورا”. والأمر ها هنا أشبه، في تقديرنا، ب “التّلجئة ” بعبارة الفقهاء، منه بالإلجاء؛ والتّلجئئة هي أن يُكره المرء على أمر ظاهره خلاف باطنه. فأبو تمّام إنّما أتى الاسم “نوح”، ولم يكن له من ذلك بدّ، لسببين على الأقلّ : أحدهما أنّ الممدوح هو سميّ النبي نوح، والآخر أنّ معنى الشكر يقترن في الآية ب” نوح ” النبي، وليس ب” موسى” أو “هود” ؛ فهو البعيد الخفيّ المراد بهذه القرينة “شكره”. بل ربّما ذهبنا أبعد، فظاهر الاسم خلاف باطنه، وقد يكون الاسم ” نوح ” تورية من الشاعر عن نفسه، إذا نحن قرأنا البيت في ضوء سابقه ” يا مانحي الجاه… “، وليس لنا إلاّ أن نقرأه كذلك. فمثلما ألبس الله نوحا فضل نعمته، لأنّه كان عبدا شكورا ؛ يثني الشاعر على ممدوحه، لما أولاه من المعروف وقلّده من النعم. وعليه فإنّ اسم الممدوح في هذه القصيدة، لم يكن إلاّ ذريعة لاستدعاء الاسم الرّمز في سياق المعنى القرآني (لشّكر وما يقترن به من المعاني الحافّة). وهذه طريقة من بين طرائق أخرى يتوخّاها الشاعر في نصب الاسم للقافية؛ حتّى إذا استتبّت له هذه الأسماء، وانتقل إلى النّظم، وقع له منها، على ما يبدو، ما لم يمرّ قطّ بباله، ولا خطر في وهمه. فقد ذكر أبو تمّام اسم ” نوح” هذا، ممدوحه، في قصيدة أخرى، وقرنه باسم النبي نوح، ولكن دون أن يبرح المعنى المتعارف مثل كرامة المحتد وأرومة شجرة النسب.
وينحو المنحى نفسه في مدح الواثق بالله، حيث يحشد في بيت واحد أسماء خمسة من خلفاء بني العبّاس :
يسمو بك السّفّاح والمنصور والمهديّ والمعصوم والمـــــــــــــــأمونُ
وقوله في رثاء ابنه محمّد حيث يتنادى السّميّان : اسم المرثيّ واسم النبي محمّد:
ولا تحسبنّ الموت عارا فإنّنا / رأينا المنايا قد أصبنَ محمّـــــدا
بل هو يثبت اسمه “حبيب”:
كاد أن يكتب الهوى بين عينيه/ كتابا: هذا حبيبُ “حبيب “
ومن الواضح أنّ الاسم الثّاني المضاف إليه هو اسم أبي تمّام ( حبيب بن أوس).
أمّا عند طائفة من المعاصرين فالظاهرة نافذة عمياء، ليس لها من كلمة “نافذة” إلاّ هذه الأسماء المستجلة بدون داع؛ وهي تجري وتنعطف على سبيل المصادفة والعشوائيّة، فهي عتمة لعين القارئ وغشاوة عليها؛ في حين أنّ القصيدة قصْدٌ في اللغة أي نوع من الاقتصاد اللغوي، يفضي إلى نظام شعريّ صارم، ويجلّي صنعة في إدارة فنّ القول. وعسى أن أعود إلى هذا بشيء من التفصيل.
متألق ياأبا زينب كالقمر البازغ المنير والشموع ؛ كعهدنا بك دائمًا القلم اليراع .هنيئًا لتونس بأمثالك من رجالات الأدب المبدع.
ملاحظة على السريع،
أخالف هنا رأي الأخ منصف الوهايبي لدى لجوئه إلى مصطلح «التلجئة» بمعناه الفقهي بدلاً من لجوء أبي العلاء المعري إلى مصطلح «الإلجاء» بمرماه العروضي، في تعليل تقفية بيت أبي تمام:
«لم يلبس الله نوحًا فضل نعمته / إلاّ لما بثّه من شكره نوحُ»
بأنّه لو كانت القصيدة على قافية السين لصلح أن يجعل مكان «نوح» اسم «موسى»، ولو كانت على قافية الدال لصلح أن يجعل مكانه اسم «هودا»، وهلمَّ جرًّا.
حتى أن الأخ منصف يناقض نفسه بنفسه لدى استشهاده ببيت أبي تمام الآخر في مدح الواثق بالله، حيث يحشد فيه خمسة أسماء من الخلفاء العباسيين:
«يسمو بك السّفّاح والمنصور والمهديّ والمعصوم والمأمونُ»
بالتأكيد، التقفِّي هنا «إلجاء» وليس «تلجئة» مهما كان مدلول أيٍّ من هذه الأسماء، لأنه لو كانت القصيدة على قافية الميم لصلح أن يجعل مكان «المأمون» اسم «المعصوم»، ولو كانت على قافية الراء لصلح أن يجعل مكانه اسم «المنصور»، ولو كانت على قافية الحاء لصلح أن يجعل مكانه اسم «السفَّاح»، ولو كانت حتى على قافية الياء المشددة لصلح أن يجعل مكانه اسم «المهدي»، وهكذا دواليك.
تحية إلى الأخ جمال
شكرا لأخي الدكتور جمال، وللأخ يحي على ملاحظته. وساعود الى هذا الموضوع في مقال قادم عن لعبة الأسماء عند المعاصرين. على أن المصطلحات وبخاصة في الأدب تحتاج الى كثير من التدقيق، وأكثرها مستجلب من صناعات أخرى.