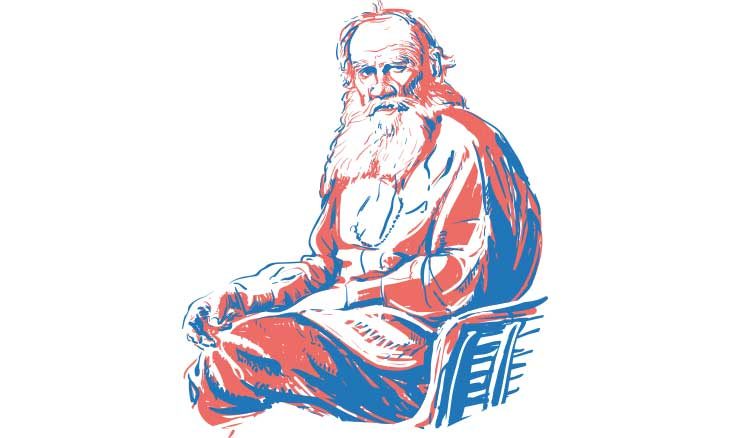
«ينبغي أن يحدث ذلك لك» عنوان فيلم، لكنه أشبه ما يكون بنبوءة استثنائية أطلقت عام 1953، لكننا نلمس صداها اليوم في كل ما حولنا.
لقد (حدث ذلك) وانتهي، هذا ما يمكن أن نقوله الآن ونحن نرى الطريقة التي باتت فيها الصورة تشكل حياتنا، من الصعود الاستثنائي للسينما، إلى الرواج الأكثر للبرامج الحية والميتة التي تحولت إلى حالة من الهوس العام.
ورغم أن حكاية الصورة والحس بأهميتها أو بخطرها، حكاية قديمة منذ أن شاهد الروائي العالمي الكبير تولستوي واحدًا من أشرطة السينما، حيث قال: «إن هذا الاختراع الجديد الذي له يدٌ تدور سوف يُحدِث ثورة في حياتنا ـ نحن الكتّاب»، لكنه لم يفطن إلى تلك الثورة التي سيحدثها هذا الاختراع في حياة القراء أو المواطنين، وقد كان تولستوي على يقين، حسب قول موريس بيجا، أن على الكتّاب «منذ اليوم» أن يكيّفوا أنفسهم.
لم يكن تولستوي يتخيل ما سيحدث، وأن اليد الدوارة التي تحرّكها يد بشرية لكي يستمر عرض الفيلم، سيتم استبدالها بأشياء لا يمكن تصورها، وأن الفيلم الذي يُعرض في الصالة المغلقة بين فترة وأخرى سيتحول إلى جزء أساس من حياة البشر في الصالات الضخمة المعتمة والغرف المضاءة وعلى مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم، وعبر مئات المنصات والمحطات الفضائية المتاحة، وما لم يقدر تولستوي على تصوره في ذلك الزمان البعيد، لم نكن نحن بدورنا قادرين على تصوره.
لكن الصورة، وإن كانت مفردة السينما الأولى، كما الكلمة مفردة اللغة، إلا أن استخدامات الصورة اتسعت بما لا يقاس إذا ما قورنت بالمفردة في اللغة، بحيث أصبح السؤال الأكثر تردّدًا في حياتنا المعاصرة «هل رأيت؟» وقد كان «هل قرأت؟!».
وبالعودة لما (ينبغي أن يحدث ذلك لك)، وقد شاهدتُ هذا الفيلم من زمن طويل، لكنه ترك أثرًا استثنائيًا في ذاكرتي وظل يمور في داخلي كواحد من أجمل الأعمال السينمائية التي شاهدتها، الأعمال التي تخرج من ركام الفيض الهائل للأفلام، وقد تحولت السينما إلى تجارة خاضعة لمتطلبات السوق، في معظم حالاتها.
بالعودة إلى هذا الفيلم، يتبين لنا أن تلك الفتاة الشقراء النكرة، التي تصل إلى نيويورك، لا تملك من هذا العالم سوى بعض مدخراتها، وترفُّعها على ذلك الخطيب الأقل من طموحاتها.
فتاة عادية تمامًا، شبه ساذجة، تلفت نظرها ذات يوم، وهي تعاني من وطأة (الحياة التي لا تليق بها) لوحةُ إعلانات في واحد من ميادين مانهاتن، تلمع الفكرة فورًا في ذهنها، وتقرر استئجار تلك اللوحة.
لم تكن تلك الفتاة التي تؤدي دورها «جودي هوليدي» تعرف أو تتصوّر حجم ذلك التحوّل الذي سيطرأ على حياتها بسبب قرارها هذا، لكنها بدأت خطوتها الأولى، الخطوة التي ستقلب حياتها تمامًا.
بعد أيام نرى صورتها الكبيرة تغطي لوحة الإعلانات وتحتها قد سُطِّر اسمها بخط كبير.
كل من يمر في ذلك الميدان لا بدّ له من أن يرى تلك الصورة ويقرأ ذلك الاسم، دون أن يعرف تمامًا ما الذي يعنيه ذلك، لكن وفي أعماق كل شخص لا بدّ أن تتكون صورة لائقة مُكبَّرة للدّور الكبير لامرأة عملت الكثير كي تحتل صورتها قلب هذا المكان!
بفرح تتأمل الشقراء صورتها، ولكن إحساسها بكل ما حولها يبدأ بالتغيّر، إنها شهيرة، إنها تنظر للجميع من عل، وقد أصبحت صورتها على هذا المستوى من الارتفاع.
الخطوة التالية هي الصراع الذي يبدأ فجأة بين شركات كبرى على استئجار هذه اللوحة نظراً لأهمية موقعها، وهكذا يبدأ البحث عن صاحبة الصورة التي تحوّلت إلى نجمة لا يعرف أحد عنوانها، أو أي إنجاز من إنجازاتها، وما الذي أهّلها لتحتلّ هذه المكانة دون نجوم السينما والثقافة والمجتمع وما تقدّمه الصناعة من منتجات.
يتألق كاتب السيناريو غارسون كانين والمخرج جورج كيوكور بدفع الأمور إلى درجة أعمق، حين يبدأ رجال الصناعة بالبحث عن هذه الشقراء لإجراء مفاوضات معها، بغية إقناعها بالتنازل عن هذه اللوحة مهما كان الثمن الذي تريده، ولكن الشقراء التي باتت المسافة التي تفصلها عن خطيبها ضوئية، لا تريد المال، بل ما هو أكثر منه (الشهرة)، ولذلك ترفض كل العروض باستثناء ذلك العرض الذي تستطيع بموجبه استبدال تلك اللوحة بعدد كبير من اللوحات في عدد من المعالم العامة، ومن بينها محطات القطارات، والمطارات، وغيرها.
ليس ثمة مبرر للحديث هنا عما سيحدث لها، وسيحدث لنا (الجمهور العريض)، وقد باتت صورتها أكثر انتشارًا، وقد تحولت إلى نجمة كبيرة، مثل أهم نجمات السينما، وأهم السياسيين، والشعراء والكتاب، وباتت فرصة اللقاء بها حلمًا يراود كثيرين!
ربما هنا، بالذات، تكمن واحدة من أهم معاني فكرة «قوة الصورة»، هذا الأمر الذي بتنا اليوم أسراه بلا منازع. ولذلك كان الأمر يحتاج إلى لملمة تفاصيل ما حدث في المشهد الصغير، وأعني هنا صورتها واسمها، إلى المشهد الواسع، وأعني عيون الناس والقناعات التي تشكلت لديهم حول صاحبة الصورة، القناعات العمياء التي لا تخضع لأي مساءلة عقلية، القناعات القارّة التي لا نقاش فيها، القناعات التي تقول: ما دمت تملك صورة بهذا الحجم فإنك بالتأكيد شخص مهم للغاية، إنك نجم مجتمع، واحدٌ من العباقرة الذين يتطلع الجمهور لملامستهم والتبرّك بتوقيعهم.
كان على الشقراء أن تنطق اسمها مرتين؛ مرة بصورة منخفضة، ومرة بصورة عصبية، حين أعادت تلك المرأة توجيه السؤال لها في واحد من الأماكن العامة الأكثر اكتظاظاً. وبمجرد أن حدث ذلك، عمَّ الصمت فجأة، ثم بدأ الهياج العام الذي لا يوازيه شيء سوى لحظة حدوث زلزال أو حريق مدمر أو وجود قنبلة على وشك الانفجار.
هكذا تندفع الجموع باتجاه مصدر الصوت للحصول على توقيعها، الجموع التي تصرخ مرددة اسمها بهستيريا مجنونة، كما لو أن كل واحد أو واحدة من الجمهور قد عثر على أحلامه كلها.
لذا، ينبغي أن يحدث لك ذلك بالفعل، ليس لك كصاحب صورة، بل لك أنت؛ مشاهد هذه الصورة، وبغض النظر عن أي معيار، لأن الأمر يحدث في ظل غياب العقل تمامًا، كما لو أن كل طاقات ذلك العقل غير قادرة على دحض واقعية وسطوة ما تراه العين.
وبعد: لا نحتاج اليوم إلى كثير من الجهد لنرى كيف يتم تخليق كثير من النجوم، في الفنون والآداب ووسائل التواصل الاجتماعي، بالطريقة نفسها التي تألق في تكثيفها ببراعة مجنونة هذا الفيلم الرّائي.
( ربما هنا، بالذات، تكمن واحدة من أهم معاني فكرة «قوة الصورة ). نعم قوّة الصورة أقوى من صورة القوّة.ومن اجتماع الكلمة مع الصورة يتكوّن هيولي من الحركة والسكون بعنفوان يلامس جميع الأذواق؛ منْ يبحث عن الكلمة؛
فهي ها هنا؛ ومنْ يبحث عن الصورة فهي ها هنا وها هناك.في سؤال من قبل ناشر لبنانيّ صديق لي؛ سألني: أريد ادخال
تغيير على هيئة الكتاب المنشور؛ ماذا لديك لتقوله؟ بعثت إليه بجواب وافٍ.خلاصته: إنّ الكتاب العربيّ اليوم أشبه بصحراء قاحلة؛ تمتدّ على صفحات تصل إلى أكثر من (300 كمعدل ).جفاف ورتابة الصحراء لا يكسرها إلا رؤية واحة خضراء تدخل السرور إلى النفس وتنشّط العقل.الصورة هي الواحة الخضراء الواجب ادخالها إلى الكتاب.ليس معقولًا في كتاب من (200 أو 300 أو 400 ) صفحة لاتوجد صورة واحدة ملوّنة! أذكر أنّ كتاب الهلال المصريّ قبل سنين عديدة
كان يضع رسومات ملوّنة أو بالأسود والأبيض في منشوراته التاريخيّة والروائيّة.نعم أنا مع ادخال الصور في الكتاب أي
كتاب.وكانت حجّة ذلك الناشر كغيره من الناشرين؛ أنّ الصور الملوّنة ذات تكاليف عالية؛ لا تناسب الاقبال على الكتاب؟
[لكن الصورة، وإن كانت مفردة السينما الأولى، كما الكلمة مفردة اللغة، إلا أن استخدامات الصورة اتسعت بما لا يقاس إذا ما قورنت بالمفردة في اللغة، بحيث أصبح السؤال الأكثر تردّدًا في حياتنا المعاصرة «هل رأيت؟» وقد كان «هل قرأت؟!»] انتهى الاقتباس
عزيزي الكاتب، من المغالطة الموضوعية والمنطقية الكبيرة أن تتم المقارنة بين (الصورة) في مجال السينما وبين (الكلمة) في مجال اللغة بالهيئة المراد بها في هذه القرينة، خاصة وأنك هنا تتكلم ضمنيا وجديا على لغة النص الأدبي سواء كان شعرا أم نثرا – في حين أن المقارنة الأصوب والأسلم موضوعيا ومنطقيا هي أن تُجرى بين الصورة الضوئية سينمائيا والصورة البلاغية لغويا – وبناء عليه، فإن السؤال الذي تظنه الأكثر تردّدًا في حياتنا المعاصرة «هل رأيت؟» لا ينطبق في المقام الأول على أدنى تخمين إلا على السينما الصامتة، فضلا كذاك عن السؤال الأكثر تردّدًا بكثير حتى «هل سمعت؟» في حال السينما الناطقة بما يجمع الاثنين معا – ناهيك عن كونه من قبل ماضيا قريبا «هل قرأت؟» في الحيّز الكتابي أولا، وعن كونه قبل ذلك ماضيا بعيدا، والأهم من هذا كله، أيضا «هل سمعت؟» أو «هل أنصت؟» أو «هل أصغيت؟» في الحيِّز الشفاهي و/أو الحكائي ثانيا !!؟
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١ الأعراف﴾..وردت كلمة صوره في القرآن 17 مره، لمكانتها الهامه في إخراج عملية السيناريوهات المقدسه لمسألة الدنيا وكيفية العيش في كوكب الأرض والصراع بين الخير والشر المقدرين بميزان المشيئة الإلهيه… وتصوير يوم القيامه أو يوم الحساب بعد ذلك… فهو الخالق الواحد الأحد…
أضافه لما سبق..، الاستاذ يوسف وهبي قال وما الدنيا إلا مسرح كبير، ذلك في فلم غزل البنات….
قالها شكسبير قبل يوسف وهبي منذ أكثر من أربعة قرون من الزمن، وذلك في المشهد السابع من الفصل الثاني من مسرحيته غير الشهيرة «كيفما تشاء»:
William Shakespeare in 1599 in “As You Like It,” act 2, scene 7:
All the world’s a stage, / And all the men and women merely players.
وهي مذكورة أيضا ولكن صيغة أُخرى في مسرحية شكسبير الأكثر شهرة «تاجر البندقية» – وكل ذلك كان حقيقةً باستلهام بنحو أو بآخر من الفيلسوف والمؤرخ الإغريقي بلوتارك قبل ما يقرب من ألفي سنة !!؟