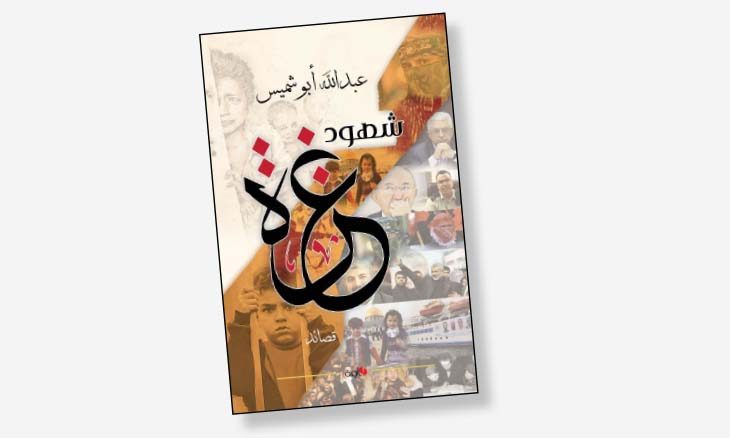
لا ريب في أن النظرة الأولى في ديوان أبو شميس الجديد الموسوم بـ«شهود غزة» تعطي الانطباع بأن فيه نظرة جديدة لم تطرح قبلا، وهي الانتقال من توظيف القناع التقليدي إلى توظيف آخر مختلف. فالقناع في الشعر وسيلة يلجأ إليها الشعراء عادة للتعبير عن تجاربهم، تعبيرا غير مباشر، فبدلا من أن يقول مثلا، أنا حزين، أو واحزناه، يجوز أن يعهد لصاحب القناع أن يقول ذلك. وفي هذه الحال يندغم في الصورة صوتان، أحدهما: هو صوت الشاعر، والثاني هو صوت صاحب القناع، سواء أكان هذا القناع يحيلنا إلى التاريخ، أم إلى التراث الديني، أم الثقافي، أم الأسطوري. وهذا في الواقع لا تقتصر فائدته على تجنب المباشرة والتقرير والاتجاه بالشعر نحو التعبير، لكنه أيضا يلقي الضوء على تجربة الشاعر، وفي ذلك كشفٌ عن خفايا المواقف والمشاعر التي يمر بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يستدعي أمل دنقل في إحدى قصائده زرقاء اليمامة متخذا، منها قناعا يخاطبه و»شوّافة» يريد أن تدين بلسانها خطاب السُلطة السائد عشية الحرب العدوانية عام 1967 قائلا على لسانها:
قلتِ لهم ما قلتِ عنْ مسيرة الأشجار
فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار
وحين فوجئوا بحدّ السيفِ قايضوا بنا
والتمسوا النجاةَ والفرار
فقد أدان الخطابَ السائد دون أن يقول إنّ هذا هو رأيه، وفي الوقت نفسه أعادنا لحكاية قديمة، تشكل جزءا من ذاكرتنا الثقافية، أي أن الشاعر عبر عن ذاته بمفردات، وألفاظ، صاغها الآخرون. وفي هذا يندغم الخاصُّ بالعام، فلا يختلف رأي الشاعر وشعوره، عن آراء الآخرين ومشاعرهم تجاه الحدث المأساوي. ونستطيع أن نجد في قصيدته لا تصالح نموذجا شبيها بهذا التوظيف للقناع المجتلَب من التراث الثقافي والأسْطوري. بيد أن عبدالله أبو شميس لا يتّبع هذا النهج في قصيدة القناع، فتجاوزَ ذلك لاختيار نماذج معاصرة، وأبطالا لمحكياته الشعرية ذات الأصوات المتعدّدة، يتحدث كل منهم بصوته الخاص عما شهده، أو رآه، أو عاناهُ، من الحرب الطاحنة التي وقعت في غزة، تلك الحرب التي سماها المعتدون الإسرائيليون «الرصاص المصبوب» وهي التي امتدَّت من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/يناير 2009.
فأحد الشهود، وهو مراسل صحافيٌ، يقدّم شهادته لا على أنه قناع جرى استقدامه من هذا التراث أو ذاك، لكنه شاهد عيان يمر بغزة بعيد سنة من الحرب المذكورة، في صورةٍ مركبة، أجزاؤها: خيمة، ومشردون، وحطام الدور التي جرى قصفُها بالقنابل الارتجاجية وتراب. وفي وسط هذه الصورة مراسلٌ يُعدّ تحقيقا عما جرى في المدينة قبل عام، وفي هذا المشهد يتكلم المراسل قائلا: ما الذي تتذكره قبل عام. الغزيون الموجودون في الخيمة يقولون إنها الحرب، ويلتقط المراسل صورا:
دارت الكاميرا
بشراهتها في خراب الجهات
دنَتْ من حقول الرماد ومن
شجَر الموتِ والتهمتْ
كلَّ شيء وما زال يأكلها جوعُها للكلام
فالحربُ التي انتهت، أو قيل إنها انتهت، ما تزال رحاها تدور وتسحق بدورانها كل شيء؛ الحجر والشجر، والحقول والرماد، ولذا لا يستطيع من تبقى من ضحايا تلك الحرب الإجابة عن أسئلة المراسل الصحافي. ويأتي القناع الآخر مشاكلا للسابق، لكنه في هذه المرة ليس مراسلا صحافيا لجريدة، وإنما هو مراسل يسعى لإعداد تغطية أو متابعة تلفزيونية، فهو، أي المراسل، يصرخ بأعلى صوته قائلا: إنهم يقصفون المقابر. ويكرر متسائلا ماذا يريدون منها بحق السماء؟ تبدو هذه الصرخة مع هذا التساؤل كما لو كانت استثارة للقارئ المتلقي، فما الغاية من قصف القبور يا ترى؟ يقول الشاعر في رده على هذا السؤال موردا عددا من الاحتمالات التي تتكرر على لسان المراسل التلفزيوني:
يريدون أن يخلطوا
الحديثين والقدماء
فمن هؤلاء البهار
ومن هؤلاء الدماء
لكي يلهبوا للمُظفّر يهْوَه
صحْن الحِساء
وهذا التفسير قد لا يكون مقنعا في رأي هذا الشاهد. وثمة تفسير آخر قد يرجح على هذا، فقد يكون قصف المقابر وسيلة لإثبات أن هذه الأرض (فلسطين) ومنذ التيه الكبير، كانت خالية من السكان، فهم – أي الصهاينة – أول من أحال هذا الخواء إلى وطن في زعمهم. إلا أن هاتين الشهادتين غير كافيتين، فثمة ثالثة تقول، ولعلها هي الصواب:
يقصفون المقابر خوفا من الشهداء
وما يتسرَّبُ من نور أحلامهم في الهواء
أما المقاتل، فقناع ذو شهادة، تختلف عن سائر الشهادات، وذلك أنه الخاسر الوحيد، ليس في الحرب وحسب، بل حتى في السلم، إنْ نصرا أو انكسارا، ولا شأن له بالنتائج، فهي من حظ أولئك الذين يحاربون من على الكراسي:
أقاتلُ من أجل شيء بسيط
وأعلم أني إذا متُّ
لنْ يذكروني
ولن يكتبوا في رثائي ولو كلمة
وأعلم أني إذا ما انتصرتُ
فإنَّ لغيري الخطاباتِ والأوْسمهْ
ولا يقتصرُ شهود أبي شميس على الغزيين، بل للآخر الصهيوني موقعه في هذه الأقنعة، وحضوره بين هؤلاء الشهود مع الانتباه لطبيعة العلاقة بين هذا النفر من الأقنعة والسابقين. فالناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يدلي بشهادته التي يريد منها الشاعر أبو شميس إدانة العقلية الصهيونية الإرهابية مباشرة، وعلى لسان أدرعي، أحد دعاتها الإرهابيين، يقول:
نريد سلاما طويلا
لأجل السلام نكابدها آسفين
وإن لزم الأمر
أن نخسِفَ البرَّ
حين يخبئهم كالضباب
ونقتلهم أجمعين
فنحن نريد سلاما طويلا
وإن لم نجد فيه من شركاءَ سوى الميّتين
فأي سلام هذا الذي يدّعي أدرعي نشدانه بقتل الفلسطينيين أجمعين. وها هو الحاخام يؤكد على القانون الذي يسود الكيان الإسرائيلي، وهو قانون اقتل واقتل واقتل، بل إن القتل وحده لا يكفي، إذ لا بد من قطع كل شجرة، وقلع كل حجر، وإعادة الأرض إلى سابق عهدها قبل أنْ يُعمّرها الإنسان:
لا تتركوا بشرا
ولا شجرا
ولا حجرا على الأحجارْ
حتى تعود الأرض بكرا من جديد
فالتاريخ الذي يتحدث عنه الإسرائيليون تاريخ زائف، لكنهم، وهم مخترعوه، يصدقون الزيف الذي يتداولونه، وكأنه حقائق. وهكذا نجد الحاخام يتفقَّه في تاريخه، زاعما ألا فرق بين ماض بعيد وآخر أكثر بعدا، فهو استثناءٌ غريب من هذه الزاوية، لا يهتم بدورة الزمن، ولا بالمسارات الفلكية التي تحدّد دورة الأرض حول الشمس:
زمني تحدده قوانين الوراثة
ليس ثمة فارقٌ
إن جئتُ في وقت مع الهكسوس
أو في عصر ما بعد الحداثة
لي أنا عصري
ولي دَوْري الرتيب
واللافت للنظر أن أبا شميس لا يقتصر في أقنعته هذه على الجانب المأساوي الجاد، لكنه يلجأ للسخرية. فالقناع يبدو في هذه الحال كما لو أنه مشهدٌ مسرحيٌ يسخر فيه الشاعر من الشخصية صاحبة القناع، مُستخدما المونولوج، مثال ذلك القصيدة الموسومة بعنوان السيد الرئيس، فهو يقول على لسان هذا الرئيس:
أحدّق باسمي
على شاشة تلعنُ اسمي
أصارحُه
ربما كنتُ محمودَ فعلا
لكنّ عبّاس هذي أحاولُها
منذ ستينَ عاما
ويمضي في الكشفِ عن طبيعته التي ترمي للسخرية من المتخاذلين، والمتساقطين، مدعيا أنه يسعى بإخلاص لتحقيق السلام، على الرغم من أن هذا السلام يزداد بعدا على بُعد، ولا يسعى – مثلا – لدعم صمود غزة، وأبناء غزة، التي تقاتل دفاعا عنه، وعن زبانيته. يقولُ مدافعا عن نفسه في عباراتٍ ساخرة:
وهل كان ذنْبي أنيَ
ألقيتُ بالبندقية عن كتفيَّ
واكتفيت بغُصن السلام
في بلادٍ تعمَّد أطفالُها
بالدماءِ، وبالنار، قبل الفِطامْ
أما قصيدة إلى السيد الرئيس، فإنَّ المتكلم فيها يبوح من وراء هذا القناع بما لدى أحد الغزيين من أخبار، وهي أخبار الحرب طبعا، التي لا يحسن الرئيسُ الاستماع إليها، ولا لسقوط الضحايا، كأنهم براعم الفل، وكأنهم الندى، أو كأنهم عيون باردة كالأجراس، في حين أن الرئيس نفسه لا يبالي بسقوط الضحايا، فالشيء الوحيد الذي يشغله، ويهتم به هو، التفاوضُ العبَثي:
تقولُ نفاوض
لا بأسَ، لكنْ قلْ لي
باسم الأجْداث نفاوضُ
أم باسم الأكياس؟
لن تنْجو منها يا عباس
فأطفال فلسطين أولئك
ليسوا أطفال حماس!
وبهذا التوظيف المغاير لما هو سائد استطاع أبو شميس أن يقول في هذه القصائد ما لا يُقال، من غير أن يقع في التقرير، أو المباشرة. وقد يطولُ بنا الأمر إذا نحن استقصينا الأقنعة التي تحدَّث الشاعر من ورائها. فثمة قناع للقاضي غولدستون. وآخر لألماظة السموني ذات الـ11 ربيعا التي قتل أفراد عائلتها جميعا وتخاطب أمها قائلة في القصيدة:
كيف (طخّوكم) جميعا
إخوتي، أمي، أبي
ولم أقدر عليهم
ليتني قدْ كنت مثل اليوم يا أمي
كبيرة
فهي تحسَبُ أنْ لو كانت كبيرة، لأنقذتهم من مصيرهم. وقناع آخر للُؤيّ صبح وغيره. وهذا الأداء الشعري الذي يشبه الرؤية المقنَّعة، يجمع بين توظيف القناع بطرق غير معتادة، لم يسلكها الشعراء في قديم، أو جديد، فتحيل القصائد، وعددها غير قليل، إلى ما يشبه القصيدة الطويلة التي تتناوب عليها عدة أصوات، تمثل عددا من الأقْنعة، وهذا يُقرّبُ قصيدته من البناء الدرامي الذي وجدنا ملامح له عميقة، وجليّة، في ديوانه السابق «الحوار بعد الأخير».
كاتب وأكاديمي أردني