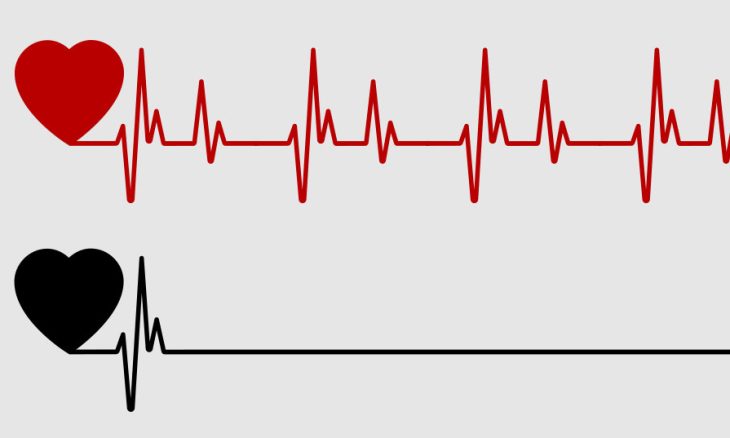
كانت الجملة الأولى التي افتتحتُ بها روايتي الأولى «براري الحُمّى» قبل أربعين عامًا: «مجرد أن قالوا لي إنني قد متُّ، وإن عليّ أن أدفع مائة ريال مساهمة منّي في نفقات دفني، أدركت أن هناك مؤامرة تحاك ضدّي».
لا أظن أنني كنت سأبدأ حياتي الروائية بجملة أكثر واقعية من هذه، بل أظنّ أنني لا يمكن أن أبدأ حكاية عشت فيها الموت شخصيًّا بجملة أدقّ من هذه.
في تلك الصحراء، كنت أراقب بذعر الأفاعي تُطارد الفئران في السقف القش، ولا أعرف متى ستسقط واحدة منها عليّ، أو متى سيلتجئ إليّ فأر هاربًا منها، فتتابعه في فراشي.
مشهد مرعب، لكنّه حدث؛ ثلاث مرات سقطت الأفعى على رأسي، وإن لم يكن في السرير، ونجوت. لكن ما هو أكثر جنونًا من ذلك، تلك البعوضة التي زرعت في جسدي جمرة الملاريا، فأحرقتْ بها دماغي.
لا شيء أسوأ من البعوضة.
لماذا تُصرّ البعوضة على البقاء في الغرفة بعد أن تلسَعكَ، أو تُمرضَكَ؟! لماذا لا تغادر مثلما تغادر النّحلة، ويغادر الدّبور، والعقرب، والأفعى، وأمّ أربع وأربعين، والعناكب، والطائرة التي تقصفكَ؟ لماذا؟!
خطر ببالي أن أستعرض المرّات التي واجهت فيها الموت بصورة شخصية، ولم يكن صعبًا عليّ أن أكتشف أنها كثيرة؛ بالمرض أو بالقصف أو بالرّعونة، أو بالأفاعي والبعوض، أو بالكهرباء والمحاجر، أو بطلقة طائشة، أو قذيفة أكثر طيشًا، مع أن الرصاصات والقذائف في الحروب لا تطلق لتطيش، بل لتقتُل.
الموت: أنا لا أُفكِّرُ فيه.. لكنهُ أكثر وفاءً.. إنه يًفكِّر فيَّ دائمًا!
لكنني حين هربت من الموت الشّخصي، وجدتني أهرب إلى الموت في النصوص التي كتبتها، وإن كانت حالات كثيرة واجهت فيها الموت، قد تسللتْ إليها.
بدأت بالبحث عن كلمة «موت» في نصوصي، لأكتب هذه الشهادة عنه.
لم أكن قد فتّشتُ عن الكلمة في أكثر من سبعة نصوص روائية، حين انتبهت لعدد الكلمات التي جمعتُها في ملف خاص، كان الرّقم مرعبًا حقًّا. فالفقرات التي تحدثتْ عن الموت في النصوص السّبعة بلغ عدد كلماتها خمس عشرة ألف كلمة!
توقَّفتُ.
لم أستطع أن أتابع البحث في نصوصي الأخرى. أيّ جحيم هذا الذي حملتْه رحلة سريعة عن كلمة «موت» فكانت هذه الحصيلة؟ مع أنني لم أفتّش عن كلمات مثل: قتلى، ماتوا، أموات، شهداء، مقبرة، نعش، قتْل، مذبحة، اغتيال.
ماذا لو واصلتُ البحث في بقية أعمالي؟ كم سيكون عدد الكلمات التي ستضمّها الفقرات التي تتحدّث عن الموت وأشكاله وتنوعاته؟ هذا إذا ما استثنيت أعمالًا شعرية، مثل: «كتاب الموت والموتى» و «راية القلب- ضد الموت» و»بسم الأم والابن» و»مرايا الملائكة» (سيرة الشهيدة إيمان حجو ابنة الأشهر الأربعة التي قتلتها قذيفة دبابة)…
سهرتُ كثــيرًا هنا قربَ رأسِكِ
قلتُ أُعلِّمُكِ الأبْجديَّـةَ
هل تعلمينَ: الليالي الطويلةُ، دونَ كلامٍ،
ظلامٌ يسيلُ
وأنـهُرُ مَعْدنْ
ملائكةُ الله تسهرُ في هذه الأرضِ
أكثرَ من أيِّ أرضٍ، وتَحزَنْ
القارئة التونسية النّجيبة، قالت لي خلال زيارتي لتونس، في نهايات العام الماضي: «هل لاحظتَ، على كثرة ما يوجد من حروب وموت ومذابح في رواياتك، ليس هنا مجالس عزاء، أو بيوت للعزاء»!
ربما كانت جملتها واحدة من مفاتيح كتابتي، بحيث رحت أسترجع أعمالي، بما منحتني الذّاكرة من مساعدة، فوجدتُ أن لا بيوت عزاء فعلًا فيها، وتساءلت: لماذا؟
فتذكرت قصيدة شاعرنا توفيق زياد التي قال فيها:
«ادفنوا أمواتكم وانهضوا»
نحن ننسى لنعيش، لكننا لا ننسى تمامًا، كي لا نموت!
دون أن نُغْفِل أننا مثل شعوب كثيرة على هذه الأرض تواجه كلّ أشكال الموت (الطبيعي وأشباهه) التي يعرفها البشر، ثم نواجه موتًا آخر؛ ذلك القابع في عتمة فوهات البنادق وفي عينَي القناص، القناص الذي يقول للصحافيّة التي تسأله عن العدد الكبير من الأطفال الذين يُقتلون في الضفة الغربية وغزة: «نحن لا نستطيع أن نطلب من كل واحد من هؤلاء بطاقة هويته لكي نتأكّد من عمره قبل إطلاق النار عليه».
ذات لقاء مع جمهور إيطالي قلت: كنتُ أحب أن أؤرخ حياتي بقصص الحب التي عشتها، لا بالحروب التي التهمتْني والتهمتْ كل ما حولي.
بعد ضياع فلسطين بعدة سنوات عشت مأساة الاقتلاع، وبعد عامين من مولدي حدثت حرب 1956، وفي الثالثة عشرة من عمري وقعت حرب حزيران (التي حلّت ذكراها قبل أيام) ثم توالت الحروب والمذابح، تل الزّعتر، بيروت، صبرا وشاتيلا، حرب الخليج الأولى والثانية، الحروب المتوالية على غزة وغيرها.
المشكلة التي وجدتُ نفسي أتخبط فيها أنني كتبتُ عن الموت أكثر مما تحتمله شهادتي هنا، كتبتُ عن الموت أكثر مما يجب، وفي ظنّي أننا عشناه أكثر مما يجب.
رغم ذلك كله، في هذا المشهد الواسع لا نستطيع إلا أن نلعب دوْر الوردة، في احتضارنا الحي من أجل جمال البيت، ولعل هذا ما يجعلنا قادرين على مواجهته بكل هذا الصبر، إلى أن يموت!
أتذكر الجملة الأولى في روايتي الأولى، حين أخبروا بطلها بموته، وطالبوه بدفع مساهمته، لكن أجمل ما حدث أنه لم يصدقْهم، أنه أدرك لعبتهم الكبرى، ولعلها لعبة الموت نفسه، فرفْضَ الموتَ، ورفْضَ تلك الصحراء، ورفضه في ما بعد في النصوص الروائية التي بحثتُ فيها عنه؛ النصوص التي لم تُفرْحه أو تعترف به بإقامة بيوت العزاء، ببساطة لأننا لا نستطيع أن نموت تمامًا؛ نحن لا نستطيع.
وبعــد:
جاء في «أعراس آمنة»: الذي يُجبرنا على أن نـزغرد في جنازات شهدائنا هو ذلك الذي قتَلَهم، نزغرد حتى لا نجعله يحسَّ لحظة أنه هزمَنا، وإنْ عشنا، سأذكِّرُك أننا سنبكي كثيرًا بعد أن نتحرّر!
*من شهادة عن «الموت في الرواية»
{ يَمُوتُ الفَتَى في عَثْرَة ٍ بِلِسَانِهِ…..وَلَيْسَ يَمُوتُ المَرْءُ مِنْ عَثْرَة الرِّجْلِ }( عليّ ابن أبي طالب).{ منْ لم يَعشْ مُتَعزّزاً بسنانه …..سَيمُوتُ مَوت الذُّلّ بين المعْشر }(عنترة ابن شداد).{ تبكي القبورُ ؛ إذا ما ماتَ ميتهمْ..…..حتى يَصِيحَ بمنْ في الأرْضِ داعِيهَا }( حسّان ابن ثابت ).{ يَا لَيْتَني مِتُّ؛ وَمَاتَ الهَوَى……وماتَ؛ قبل الملتقى ؛ واصل}( عمرابن أبي ربيعة).{ شَمِتوا حين مات؛ والموتُ ما ……تنفعُ فيــه شماتة ُ الحُسَّادِ }( عرقلة الكلبيّ ).{ وقَدْ مُتُّ أمْسِ بها مَوْتَة…….ولا يَشْتَهي المَوْتَ مَنْ ذاقَهُ }(المتنبيّ).{ إن قلتِ مُتْ؛ متُّ في مكاني…….أو قلتِ عِشْ؛ عشتُ من مماتي }( أبو نؤاس ).