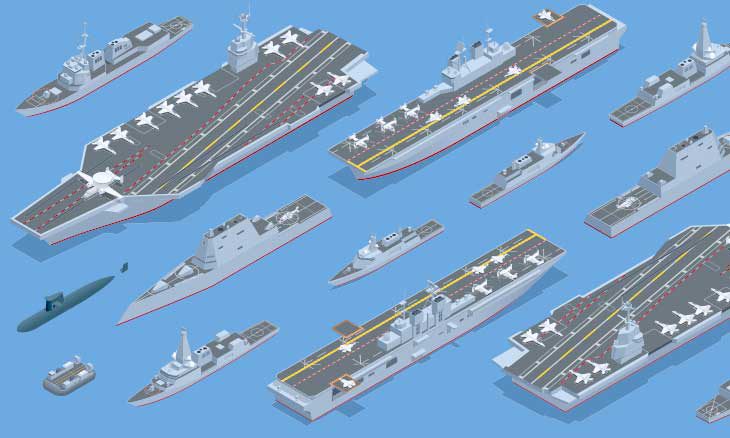
فكرة الردع ليست جديدة في السياسة الدولية، بل عرفها المجتمع البشري منذ القدم، بل إنها ممارسة إنسانية تبدأ بتربية الطفل ومحاولة ردعه عن ارتكاب الأخطاء تارة بتخويفه من العقوبة وأخرى بحرمانه من الأشياء المحبّبة لنفسه كالألعاب والحلويات وسواها.
وقد يتم التعبير عنها بألفاظ ومصطلحات متعددة، ولكن جوهرها يبقى واحدا: أن امتلاك القوة من أهم أساليب الدفاع. وحيث أن الدفاع عن النفس مشروع في المفهوم الإنساني، فهذا يعني أن امتلاك وسائل الردع أمر مشروع كذلك ضمن حدود. فلا يجوز التلويح باستهداف الأبرياء، أو القتل الجماعي أو الأراضي الزراعية ومصادر الماء. فالإسلام يمتلك أخلاقية عالية، ويقدّس النفس الإنسانية والحق في الحياة، ولا يسمح للغاية أن تهيمن على الموقف الأخلاقي أو تسمح بوسائل غير إنسانية أو أخلاقية. ويفترض أن يكون مفهوم الردغ شاملا، ولكن من المؤكد أن الحكومات وحدها هي المخولة بامتلاك الأسلحة التي توفر لها قوة كافية لردع الآخرين عن استهدافها. هنا يصبح الردع بمثابة الدفاع. أما الجماهير فلديها وسائل ردع أخرى ضد ظلم الحكومات التي لا تنتهج سياسات مقبولة. ففي المجتمع الديمقراطي تستطيع الجماهير استخدام صناديق الاقتراع لمنع وصول من تعتقد أنه مارس الظلم او سيمارسه إلى السلطة. أما في غياب الحالة الديمقراطية فيتمثل الردع بخشية الحكام من ردة فعل الجماهير وثورتها عليهم. فالردع في جوهره وسيلة للدفاع بمنع وقوع الحرب.
وكما يقال: «إذا كنت تريد السلم فكن متأهبًا للحرب».
وقد دفع التطور البشري المفكّرين للتفكير بشكل آخر، فجاء القانون وسيلة للردع ومانعا من ارتكاب الجرائم. ولكن سلطة القانون محدودة عادة، ومحصورة بدائرة الأفراد. ويتضمن القانون مفهوم العدالة، وأن هذه العدالة، هي الأخرى رادعة عن ارتكاب الظلم أو الاعتداء أو سلب حقوق الناس وممتلكاتهم. وتخشى الدول الكبرى من سلطة القانون الدولي، فيرفض بعضها القبول به أو الاحتكام إليه. فبروتوكولات روما التي قامت عليها محكمة الجنايات الدولية يُفترض أن تردع الحكومات عن اضطهاد مواطنيها أو السماح لقواتها المسلحة بارتكاب جرائم قتل واضطهاد في حالات النزاع.. ولذلك رفضت الولايات المتحدة التصديق على تلك الاتفاقية خشية مثول جنودها أمامها إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون في ساحات القتال. وفي هذه الحالة يفقد القانون سلطته وردعه، ليبقى الباب مفتوحا أمام سباق التسلح.
وتدرك الدول الكبرى دور السلاح النووي في الردع، لذلك اقتصر السماح بامتلاك أسلحة النووية على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. غير أن ضعف القانون الدولي، وسياسات الدول الكبرى الانتقائية فشلت في منع دول أخرى من امتلاك التكنولوجيا والأسلحة النووية. فأصبحت الهند قوة نووية وباكستان والبرازيل، وكذلك «إسرائيل». ولضمان التفوق الإسرائيلي رفضت الولايات المتحدة السماح للدول العربية بامتلاك تكنولوجيا نووية أو سلاح نووي. ومنذ قرابة العقدين ركّزت واشنطن جهودها لمنع إيران من امتلاك ذلك، خشية انعكاسه على ميزان القوى الإقليمي وتشبثا بمبدأ ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، برغم ما يرتكبه الاحتلال من مجازر يومية بحق الفلسطينيين خصوصا في غزة.
الردع سلاح فاعل لضمان أمن العالم واستقراره، بشرط أن يبقى ضمن الضوابط والأخلاق والقانون الدولي
قبل الحربين العالميتين كان الردع يتمثل أساسا بالتوازن السياسي بين الحكومات، كما توفر كذلك بتشكيل تحالفات وتكتلات سياسية توفر قدرا من الحماية لمكوّناتها.
وبعد الحرب الثانية كانت هناك أنماط من الردع، الأول: استمرار التكتلات والتحالفات مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف وارسو على الصعيد الدولي، ولكل منهما ذراعه العسكرية الضاربة، الثاني: لتقوية القدرة على الردع تم إنتاج القنلبة النووية التي استخدمتها أمريكا في صيف 1945 لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ونشأت الحرب الباردة بين الشرق والغرب في ظل امتلاك السلاح النووي من قبل كلا الطرفين. وبعد أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1961 والخشية التي صاحبتها من اندلاع صراع نووي مدمّر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، نشطت الأمم المتحدة في البحث عن اتفاقات دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وعلى مدى العقود الأربعة التالية تم التوصل لاتفاقات عديدة منها ستارت 1 وستارت 2 . معاهدة ستارت1 تم طرحها في زمن الحرب الباردة في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وفي العام 1991 قبل انهيار الاتحاد السوفياتي بخمسة أشهر وقّع عليها خلف ريغان الرئيس جورج بوش ونظيره السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. وفي نهاية عام 1994 دخلت ستارت1 حيز التنفيذ. أما معاهدة ستارت 2 فقد بدأ تنفيذها في العام 2011.
ولكن الخشية من اندلاع نزاعات واسعة على غرار الحربين العالميتين لم تتلاش تماما، خصوصا مع السباق على النفوذ. ومن المؤكد أن تفكك الاتحاد السوفياتي في العام 1989 ساهم في تخفيف تلك الخشية. مع ذلك برزت صراعات أيديولوجية وسياسية أخرى حالت دون الشعور الكامل بانتهاء شبح الصراع. ويمكن اعتبار صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة سببا جديدا لتجدد الخشية من حدوث صراع دولي. ولا يخفي الأمريكيون سياستهم بالاستعداد لذلك الصراع، في ما لو حدث، برغم أن الصين لم تظهر تحدّيا عسكريا لأمريكا، ولكنها مستمرة في توسيع نفوذها الاقتصادي خصوصا في أفريقيا. وتسعى الدول الأوروبية المنضوية في «حلف الناتو» لزيادة موازناتها العسكرية في ضوء الأزمة الأوكرانية التي تهدد بالتوسع، إذ ستصبح أوروبا ميدانها الأول.
بعيدا عن هذه الاعتبارات، ستبقى مقولة الردع مادة للنقاش الدولي، وقد أصبح التركيز على امتلاك السلاح بأنواعه كسياسة لتوفير الردع. وحالت الجهود الأمريكية دون انتشار السلاح النووي لتبقى لها اليد الطولى في أي نزاع. مع ذلك انتشر بناء المفاعلات النووية في العديد من البلدان، ولم تُجد سياسة فرض العقوبات على بعض الدول لثنيها عن مواصلة سعيها لامتلاك التكنولوجيا النووية. ومن أسباب هذا التمرد على السياسة الأمريكية أنها «انتقائية» أو «ذات معيارين». فهي تغض النظر دائما عن «إسرائيل» التي تخترق بشكل مستمر، الاتفاقات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالسلاح النووي، وترفض السماح للوكالة الدولية للطاقة النووية بتفتيش منشآتها النووية في صحراء النقب، أو تعريض ترسانتها النووية التي تقدر بأكثر من 200 رأس للرقابة الدولية. فأمريكا ملتزمة بسياسة ثابتة: الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في مقابل الدول العربية والإسلامية. وتأمل أن السلاح النووي يوفر ذلك التفوق. لكن هذه السياسة ليست مضمونة النتائج في ضوء تمادي الإسرائيليين في العدوان والقتل والاحتلال. فلم تعد الترسانة العسكرية الإسرائيلية رادعا عن التصدي لجرائمها التي تتحدى الضمير الإنساني.
من جانبهم يعي الفلسطينيون واللبنانيون أهمية الردع في تصدّيهم للاحتلال. لذلك يسعون لامتلاك وسائل ردع حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانات العسكرية والتكتولوجية بين الجانبين. لذلك تبنّوا مبدأ «توازن الرعب» لردع العدوان، الأمر الذي أدى لتعقيد المهمة الإسرائيلية. فقد ارتكبت «إسرائيل» من جرائم الحرب ما يكفي لإدانة العشرات من مسؤوليها بالإضافة لرئيس وزرائها الذي أعلنت محكمة الجنايات الدولية قرارها بمقاضاته. ويمكن القول إنه برغم التفوّق العسكري الإسرائيلي أصبح هناك حالة من توازن الرعب. فبعد أن حصدت آلة الموت الإسرائيلية قرابة 40 ألفا من الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، ودُمّرت الأبراج على رؤوس ساكنيها ومُزقت أشلاء الأطفال في واحدة من كبريات جرائم الحرب في العصر الحديث، سمح الفلسطينيون واللبنانيون لأنفسهم باستهداف بؤر الاستيطان خصوصا في شمال فلسطين.
الردع سلاح فاعل لضمان أمن العالم واستقراره، بشرط أن يبقى ضمن الضوابط والأخلاق والقانون الدولي. وفي الحالة الفلسطينية أصبح مطلوبا إفهام المحتلّين بأن سياسة «توازن الرعب» سوف تضرّه على المدى البعيد.
كاتب بحريني