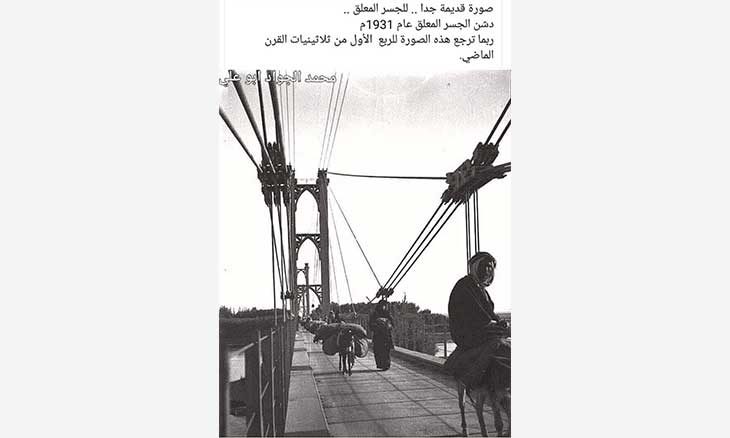
يمكن قراءة ثنائية الشاوي والمديني في سياق اقتصادي صرف، في لعبة المركز (المدينة) والأطراف (الريف)، المدينة التي تعني مثلث الثكنة والسوق والمعبد، والريف الذي يعني (خزان الطعام). منذ آلاف السنين نشأت الحواضر ثم تطورت إلى تجمعات بشرية معقدة، وتحولت من قرى كبيرة إلى مدن.
حين كنت أقرأ المقامة البغدادية على تلاميذي، كنت أتذكر أسلافي وهم يتلقون «المقالب» في المدن الكبيرة، في ساحة «بنقوسة» في حلب. ولم يكن «عيسى بن هشام» غير بديع الزمان الهمذاني نفسه، المديني، الساخر، اللامنتمي، الصعلوك، الذي أنتجته المدينة، التي وجدت في زيارة الريفي للمدينة انتهاكًا يجب الرد عليه. هكذا كنت أحسب أجدادي، وهم يقطعون مسافة أيام على ظهور الدواب لبلوغ قصدهم «حلب».
سبق بديع الزمان بنحو مئة عام أبو الفرج الأصفهاني. كان السوادي المفارق والمختلف هنا هو «ناهض بن ثومة»، الذي حضر عرسًا في حاضرة قريبة من حلب، وكانت «صدمة حداثة» خفيفة، ظن فيها الأعرابي أن خبز الصاج قمصان، وأن الخمرة دواء يقاوم الإسهال. الطريف في الأمر أن الأعرابي ناهض بن ثومة هو من يسرد الحكاية، على سبيل الطرافة في حضرة والي البصرة (قثم بن جعفر بن سليمان). يؤدي الأعرابي الشاعر الفصيح الفارس، دور المهرج الحكاء، ليدخل السرور على أهل المجلس. يقول الراوي إن أباه ظل يضحك حتى سقط، وإن ناهضًا كان يعيد الحكاية ويُطرف بها إخوانه، فيضحكون منه. كان أبو الفرج الأصفهاني قد جمع أخبار الأغاني في النصف الأول من المئة الثالثة، وأثبت تلك الحكاية بعد حدوثها بأكثر من مئة عام تقريبًا، ناقلًا إياها عن ست رواةٍ متوالين. وللمتأمل أن يحسب أن حكاية البدوي في عرس، تطوير لمسامرات المربد ونقائضه، حين تجمعت القبائل الوافدة من الجزيرة، وأنشأت «هايدبارك» شعريا، ظلت نقائضه الساخرة مادة خصبة في الدرس الأدبي حتى يومنا هذا.
من ناهض بن ثومة «الأعرابي» إلى أبي عبيد «السوادي» كانت المدينة العربية في قد أتمت نحو أربعة قرون، تجمع فيها من «كل لسنٍ وأمة» وقد أعادت مبكرًا مفهوم الانتماء، من رابطة الدم إلى رابطة المكان، الانتماء الذي تبناه أهل الحلم والحكمة منذ الأحنف بن قيس التميمي البصري: «يا معشر الأزد وربيعة من أهل البصرة، أنتم والله أحب إلينا من تميم الكوفة، وأنتم جيراننا في الدار». لم تكن البصرة يومها أتمت الخمسين من عمرها، ولكن المزاج المديني – الذي وجد في مسرح المربد تصريفًا لبقايا الرغبة البدوية في الغزو والحرب في معارك من دون دماء – كان ميالًا إلى الهوية الجديدة التي اقترحها الأحنف.
قصد الشاوي الجديد (السوادي) بغداد مركز العالم، ولم يجد الصعلوك عيسى بن هشام طريقة سهلة سريعة لكسب الرزق، غير خداع الأعرابي بأخذه إلى سوق المتعة، حيث اللحم والحلوى والشراب البارد، قبل أن يخسر عشرين درهمًا «ربما كانت كل ما في صرته من مال»، ليكتشف جدنا أنه وقع فريسة الجهل. في السياق يجب أن يضحك المتلقي، ويعجب من كوميديا الموقف، والثوب البلاغي الجديد الذي اقترحه الهمذاني في مسعى لتطوير الأدب العربي، والانتقال إلى السرد. ولكن لم يفكر أحد بجدنا السوادي: هل جاء المدينة ليشتري كسوةً لأولاده؟ أم جاء لسداد دين؟ أو للاستشفاء؟ كنت أقرأ على طلبتي مستظهرًا شيئًا من المقامة، لأضحك وطلابي (السواديون الجدد) بدون أن ندري أننا وقعنا في الخديعة مرتين.
في أخريات القرن الماضي، أنجز الشوايا نخبتهم، أنجزوها بفضل المدينة، وببطولات فردية مليئة بأوجاع الدراما: «أطباء ومهندسون وقضاة ومحامون وأساتذة جامعات، وأدباء وصحافيون»، ذرعوا شوارع المدينة التي كانت مثار الرهبة في عيون أسلافهم، ولكن هذه النجاحات ظلت نبتات برية أليفة، حبات رمل جميلة تأبى أن تمتزج. وظلت بلاد مستطيلة الحزن والألم، تعاني قلق المكان والزمان.
كانت المقامة المعبر الطارئ عن «اللامنتمي العربي» المشبع بثروة بلاغية أنتجتها كتاتيب المدينة، التي بدأت تفقد هويتها العربية، في صراع ثقافي حقيقي تعاقبت فيه هممٌ العرب والفرس والترك، على التحكم بالمدينة التي تحكم العالم، وفقد الأدب نشوته البدوية الأولى، رغم هزات ارتدادية ستأتي في حالات فردية. لم تكن الكارثة المغولية فصلًا رابعًا في الحكاية، بقدر ما كانت فصلًا غير متوقع، وبدت مدينة جديدة غريبة، اختُصِر فيها الأعرابي إلى «العْرُبي» أو «الشاوي» ولكن لعبة المركز والأطراف ظلت تلك اللعبة الأبدية القاسية. ولم تكن حلب تلك المدينة التي حدثت بقربها قصة الشاوي القديم جدنا «ناهض بن ثومة»، بل باتت درة الشرق، وصلة الوصل بين أوروبا الناهضة، والشرق المزدهر، في ما يسمى «درب الحرير». وفي الشمال السوري كانت بقايا القبائل العربية الناجية من مذابح المغول تؤسس بناءها الجديد، في الحيز الممكن من الحياة.
ومثلما كان ناهض بن ثومة، وأبو عبيد يقصدان المدينة، كان أحفادهم يقصدون حلب، والشام، والموصل، ودير الزور. ترتبط زيارات المدينة بالمتعة «تجهيز العرائس، الاستجمام، الاستشفاء» وفي مواسم «جز الصوف» و»السمن» و»الجبن» و»حصاد الحنطة والشعير» و»قطاف القطن»، يمكن للأسر الصابرة المنتظرة أن تبدد ثروتها الطارئة في «التمدن». تحفل ذاكرة أبناء الريف بالزيارة الأولى للمدينة، حيث مطاعم الكباب، والبوظة، والمنامة، في «الخان»، ولكن الأمر لا يسلم من «الزعران» و»الكشتبانجية» المتربصين بالأعراب في أسواق المدينة، وقد تجددت طرائق أحفاد عيسى بن هشام، وقد استمعوا نصحه «إعمل لرزقك كل آلة» في اصطياد المساكين المتسللين إلى فضاء البهجة المسبوق بتحذيرات مخيفة من «النشترية والنصابين».
ظل الشاوي أسير صورة نمطية مؤسية في المخيال المديني، وظل ذاك السوادي الذي «يسوق حماره، ويطرف بالجهد إزاره»، إلى أن زارها بغير قصد المتعة، طالبًا للعلم والعمل. تحتفظ قبائل الجزيرة الفراتية بأسماء عدد غير قليل من أبنائها الذين نجحوا وتفوقوا، وبزوا أقرانهم «المدينيين» في النصف الثاني من القرن الماضي، كان التعليم يثير شهية الريفيين. ضحى كثير من الآباء بما يملكون لتعليم ولد واحد «نجيب»، وكانوا ينجزون لوحات شرف شفهية يقلبونها في مجالس سمرهم. وفي سنين تالية من عمر الحداثة كانت طاقات شباب الأرياف ترفع أعمدة البناء في الأحياء الجديدة في حلب ودمشق وبيروت وعمان. حينذاك اختفت صورة «الكشتبانجي». ولكن الإطار القديم للبدوي ظل مثبتًا في جدار المدينة.
حين رسم الأديب الشيخ علي الطنطاوي صورة البدوي؛ فإنه لم ينج من المسارات القديمة التي صممها بديع الزمان الهمذاني، ولم يكن الطنطاوي «لامنتميًا» فقد كان صاحب مشروع، ولكن اتجاه الشيخ الأدبي الذاهب إلى الطرائف أحيانًا، جعل من البدوي نسخةً من بطل المقامة البغداية، مطعمة بمزاج ناهض بن ثومة المتندر. يسرف الطنطاوي في وصف البدوي في سوق الحميدية الذي يقع ضحية «الحضر» الذين يستغلون صدمته بالحداثة الجديدة، في موقفه من الجرائد، والسينما، وتقبل الضيافة التي يفاجئه صاحبها بوجوب دفع الثمن. ولكن الطامة الكبرى تحدث حين يدخل السينما، ويتخيل أن ما يشاهده حقيقة في الفيلم، فيهب لنجدة المظلومين: «وإذا بالخيل تهجم علينا مسرعة حتى كادت والله تخالطنا. فقلت: لك الويل، ثكلتك أمك، إنه الغزو فما قعودك؟ وقفزت قفزاتي في البادية، وصرخت، وهجمت أدوس على أجساد الناس وهم يضجون ويصخبون، فلما كدت أبلغ الخيل اشتعلت الأنوار، وفرّ العدو من خوف بطشي هارباً، وجاء عبيد السلطان ليخرجوني فردهم عني صاحبي وكلمهم».
في المقابل كانت القرى بالنسبة إلى أهل المدن مظانا لجلب الرزق. فكان يقصدها البياطرة (حذاؤو الخيل) والربابون مبيضو النحاس، وتجار الجبن والصوف، وصانعو اللبابيد وغيرهم. في ما بعد باتت المدينة تصنع الخوف، حين أرسلت إلى الريف عساكر الدرك والمعلمين. ولم يعد الخوف يطال الذاهبين إلى المدينة، بل صار إطارًا عاما في حياة الريفيين، إذ يعاني أولادهم في المدارس، فيما يعانون هم حين تمر سيارات «الأندروفر» الرصاصية، للموظفين والشرطة.
في أخريات القرن الماضي، أنجز الشوايا نخبتهم، أنجزوها بفضل المدينة، وببطولات فردية مليئة بأوجاع الدراما: «أطباء ومهندسون وقضاة ومحامون وأساتذة جامعات، وأدباء وصحافيون»، ذرعوا شوارع المدينة التي كانت مثار الرهبة في عيون أسلافهم، ولكن هذه النجاحات ظلت نبتات برية أليفة، حبات رمل جميلة تأبى أن تمتزج. وظلت بلاد مستطيلة الحزن والألم، تعاني قلق المكان والزمان.
٭ شاعر وكاتب سوري
متعتنا استاذنا الكريم شكرا
شكرًا أستاذي
شكرا لهذا المقال الرائع
شكرًا جزيلًا