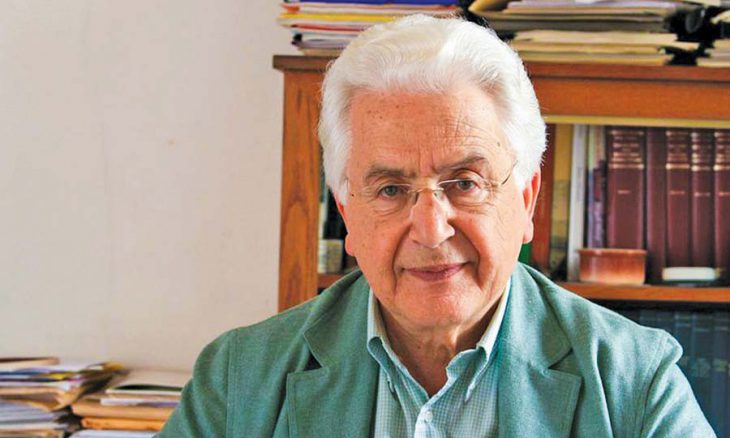
ثمة الكثير مما يمكن أن يُقال عن الفكر العربي، ومخاض البحث عن صيغ فاعلة، كما ثمة مشاريع كثيرة سعت إلى اختبار ذلك بهدف الخروج به من التيه والاضطراب بعد قرون من ضمور الوعي العربي، غير أنّ الإشكالية تتصل بالهدف القائم على محاولة الخروج من حالة الضعف والهوان إلى مرحلة القوة والكرامة، فعلى الرغم من السيادة الظاهرية نتيجة الاستقلال، غير أن القدرة على اجتراح منظومة فكرية تفعّل معنى الاستقلالية التامة، والرشد عبر تقديم المصلحة العليا للذات على مصلحة القوى الأخرى، ما زال غير متحقق، فثمة نموذج تابعي مستقر في الوعي العربي تجاه قوتين متعاكستين الماضي والحاضر، كما ارتهان مستمر ومرضي للقوى الإمبريالية.
ولعل التفكير في هذا يقونا إلى الإقرار بوجود مشاريع فكرية ذات مرجعيات متعددة؛ كالدينية مروراً بالقومية، واليسارية، وليس انتهاء بالوطنية أو الشعبوية، لكن ثمة قاسما مشتركاً بين هذه المشاريع، هو أنها غالباً ما تُجهض، ولا تستمر، ولعل هذا ما يدفع إلى التساؤل عن هذا الاستغراق في محاولات استعادة القيمة الحضارية والثقافية والإنسانية للثقافة العربية، على الرغم من عمق مخزونها، حيث تمكنت أمم أقل عمقاً من تجاوزها، وأن تتمكن من فرض وجودها! فهل تكمن المعضلة بأن هذه الأمة لا تمتلك تصوراً واضحاً تجاه المستقبل؟
عند النظر إلى بعض نماذج الفكر العربي سنجد أنها مرتهنة لثنائيات، ما يعني خللاً نتيجة عدم القدرة على تكوين أفق حيوي، وإذا ما نظرنا إلى بعض الأسماء أو المشاريع الفكرية فسنرى أن الجابري -على سبيل المثال – يختصر أزمة العقل العربي بسيادة النموذج التقليدي السائد نحو البحث عن عقلانية قريبة للنموذج الغربي، مع التركيز على التراث، وتمثله ضمن منظور غربي وصولاً إلى الديمقراطية، وكما محمد أركون في مناقشة البعد العلماني، وأثر التاريخ، وكما طه عبد الرحمن في نزعته إلى العقلانية، واكتناه التاريخ، بالإضافة إلى العروي، وغيرهم… وكلها تخلص إلى أن القيمة المنوطة قد تتصل بثنائية تنطلق من الأنا والآخر، كما أثر الماضي والتاريخ، فضلاً عن الضّبابية تجاه صيغة المستقبل.
لعل الفكرة التي أريد أن اختبرها أن المعضلة لا تكمن في الماضي بوصفه متعالية ينبغي أن تُستعاد فحسب، لكنها تتعلق بالمستقبل، فثمة غموض يتعلق بتعريف المستقبل، أو الصيغة التي ينبغي للثقافة العربية والوجود العربي أن يتخذها، وهي لا تتعلق بهوية الأيديولوجيا أو المشروع بمقدار ما تتعلق بما يعني المستقبل للذات العربية بشعوبها، وحكوماتها، أو جودها الكلي، لكننا نشهد على الدوام انفصالا بين السلطات من جهة، والشعوب من جهة أخرى، فالمستقبل لكلا الكيانين يخضع إلى تأويل مختلف، فمستقبل السلطة يختلف عن مستقبل الشعوب، في حين ثمة من يبحث عن نموذج مستقبلي ينسخ الشكل الماضوي، الذي لم يعد صالحاً بصيغته السابقة، وهناك مستقبل ينهض على مشروع فكري يخضع لمتعالية الغرب، وهناك مشاريع تنهض على القومية العربية، وكل هذه النماذج لا تتعلق بحقيقة إدراك أن الخلل يكمن في أننا ننظر إلى هدف لم يعد قابلاً للتحقق كون المعايير التي سادت في زمن لا يمكن أن تستجيب إلى هذه النظرة المغلقة، بانفصال عن فهم الحقيقة المطلقة لهذا الكون، وأنها تعني أن واقع هذا العالم ينطوي على معنى، أو مقولة المصلحة، التي يمكن أن تتحقق من اتباع نموذج حضاري ينهض على المصالح العليا المشتركة، ما يعني أننا إزاء نموذج شبه مثالي.
لعل ضعف السيادة يتأسس على الصراع على الشكل، وتوجس الذات العربية من نفسها، فثمة إقصائية واضحة، وقلة نضج وخبرة قراءة كيف يعمل هذا العالم، إذ ما زال العقل العربي يفكر بمبدأ النمط الرعوي والقبلي الذي ساد العقل العربي، على الرغم من التّخفف منه في بعض مراحل التاريخ.
نبدو اليوم أقرب إلى مقولة التيه نتيجة اختلاف التفسيرات للشكل الذي يجب أن نكون عليه، لكن المتأمل في هذه المعضلة سيدرك أنها مشكلة شكل أو صيغة، وليست جوهر الموضوع، فلكل أمة أهداف محددة تنهض على مبادئ إنسانية كبرى، ومبادئ وطنية، وهي تتصل بقيمة الإنسان وحريته، ومن ثم تطوير أمة لا تفقد سيادتها بين الأمم، كما يحصل الآن تجاه الحرب في غزة، إذ تبدو الأمة العربية فاقدة لسيادتها، فهي ضعيفة لا تستطيع أن تقف في وجه الكيان الصهيوني الدموي المدعوم من الغرب، الذي لا يعترف إلا بمصالحه العليا القائمة على النظر إلى العرب بوصفهم نموذج التابع ضمن مقولة الاستعمار الجديد، وهي صيغة قوامها البعد الاقتصادي في المقام الأول، كما أشار إلى ذلك كوامي نكروما الرئيس والمفكر الغاني، في توصيف مفهوم الكولونيالية الجديدة، فالغرب يفيد من الدول العربية، أكثر مما تفيد الشعوب العربية من دولها، فبعض الحكومات تبدو عالة على شعوبها.
لعل ضعف السيادة يتأسس على الصراع على الشكل، وتوجس الذات العربية من نفسها، فثمة إقصائية واضحة، وقلة نضج وخبرة قراءة كيف يعمل هذا العالم، إذ ما زال العقل العربي يفكر بمبدأ النمط الرعوي والقبلي الذي ساد العقل العربي، على الرغم من التّخفف منه في بعض مراحل التاريخ، ثمة افتتان مرضي بالغرب بل ينظر إليه على أنه (إله) ينبغي الإيمان به، على الرغم من كل خطاياه، بل إنه لا يعبأ إلا بمصالحه الخاصة، وفي حالة تجزّؤ المصالح العربية، وتعارضها فإن الوعي العربي ينخرط مع هذا الإله الورقي كي يحافظ على منطق المجموعة الضيقة، ويتناسى القيم الكلية والجمعية، لما يمكن أن نطلق عليه أمة عربية.
تبدو الصورة أقرب إلى خشية العقل العربي من فقدان الغرب.
الشعور بوصاية الغرب أمست معضلة بنيوية عميقة، أو جزءا من تشوه العقل العربي، الذي فقد الثقة بنفسه، ولم يعد يرى وجوده إلا أشبه بنموذج متصل بصورة عضوية بالغرب، أو أشبه بذلك الاتحاد بين الإنسان والروبوت، أو مفهوم السايبورغ – حسب قول دانا هاراواي واضعة مانفيستو السايبورغ الشهير- وهي صيغة تبدو معقدة، حيث الخوف من أي انفصال عن الغرب سيؤدي إلى الموت العضوي، وكأن العقل العربي بات متصلاً بما يؤمن به الغرب، وما يقوله، ولاسيما النموذجين الاستعماريين (الولايات المتحدة وإنكلترا) فقيمة التفكير لدى العربي متصلة بما يفكر به الغربي، أو ما يريده، وما يؤمن به، ولا يوجد أي قيمة أو فعل حيوي للعقل العربي الساكن، الذي يمارس فقط تابعية ماضوية أو تابعية راهنة للغرب مع غياب للتفكير في المستقبل.
لقد تمكن الغرب من خلق منظومة أطلقت عليها الخطابات ما بعد الاستعمارية، الوكلاء المحليين، ودورها أن تعطل إمكانات العقل العربي المجزأ والمُتشظي، وهي سمة تبدو ملازمة له، على الرغم من المحاولات التي سعت إلى تجاوز هذا الخلل البنيوي في العقل العربي، سواء أكان عبر النموذج الديني أو القومي أو الأممي، غير أنّ هذا الخلل ما زال عصياً على المعالجة، ولعل في سرديات التاريخ ما يؤكد ذلك، فثمة – دائما- رفض لأي مشاريع تعاونية أو مشتركة، أو وحدودية، على العكس مما نراه في الغرب الذي أدرك بعد الحرب العالمية الثانية قيمة النموذج التعاوني، فسعى إلى بناء نماذج التحالف كما نراه في الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو الذي ينهض على معنى المصالح المشتركة عبر التخلص من المصالح الضيقة والنزعات الشوفينية، ويمكن أن نلمح ذلك في النموذج الخطابي، حيث يلجأ الغرب إلى اجتراح مقولة التحالف – وهو مصطلح مفضل في معجمه – عند مواجهة أي أزمة، غير العقل، إن العربي لا يعرف معنى التحالف أو التعاون المشترك إلا مع الغرب حين يطلب منه، لكنه لا يستطيع أن يتحالف مع نفسه الأخرى ضد عدو حقيقي ومجرم.
إن وعي الفكر يتأسس على الإنسان الذي ينبغي أن ينتمي إلى المستقبل، لا الماضي، ومن ثم تقدير هذه الذات، فالفكر العربي يعالج مشاكله ضمن وعي ماضوي متصل بذاته والآخر، أو أنه يمضي إلى آخر المطاف بالتعويل على الغرب، الذي يسعى بكل السبل إلى خلق فكر عربي عالق لا يتقدم، أو أنه لم يعد قادراً على أن يدرك الرشد، كونه لا يؤمن بنفسه، أو بقدرته على التغيير، فالثقافة العربية مرتبكة تجاه كل شيء، لكننا نتوافق على أنها دائماً ما ترفض كل ما يمكن أن يتصل بحرية الإنسان العربي، ربما كونها تعلم أن الحرية هي القادرة على إنتاج فكر ناضج، يجد طريقه تبعاً لوقائع الواقع، لا استيهامات أو ارتهان لقيم لا تتعلق بالإنسان، بوصفه المنطلق الأول، فعقلية الوصاية جزء من تشكيل العقل العربي، مع رفض لتحرير العقل، واحترام الفرد، وخصوصية ما يريده.
كاتب أردني فلسطيني