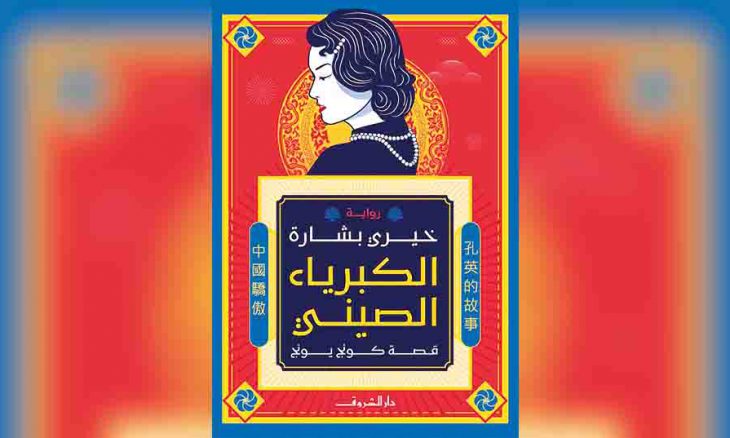
من أكثر الأعمال الأدبية التي تستولي على الذائقة وتجعل المرء أسيراً لقراءتها المشوقة، المفيدة، هي تلك السير الذاتية، والمذكرات، التي يكتبها مخرجو السينما العالمية الكبار، أمثال الإسباني العظيم لويس بونويل ورائعته «مذكرات بونويل» التي أشاد بها غابرييل غارسيا ماركيز، وعدَّها من روائع الأدب العالمي، والسيرة الذاتية للمخرج الإيطالي ذائع الصيت فدريكو فيلليني «أنا فيلليني»، وكذلك الياباني أكيرا كيروساوا «عرق الضفدع»، ثم رائعة إنغمار بيرغمان المخرج السويدي الكبير «الناى السحري»، والمخرج الروسي الفيلسوف أندريه تاركوفسكي «النحت في الزمن»، وآخرين شكلت أفلامهم وكتاباتهم علامات بارزة في المجالين، كالمخرج الأمريكي المتفرد «وودي ألان» الذي يراوح بين الكتابة والسينما، متفوقاً في المجالين.
في هذه الأعمال تجد متعة السرد الروائي، الذي ينهل من الحياة الشخصية: السيرة الذاتية الخاصة، والسيرة الفنية، عبر سياحة تأملية في عوالم بالغة الثراء، غنية بالتفاصيل المذهلة، التي تغطي صوراً مختلفة لهذا العالم الساحر: فنون الدراما، الصورة، الموسيقى، التمثيل، الفن التشكيلي، التقنيات الفنية لهذه الصناعة المبهرة. ومن ثم يتسنى لنا الاطلاع على خبرة فنان، يجيد الكتابة كما يجيد الإخراج، يضع عصارة خبرته على الورق، بمهارة فائقة، ومعرفة دقيقة بالنوع الأدبي الذي انتقل إليه من فن السينما، ليصنع بالبراعة نفسها، عملاً فارقاً، كمنافس عنيد لكبار كتاب الرواية.
هنا، أيضاً، في السينما العربية ثمة أسماء مهمة، تركت بصمات مشهودة في عالم السينما، كالمخرج المصري الكبير خيري بشارة، صاحب مجموعة من الأفلام التي تعد من علامات الواقعية الجديدة في السينما العربية. كـ«العوامة 70» و«الطوق والإسورة» و«يوم حلو ويوم مر» وغيرها. والذي فاجأ الأوساط الثقافية بصدور روايته «الكبرياء الصيني» في تحول نوعي إلى عالم الأدب من خلال رواية كبيرة نسبياً (ما يربو على 500 صفحة) رواية خالصة، لا سيرة ذاتية، تمثل واحدة من الانتقالات المدهشة حقاً. حافلة بالبناء نفسه، الذي يكون به المعمار الفني لسيناريوهات أفلامه، وبالطريقة التي تُبقي المشهد حياً من خلال الصراع الدرامي، حيث العنصر المهم، أن تُبقي كل شيء حقيقياً، من خلال التعبير عن الحركة الداخلية والخارجية للأبطال، محولاً آلة التصوير السينمائية إلى قلم، يرصد به حركة الزمان، والمكان، والشخصيات، وينسج به الأحداث، بالحرفية ذاتها، التي كانت تسعفه كمخرج نابه، مشهود له بالكفاءة والحرفية.
وعلى طريقة التحضير للأفلام، وضع خطة للعمل كمشروع فني، جلب كل العناصر التي سيتم العمل بها، ومن خلالها. ففي السينما لا يتم البدء بتصوير الفيلم من نقطة الصفر، كل شيء سابق التجهيز: السيناريو الذي صار فناً مستقلاً الآن. الممثلون، فنيو التصوير، الإضاءة، الصوت، المونتاج، الديكور، معاينة المواقع التي ستجري فيها المشاهد..إلخ. لا يوجد فيلم يبدأ من فراغ سوى في حالات نادرة جداً لبعض المخرجين التجريبيين، كالفرنسي الملهم جان لوك غودار، الشهير بالارتجال والتجريب.
بهذا الاحتشاد والجاهزية، انطلق خيري بشارة، في رحلة شاقة من البحث والتقصي، ليدعم عمله بالعناصر التوثيقية، كأنه بصدد فيلم تسجيلي، عائداً إلى البدايات، عندما أخرج بعض الأعمال التسجيلية. لكنه هنا، أطلق العنان للخيال، مخلصاً لرؤاه الشخصية التي دمغت كل مشهد ببصمته الخاصة، وأفكاره الذاتية. تاركاً للوقائع الحقيقية فرض نفسها بعيداً عن التصريح المباشر، أو الرصد المفرط في الواقعية.
وحتى يبعد الطابع الوهمي لعمله، انطلق في تمهيد تاريخي، استعرض فيه حقبة أواخر الستينيات، ثم السبعينيات، راصداً بدقة تلك الأحداث السياسية والاجتماعية، التي تلت هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو 1967م. من خلال بطله «آدم» الذي كان أقرب إلى تمثيل وجهة نظر الراوي العليم، المؤلف، فيما جرى وقتها، رأيه الخاص، وتداعيات هذه الحقبة على شخصية البطل. إن بشارة، يستعيد معنا ذكريات تلك الأيام، حراك الطلبة الغاضبين، المطالبة بالحرب لاسترداد الأرض، والثأر من الهزيمة، عام الضباب، عام الحسم. التخبط الأيديولوجي لهذه الفئة من الشباب وقتها، هؤلاء الذين تفتح وعيهم على الأحداث الكبرى. لقد وجه عين الكاميرا، على اتساعها، وراح يتجول داخل أركان المجتمع. التقط بروز أسماء مثل الثنائي الشهير الشاعر المتمرد أحمد فؤاد نجم، والموسيقار والمغني الثائر الشيخ إمام عيسى. التفاف الطلبة الحائرين حولهم، انتشار أغانيهم، وإعادة ترديدها بين أوساط المثقفين، المعنيين بالقضايا الوطنية. الشاعر الكبير أمل دنقل وقصيدته «الكعكة الحجرية». ونجيب سرور بفورانه، وجموحه. ذكر اسم المناضلة اليسارية أروى صالح، كصديقة للبطل، حيث يمعن الكاتب هنا في حصر المعلومات الحقيقية عنها، الأسماء الحركية لها كمناضلة في الحزب الشيوعي، حتى نهايتها المأساوية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق العاشر. أحمد عبد الله رزة، زعيم الحراك الطلابي وأيقونة جيل السبعينيات، هو وزهرة الحركة الطلابية طالبة الهندسة سهام صبري التي كانت تتمتع بالجمال والثورية، وتلهب حماس الطلبة عن طريق الخطابة، والجسارة النادرة. تلك التي لا تعرف الخوف، نفس التأثير الطاغي على من حولها، إلى الدرجة التي شعر فيها آدم بأنه وقع في غرامها، مفتوناً بعينيها الزرقاوين، وبشرتها البيضاء الناصعة، في الوقت الذي كان يراها صوت الجيل هي وعبد الله رزة صاحب الخطب النارية.
ويعرج بشارة على سنوات صعود التيار الإسلامي بالجامعات المصرية، وإطلاق حريتهم للقضاء على اليسار بجناحيه، الماركسي والناصري، في فصل استعادي لمرحلة لا تنسى من تاريخ مصر. ليوغل بعدها في تشريح الحيرة الوجودية لآدم، صيني الأصل، الذي سنذهب معه، فيما بعد، إلى أشد العوالم دهشة وإثارة في الرواية العربية الحديثة، عبر محاولات مستمرة لاكتشاف العالم، وإعادة اكتشاف مناطق زمنية معتمة في دول عريقة كمصر والصين، والهبوط إلى الماضي القريب، الأحداث الكبرى التي جرت في العصر الحديث للبلدين. وهذا عبر رحلة «كونج يونج» والد آدم، الذي هو الشخصية المحورية للعمل، التي ستدور حولها أحداث عقود مضت من تاريخ مصر والصين، ومن تاريخ العالم الخارجي، خروجه من وطنه، حتى لحظات وصوله إلى مصر، وزواجه واستقراره فيها.
أثناء وقوع آدم في متاهة الأفكار، والحيرة البالغة، تجذبه عوالم التصوف، تفتنه سيرة القطب الكبير أبو الحسن الشاذلي، بعد زيارة إلى «مقام» الشيخ الجليل، الواقع في أقصى جنوب مصر، رفقة أحد أصدقائه. يأخذه هذا الجو الروحاني من تقلبات السياسة، ومن دراسة الطب، إلى عالم الرهبنة كشخص مسيحي الديانة، يذهب إلى دير الأنبا أنطونيوس، أول من سكن البراري بالصحراء الشرقية بالقرب من البحر الأحمر. يلجأ آدم إلى الدير بعد مواجهة عنيفة مع والديه، لقد اختار أن يهب روحه لملكوت السماء، بتولاً، لا يتزوج مدى الحياة، مدرباً نفسه على ألا يأكل شيئاً إلا الضروريات، وأن يكون مطيعاً لأبيه الروحي في هذا المكان النائي.
هنا يستفيض بشارة في شرح تفاصيل هذا العالم، خطواته كافة، يبين المراحل التي تسبق استحقاق رسامة الرهبنة، واتخاذ اسم ديني جديد بدلاً من الاسم العلماني، ليصير آدم بعدها ملقباً بجبرائيل الأنطوني. لكنه يقطع هذه التجربة، بعدما شعر برتابة الحياة داخل الدير، وبعد تشككه في الدين نفسه، وتذكره أن أباه أصبح مسيحياً فقط ليتمكن من الزواج بأمه. عادت الدنيا تزهر في عينيه، دنيا الحقيقة التي تحتوي على كل العناصر والمتناقضات، والتي تستحق أن يخوض المرء فيها تجربة الحياة، واقعاً بين ثنائية الخير والشر. لقد شعر بأن من ترهبن فقد مات. يترك الدير عائداً إلى القاهرة، رفقة المصورة الصحفية، إيطالية الجنسية ستيفانيا، التي حضرت إلى المكان لتصوير طقس رسامة الرهبان الجدد. كان رئيس الدير قد طلب منه أن يصحبها ويساعدها على إنجاز عملها، ترافقه ستيفانيا، فيما بعد، كصديقة وعشيقة، ضمن محطات حياته الغرامية، التي لا تخلو من النساء العديدات.
لقد تخلص من رحلة إثبات وجود الله، ولم يعد رهين حالة الشك واليقين، تاركاً نفسه لإحساسه الذاتي، يحيا وفقاً للنمط السائد، مندغماً مع إدراكه الحسي، بعيداً عن الشرود الذهني، وحالة الزهد. إنه يعود إلى الدنيا، لنبدأ معه رحلة البحث الشائقة، المثيرة، عن والده كونج يونج الذي استيقظ ذات صباح ولم يجده في المسكن. لقد تفوق بشارة على نفسه، وعلى كثيرين ممن يكتبون الرواية، وهو يخترق بنا أشد جوانب الحياة غموضاً وإثارة، مستخدماً كل الحيل الفنية، في اعتصار فني للتاريخ، والجغرافيا، والسياسة، والأحداث الكبرى. ما جعلنا نستعيد معه أجزاء من حياتنا وتاريخنا الشخصي، ونطلع على ما لم ندركه زمنياً، ملمين بدقائقه، معيدين اكتشافه كأنه حدث فوراً، ممتنين لهذا الدأب على جعل الرواية عملا معرفياً شائقاً، وبأنه صار لدينا كاتب موثوق، مرموق، على غرار السيميولوجي الإيطالي الشهير إمبرتو إيكو صاحب رائعة «اسم الوردة» الذي أثبت أن البحث والتحري والسعي وراء الوثيقة، ودراسة التاريخ، من الممكن أن ينتج عملاً روائياً خالداً.
إنها سيرة الهجرة والخروج من بلد إلى بلد آخر، هروباً من الفقر والجوع، وفقدان الحبيبة، على يد إحدى العصابات، السعي وراء هوية مفتقدة، عبر تغريبة دائمة، نطالع خلالها ما يجري من أجل تركيع الصين، واستعمارها، حرب الأفيون، تخدير الوعي، وجعل البشر خاملين، مجرد أرقام، لا قيمة لهم. يصل كونج يونج إلى مصر في رحلة ملحمية، تتبع بشارة مسيرتها، على نحو شديد الإثارة، مخلصاً للتصعيد الدرامي الذي يصنعه كاتب سينمائي، بنية شد انتباه المشاهد إلى الدرجة القصوى. يبدأ معه رحلة في مصر الملكية، عالم الأرستقراطية، والطبقة العليا، مؤرخاً للأحداث، على نحو مبتكر، بالأفلام المصرية، فهو لم يستطِع تجاهل عشقه للسينما كأحد صناعها الكبار، المتيمين بها، من زمن الطفولة، ومن قبل التفكير في العبور إلى هذا العالم الساحر.
لا أدري كم من السنوات قضاها بشارة، كي يجمع مواد هذه الرواية، والمعلومات الوفيرة حد التطرف، أعتقد أنه أجهد نفسه، معطياً للعمل الصبور، الجاد، حقه، لكي يطلعنا على أكثر من عالم، ولنكتشف معه أننا بإزاء رواية (مخدومة جيداً) تلعب على البعد المعرفي، ربما تغني القارئ عن قراءة عديد من كتب السياسة والتاريخ، في الوقت نفسه الذي لا يفارقه الاستمتاع بسحر السرد وهو يطالع الرواية. لقد فعلها بشارة، واستطاع أن يضفر الحوليات، وعلوم التاريخ المختلفة في ملحمة كونج يونج، أو ما سماها بـ«الكبرياء الصيني».
لقد كانت الرواية مثل السينما تماماً، وهي تستعير تقنياتها، لتكون عيناً مفتوحة على اتساع العالم، محتفظة في طياتها بنقاء النثر، وهو يصور مشاهد الحياة المختلفة.
خيري بشارة: «الكبرياء الصيني»
دار الشروق، القاهرة 2023
517 صفحة.