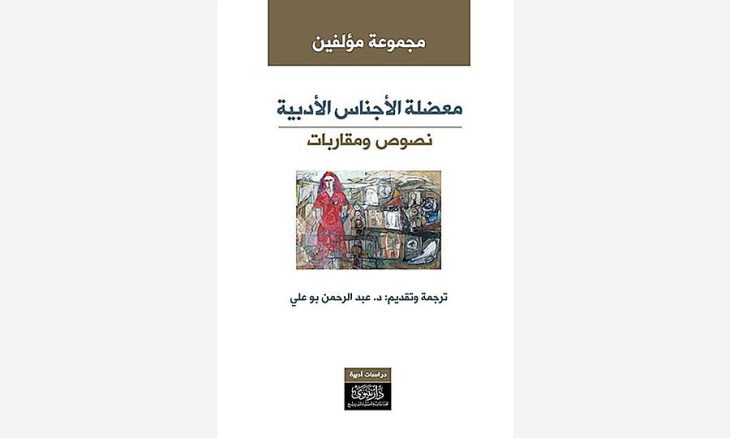
مقولة النوع
إن أي دراسة علمية تتطلب تعريف المصطلحات، بما فيها المفاهيم التي تستخدمها؛ فمنذ «فن الشعر» لأرسطو، مرورا بـ«علم الشعر» عند قدماء العرب، كانت النظرية الأدبية تسعى إلى تحديد الأشكال الأدبية وتصنيفها وتقييمها، وكانت تحاول أن توجِد لكل نوع أدبي، تصريحا أو ضمنا، سمات مُحددة تُميزه عن الأنواع الأدبية الأخرى، وترى في ذلك ضرورة في تنظيم حقل الأدب. إلا أن هذه المحاولات كانت بدورها تثير مشكلات نظرية وأخرى إجرائية على مستوى وصف هذه الأنواع وتعريفها وضبط حدودها.
ارتبطت مقولة النوع بمعنى العِرْق (تجميع، صنف) الذي يكاد يسود مجموع الاستعمالات عبر التاريخ، ثم اختفى هذا المعنى منذ العصر الكلاسيكي وصار يدل على صنف من الأعمال تحدده قواسم مشتركة (موضوع، أسلوب، إلخ). ويُظهر مثل هذا التعريف أن مفهوم النوع الأدبي يفيد في تصنيف الأعمال الأدبية وإعادة تجميعها في مختلف مقولاتها، تبعا لمعايير مُحددة، وهو ما عملت على بلورته نظرية الأنواع الأدبية منذ بدايات القرن العشرين، إلى درجة أنه أصبح يُنْظر إلى النوع الأدبي باعتباره مُؤسسة، وبما أن كل مؤسسة تستند إلى تراتبية متواضع عليها، وإذ لا واقع لها خارج التاريخ، فإن ذلك يصح بالنسبة إلى الأدب والأنواع الأدبية. وفي عز البنيوية، باتت الأنواع تمثل «الموضوع المركزي للشعرية». وعدا التعريف الذي يُركز أساسا على العناصر الشكلية والانسجام الداخلي، سيجري التركيز على البعد الدلالي الذي لا يختزل هذه الأنواع إلى مجرد خصائص بنيوية، أي أن معايير تعريفها تحتوي في المجموع على عنصر موضوعاتي ينفلت من الوصف الشكلي أو اللساني الصرف (تودوروف، جينيت..). إلى جانب الرهانات النظرية، يدخل في الاعتبار موضوع التوافقات الضمنية بين القراء والمؤلفين، والنقاد والناشرين، على نحوٍ ارتفع بمفهوم النوع إلى كونه «نموذجا وصفيا افتراضيا» يسمح باستخلاص السمات المشتركة لعدد من الأعمال الخاصة وإعادة تجميعها في صنف أو أكثر بغرض مطابقتها لهذا النموذج. ويتقاطع ذلك مع وجهة نظر التلقي التي ترى أن كل نوع أدبي يخلق «أفق انتظار» خاصا به، لأن المتلقي يستضمر من خلال تجربة حياته اليومية مجموع العناصر الثابتة والمقررة في هذا النوع أو ذاك، ثم لأن هذا الأخير هو نسقٌ يكشف مجموع التوجيهات الضابطة لبعض الممارسات الخاصة بتكوين النص الأدبي وتلقيه.
المعيار والانزياح
رغم ثوابته النوعية وعناصره الرئيسية التي استقرت عبر فترة طويلة، ومن ثم حددت هُويته، إلا أن النوع يمتلك حقلا غنيا من الإمكانات المتنوعة والمتغيرة وحتى المتعارضة، وهو ما يساهم في عملية خلق البنية وتنويعاتها واتساعها بشكل يجعله في غير مأمن من الاختراقات التي كانت تحدث من حين لآخر، وتشوش نظام الأنواع وتراتبيتها المعهودة وترسيماتها الفاصلة، ومن جهة أخرى يساهم في الدينامية التي تنبني على سمات النوع التي يدل عليها المؤلف (جماع القيود الشكلية، الموضوعات، الصيغ والموتيفات، والوظائف التي تناط بها) وعلى سيرورة تعرّف هذه السمات التي ينخرط فيها القارئ (تصنيف، قراءة، إعادة تأويل). ولئن كانت النظرية تتعالى على واقع الأدب ونشاط ممارساته النصية، من خلال عملها على التصنيف وتجريد مقولات النوع الأدبي بين أن يكون معيارا، أو جوهرا مثاليا، أو قالبا للقدرة، أو مجرد مصطلح تصنيفي لا تقابله أي إنتاجية نصية خاصة به، حتى وضعت نفسها في إطار «نظام مغلق» كما يرى جان ماري شيفر، إلا أنه – في المقابل – يجري الحديث من داخل واقع هذه الممارسات عن «انحراف» و«انعدام تحديد أنواعي» وعن كون الأنواع صارت «مركبة» أو داخَلها التهجين، بل عن «انفجار الأنواع»؛ منذ سنوات الستينيات، في خضم الرواية الجديدة، ورولان بارت، ونزعة النص التي دافع عنها فيليب سولرس وجماعة تيل كيل، بحيث اتخذ الأدب والنقد من مقولة النوع الأدبي غريمهما الرئيس، فصار النص الأدبي الحديث هو «المفتوح» بتعبير أمبرتو إيكو.
كم وفيرةٌ هي الأعمال «المفتوحة» التي تضع التصنيفات موضع سؤال بسبب الحيرة المتعاظمة لدى الناشرين والكتبيين وأمناء المكتبات والنقاد، وتضع أصحابها تحت مقولة «المبتكرين» و«غير القابلين للتصنيف». إلا أن ذلك يكشف في حقيقة الأمر عن «براديغم» جديد لن يكون له من معنى إلا في ضوء مقولة النوع نفسها، وإلا بِمَ نفسر- عدا بعض هذه الحالات الخاصة- استمرار العمل بهذه الأنواع (رواية، شعر، مسرحية، مجموعة قصصية، سيرة ذاتية…) التي تزين أغلفة كتب معاصرينا؟ أو الجوائز الأدبية التي لا تكف عن التحجج بقواعد النوع وتلزم المؤلفين بها؟
يضم الكتاب نصوصا ومقاربات لأبرز أعلام النظرية الأدبية المعاصرة (كارل فيتور، إيف ستالوني، فرانسوا راستيي، تزفيتان تودوروف، بيير فانكلير، جان هانكيس، جان ماري سيلان، ساولو نييفا) الذين أشرعوا في العقود الأخيرة آفاقا جديدة من التأمل والبحث في هذه الأنواع، من حيث تاريخها وأصولها، ومفهومها، وأساسها النفسي، وظواهرها الجمالية والنصية.
عودة الأنواع
إن الأنواع الأدبية اليوم في أحسن حال، كأن الحنين يشدها إلى ماضيها، فقد عاد الاهتمام بها في الخطاب النظري والنقدي للأدب، من منظورات مغايرة تستفيد من المقاربات الجديدة التي أطلقتها السيميائيات وجماليات التلقي والتأويلية والبلاغة الجديدة والدراسات الثقافية، بقدر ما قادتها إلى قواعد جديدة من التأويل والتأمل الجمالي، وإلى المتخيل الذي يبنيها داخل التعاريف والأوصاف، عبر نماذج وفرضيات تحتملها «يوتوبيا» النص الأدبي المعاصر. كما أن النقد الجامعي لم ينقطع عن العودة إليها، مثلما تقع في صلب الدرس الأدبي وتعليم التاريخ الأدبي الذي ما زال قائما إلى اليوم على برامج منشغلة بتقســـيم الآداب إلى أنواع.
وفي المجال العربي، اتسعت دائرة الاهتمام بنظرية الأنواع الأدبية من حيث علاقته بالتراث الأدبي العربي، ومرجعياته الجديدة التي ترفد أدوات اشتغالها من أطر البلاغة والنقد المعاصر، فلم تكتفِ بما هو متداول، بل أعادت اكتشاف ما هو منسي ومغمور في ذلك التراث، وجددت وعيها النظري بما استعصى أو استجد من أنواع وإنتاجات نصية. مثلما أن الترجمة ساهمت بقوة في تمتين هذه المرجعيات وبيان ما يحتمله من التباس وغموض واستشكال منهجي، وآخر عناوينها «معضلة الأجناس الأدبية» للشاعر والمترجم المغربي عبد الرحمن بوعلي؛ بحيث تعد هذه النظريةُ «من أقدم قضايا النظرية الأدبية المعاصرة، فقد أولاها المنظرون والنقاد والفلاسفة عناية كبيرة منذ فجر التاريخ. ولا غرابة في ذلك، فقد ظل البحث في الأدب وفي مفهومه معا يهيمن على الكثير من الدراسات القديمة والحديثة، سواء عند الغربيين الذين كان لهم قصب السبق، أو عند العرب الذين تأثروا بثقافة الحضارة الغربية». ومن هنا، فالأبحاث التي تخصصت فيها أو درست معضلتها، تسعى إلى استكشاف القوالب الفنية التي تمتلك ضوابط وحدودا فاصلة، بقدر ما تعمل على تكريس قواعد انبناء الأجناس. وبنا على إرث اليونانيين القدامى (أفلاطون، أرسطو..) الذين كان لهم قصب السبق في ذلك، بل الجرأة على التفكير والتقسيم والتنظير، «تناسلت وتعددت أعمال الكثير من المنظرين، الذين كان ديدنهم هو البحث عن الفروق التي تفصل بين هذا الجنس الأدبي وذاك، مستغلين عدة أشكال من المقاربات مختلفة الأصول والأهداف».
يضم الكتاب نصوصا ومقاربات لأبرز أعلام النظرية الأدبية المعاصرة (كارل فيتور، إيف ستالوني، فرانسوا راستيي، تزفيتان تودوروف، بيير فانكلير، جان هانكيس، جان ماري سيلان، ساولو نييفا) الذين أشرعوا في العقود الأخيرة آفاقا جديدة من التأمل والبحث في هذه الأنواع، من حيث تاريخها وأصولها، ومفهومها، وأساسها النفسي، وظواهرها الجمالية والنصية.
من أجل تأويل جديد
ظلت التلاثية الأرسطية (ملحمي، درامي، غنائي) تلقي ظلالها على النقاشات والأسئلة المطروحة، غير أن هذه المقاربة أو تلك تنطلق من إشكالية خاصة بها، وتتحجج بشواهد وإحالات وأمثلة نابعة من ثقافة وأدب محددين. فعلى سبيل المثال، يناقش كارل فيتور Karl Vietor تاريخ الأنواع انطلاقا من التحول الجمالي الذي حصل داخل التجربة الألمانية في الفترة الحديثة، ولهذا يناقش نظراءه الألمان الذين عناهم الموضوع واختصوا بآرائهم أو غيروا زاوية النظرية إليه (غوته، روبير هارتل، شليغل، جورج سيمل، غ. مولر..). فالأنواع ـ في نظره- هي «إنتاجات فنية» وكان تحولها مشروط بالخصوصية الفردية والتاريخية؛ فإن بدأت تتخلى عن عناصرها الصورية منذ الرومانسية الألمانية، وبات شعر التجربة الذاتي الخالص يتنحى أكثر فأكثر عن التقليد التقسيمي المتعارف عليه، إلا أن «الشعر المعاصر يوضح في أكثر من دلالة أن الاهتمام بالمعطيات الموضوعية للأجناس يستيقظ الآن». وفي سياق هذا الاهتمام، صارت تُطرح مشاكل المنهج في تناول موضوع الأنواع وتاريخيتها، بحيث لا يكون هناك أي معيار ثابت للنوع إلا بمقدار ما تستخلصه «نظرية شمولية لمجموع كم الأعمال الفردية التي برزت خلال التاريخ»؛ أي أن النوع ليس حقيقيا إلا في الأعمال الفردية، ومن ثمة لا تقدر النظرية الجمالية أن تعثر على الجواب من تلقاء نفسها، بل من المادة التي يمنحها لها تاريخ النوع الأدبي.
وعطفا على مفهوم النوع، يعتقد إيف ستالوني Y. Stalloni أنه من الضروري تعريف معناه وتحديد حقله الإجرائي وإبراز مصاعبه، ما دام أنه عنصر أساسي في الوصف الأدبي وحافز على إثارة الأسئلة النظرية. يعود إلى استعمالات معاني المصطلح في مجالات متنوعة ارتبط بها تاريخيا (العرق، الجنس، البلدان، النحو، المعمار، السينما) ويرى أن الرغبة التقسيمية هي نفسها تستجيب للمجال الأدبي، بعد أن جرى تصنيف الأعمال والمواضيع بناء على معايير خاصة، أسلوبية كانت أو بلاغية أو موضوعاتية أو غير ذلك، ليستنتج من التعريف الذي يعطيه لمقولة النوع، ثلاث مسلمات أو أفكار مفترضة: فكرة المعيار، وفكرة العدد، وفكرة التراتبية. ويقوده البحث بخصوص النوع في مجال الأدب إلى التساؤل حول الطبيعة الخاصة لمختلف الإنتاجات الأدبية، انطلاقا من فعل القراءة والتلقي، ومن أدبية العمل نفسه. ومن هنا، يتبني التحليل «البويطيقي» للإنتاج، الذي يتأسس على الشكل ويؤكد الطابع «البنائي» للعمل الأدبي.
مثل هذا التحليل الذي يعيد النظر في النموذج اليوناني- الأرسطي، ويساجل المقترحات والنظريات التي اخترقته وعملت على تهذيبه ومعارضته كحاجة معرفية في الحقبة الحديثة، هو ما يعتمده، من زوايا منهجية أخرى متنوعة، فرانسوا راستيي F. Rastier من منظور التناص، أو تزفيتان تودوروفT. Todorov من خلال ربط الأنواع بخصائصها البنيوية، أو بيير فانكليرP. Vinclair في رؤيته إلى الأنواع باعتبارها أنماطا مختلفة من التفكير، تنتج عن أجهزة سيميائية تندمج هي الأخرى في نظام اجتماعي أوسع، أو غيرهم.
فالمسألة الأنواعية تؤكد راهنيتها، وتثبت على نحو مفارق أن المقولة التي انتقص منها الكتاب والنقاد معا، قد انبعثت كموضوع تأمل للدراسة العلمية من أجل تأويل جديد يقطع مع التقليد النظري الإشكالي، الذي كان مصدر ثلاثة آلاف سنة من «الانسدادات» على حد تعبير جان ملري شيفرJ.M. Schaeffer؛ «فلا أحد من خلفاء أرسطو اللامعين تمكن من الذهاب أبعد من مؤلف «الشعرية» كل واحد منهم حاول أن يجعل المشاكل أكثر صعوبة من سابقيه بالفعل».
كاتب مغربي