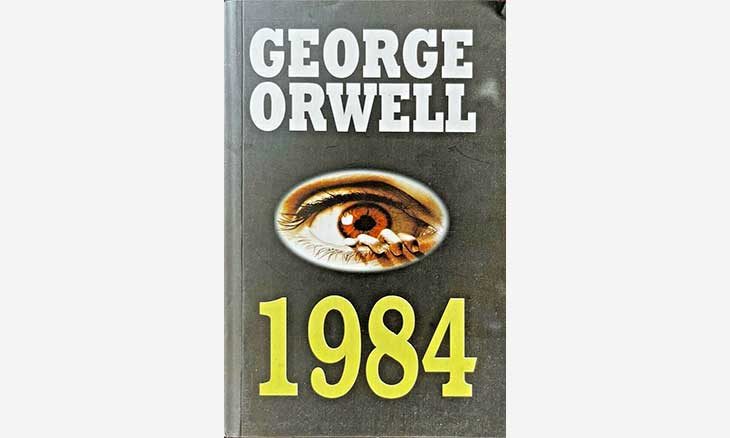
اهتم بعض النخب الغربية الأسبوع الماضي بخبر نشرته وكالة «تاس» الروسية بأن رواية جورج أورويل البائسة بعنوان: 1984، على قوائم الكتب الإلكترونية الأكثر مبيعا في روسيا. الرواية تدور حوادثها في مستقبل متخيّل حيث يحرم الحكام الاستبداديون مواطنيهم من كل الوسائل من أجل الحفاظ على استبدادهم ودعمهم للحروب التي لا معنى لها. وقالت الوكالة إن الرواية هي أشهر تنزيل روائي لعام 2022 على منصة «ليتر» بائعة الكتب الروسية على الإنترنت، وإنها ثاني أكثر الروايات شعبية في أية فئة. هذا الاهتمام منبعه حرص الغربيين على إظهار الرئيس الروسي وبطانته حكاما استبداديين دفعوا مواطنيهم للبحث عن الإنتاجات الفكرية التي تتناغم مع مشاعرهم، وأن الإقبال على الرواية المذكورة مؤشر لذلك. وهناك معان إضافية أخرى لهذا الاهتمام. فهو مؤشر كذلك لتصاعد أجواء شبيهة بأجواء الحرب الباردة التي ظهرت الرواية خلالها (في العام 1949) خصوصا بعد إقدام موسكو على الحرب في أوكرانيا، وفشل الغرب في التصدي عمليا لروسيا. ثانيها تعمق هواجس النخب الغربية إزاء ما يرونه من تراجع عام في الحريات العامة ليس في روسيا فحسب بل في الغرب نفسه، والانعكاسات المحتملة لهذه الظاهرة. ثالثها أن هناك مشاعر متوازية لدى قطاعات أخرى من النخب الغربية بأن «الديمقراطية» الغربية هي الأخرى مهددة تارة من داخلها كمنظومة وأخرى من خارجها، وبالتحديد من الأطراف السلطوية الأكثر انشدادا للحلول الأمنية والخشية المفرطة من انفلات الأمور خصوصا في ظروف التراجع الاقتصادي وهيمنة مشاعر الإحباط في الأوساط الشعبية ومنها القطاعات العمالية. ولا شك أن تصاعد موجة الإضرابات العمالية في العديد من البلدان الاوربية خصوصا بريطانيا سبب آخر لشعور الجهات الأمنية بالقلق. والمشكلة هنا مصدرها طبيعة النظام السياسي وما يمارسه من نظم اقتصادية واجتماعية. صحيح أن هناك من البشر من يتمرد على القانون ويستخدم العنف ويمارس الفساد، ولكن الغالبية القصوى من المواطنين في أغلب البلدان ليسوا كذلك، بل هم بشر أسوياء يستحقون العيش بكرامة وحقوقا مضمونة وحريات محترمة. والمشكلة تنطلق عادة من المتربّعين على كراسي الحكم، خصوصا إذا صادروا الحريات واضطهدوا المعارضين وتمرّسوا في القمع. يتم ذلك ليس بشكل أرعن كما يحدث في البلدان العربية بل ضمن أطر ما يشبه «الحرب الناعمة» التي تستهدف البشر على اختلاف انتماءاتهم.
قبل ثلاثة عقود احتفى الغرب بنهاية الشيوعية وبداية تحقق نبوءات الكتّاب بحتمية هيمنة المشروع الغربي «الديمقراطي» على العالم. ولكن ذلك الاحتفاء لم يدم طويلا، فسرعان ما استعادت روسيا المبادرة وأوقفت ما تعتقده تمددا غربيا على حدودها، وبلغ هذا القلق ذروته باشتعال الحرب في أوكرانيا. ولا شك أن الأمن الأوروبي همٌّ كبير لدى الطبقات السياسية التي تخطط لمستقبل القارة البيضاء. وبرغم توسع عضوية حلف الناتو بعد تفكك الاتحاد السوفياتي والتحاق جمهورياته السابقة بالحلف العسكري الغربي، فما يزال الأمن مصدر قلق متواصل. وجاءت الأزمات الحالية كارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار الطاقة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي لتؤكد هذا القلق الذي يتصل بحياة الناس العاديين. وقد اعتاد الغربيون على اتهام الآخرين كمصدر لمشاكلهم. وهناك تركيز على مصدرين أساسيين لهذا التهديد في نظرهم، روسيا والصين من جهة وما يسمونه «التطرف الإسلامي» من جهة أخرى. والواضح أن تعاطي الغربيين مع هذين البعدين متباين جدا. فبينما يرون نمط الحكم الذي يمارسه بوتين مصدر تهديد لأمنهم، ويشجعون معارضيه لتصعيد مواقفهم من أجل الوصول إلى ما يعتبرونه «ديمقراطية حقيقية» فإنهم يمارسون سياسة أخرى للتعاطي مع «التهديد الإسلامي». هنا لا يطرحون الديمقراطية خيارا بديلا، بل يركزون على التعاطي معه من منطلقات أمنية بحتة. وبدلا من البحث في اسباب التطرف لدى البعض ممن يحسب نفسه في الخانة الإسلامية، فانهم يحصرون تعاطيهم مع الاستبداد بلغة أخرى، ويعتبرون أن معارضته تمثل تهديدا أمنيا يؤثر على مصالحهم. وبشكل تدريجي تحوّل أغلب بلدان العرب والمسلمين إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، ويفرض على المواطنين أن يستجيبوا للأوامر والقرارات الصادرة من الأعلى خارج أطر الشورى والتمثيل الشعبي والمجالس المنتخبة. ولا يختلف الوضع في الأراضي المحتلة، فيتم الترويج للاحتلال بأنه يمثل «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» بينما يتم تجاهل الممارسات القمعية المتواصلة التي تتنافى مع مقتضيات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
تصاعد موجة الإضرابات العمالية في العديد من البلدان الأوروبية خصوصا بريطانيا سبب آخر لشعور الجهات الأمنية بالقلق
بعيدا عن الدعاية السياسية المغرضة ومقولات الديمقراطية، فإن تغوّل أجهزة الأمن في أغلب البلدان، خصوصا «الديمقراطية» منها يمثّل مشكلة حقيقية للحريات العامة وحق البشر في الاستمتاع بالحقوق المشروعة. وبرغم محاولات أجهزة الإعلام التي تعتبر جزءا من النظام الحاكم (حتى في الدول الغربية) حُصرت مضامين كتاب جورج أورويل (1984) بالدول المحكومة بأنظمة «غير ديمقراطية» كالاتحاد السوفياتي سابقا، إلا أن مضامينه أصبحت متجسدة في أغلب الأنظمة السياسية. وقد نجم عن التطور العلمي واكتشاف التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع، انحسار خصوصية المواطن. فهو مراقَب في كل شارع من قبل «الأخ الأكبر» الذي يتحدث الكتاب عن دوره في رصد حركة الأفراد. هذا «الأخ الأكبر» يتمثل اليوم بأدوات التجسس الالكترونية واختراق الهواتف الذكية واجهزة الكومبيوتر، وكذلك بكاميرات التجسس على المواطنين التي لا تخلو منها زاوية أو شارع. وحسب تقديرات شركة «كلاريون لأجهزة الأمن» لهذا العام، فإن هناك 943 ألف كاميرا في لندن، أي كاميرا واحدة لكل عشرة أشخاص. وحسب تقديرات الشركة فإن الشخص تلتقط صورته 70 مرة يوميا.
وتقول منظمة العفو الدولية إن مدينة نيويورك هي الأخرى ترصد حركة مواطنيها بشكل مستمر. ونسبت إلى جيمسون سبيفاك، الباحث في مركز القانون بجامعة جورج تاون قوله إن مشروع المنظمة «يقدم لمحة حول سعة الرصد خصوصا في المناطق المأهولة بغير البيض، وكيف أن الأماكن العامة يتم تصويرها لتساعد الشرطة على معرفة الوجوه». وما أكثر الحالات التي تستخدم فيها الأقمار الصناعية لرصد حركة الأشخاص، وربما اغتيالهم خارج القانون، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال. هذه الحقائق تؤكد أن ما يحدث الآن في دول «العالم الحر» من رصد المواطنين ومتابعتهم يتجاوز كثيرا ما ورد في كتاب جورج أورويل الذي كانت تنبؤاته محصورة بوجود ما أطلق عليه «الأخ الأكبر» الذي يطل على الناس في الشوارع ويحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم، بينما تجاوزت عمليات الرصد والتجسس على الأفراد هذه الحدود وأصبحت الأقمار الصناعية وسيلة أساسية في هذه العمليات. بل أن البعض يرى أن الفسحة المتاحة للحريات العامة مؤشر لقوة أجهزة الأمن والاستخبارات، وليس العكس، بمعنى أن «الدولة» محمية بنظام بوليسي فاعل يسمح له بالسماح بالحريات التي توفر متنفسا للمعارضين. ويشير إلى أن غياب الحريات في الدول القمعية يعود لشعور النظام بالخطر الدائم لعدم توفر أجهزة أمنية فاعلة.
هنا يصبح الحديث عن قيم «الأمن الشخصي» أو «مراعاة الخصوصية» أو «احترام الحريات العامة» مقولات لا يؤكد الواقع وجودها بشكل حقيقي. فالمواطن العادي هو المستهدف بهذا الرصد الذي تستخدم فيه أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية. ولذلك يبدو الحديث عن رغبة المواطنين الروس في الاطلاع على كتاب أورويل هامشيا إذا ما قيس بحجم مشاريع الرصد والتجسس التي كثيرا ما استخدمت للاغتيال والاعتقال وجمع المعلومات وتخزينها للاستخدام عند الحاجة. هنا يجد المواطن نفسه عرضة للابتزاز بعد أن تتراكم محتويات ملفه الأمني الذي أصبحت التكنولوجيا المستخدمة فيه أوسع مدى وأكثر تطورا وأيسر استعمالا.
في ظل هذه الحقائق تتواصل سياسات استغفال البشر ودفعهم لإظهار الحماس دفاعا عن «الديمقراطية» التي تحميها أجهزة أمن لديها قوانين خاصة وموازنات مالية عملاقة ولا تخضع لحساب أو رقابة. وهكذا يتم تقزيم المواطن ليصبح أداة في آلة عملاقة تهدف للهيمنة على البشر ومساومته على الحقوق وإشغاله بهموم الحياة العامة خصوصا في مجالات العمل والدخل الشخصي وضغوط المعيشة. فاذا كان من حاجة لتقييم كتاب جورج أورويل أو فحص مدى واقعية تنبؤاته في مجال الحقوق العامة والرصد المتواصل من قبل أجهزة الأمن، يمكن القول بأن تنبؤاته في جانبها المعنوي ضرورية ودقيقة وتتسم بشيء من الشمول، ولكن تطور التكنولوجيا الرقمية تجاوز استشرافات الكتاب كثيرا، فأصبحت الرواية محدودة الأهمية لدى استراتيجيي الغرب، لكنها لا تزال تحتفظ بأهميتها في إطار مناقشة قضايا دول الشرق في مجالات الأمن والرصد وسلطة الدولة ودور أجهزة الأمن والاستخبارات. غير أن ذلك سيبقى ناقصا إذا لم يتم النظر في المنحى التنازلي للمشروع الديمقراطي في العالم الغربي الذي يزداد جنوحا نحو الاستبداد والتجسس والرصد بدلا من مزيد من الانفتاح واحترام الفرد واعتباره نواة المجتمع المتطور في مجالات التكنولوجيا وكذلك على مستوى حريات أفراده وحقوقهم.
كاتب بحريني
الواقع ان الغرب يرفل في الديمقراطية و العلم و الثقافة .
بينما العالم العربي و الإسلامي يتخبط في الايديولوجيا و اليوتوبيا