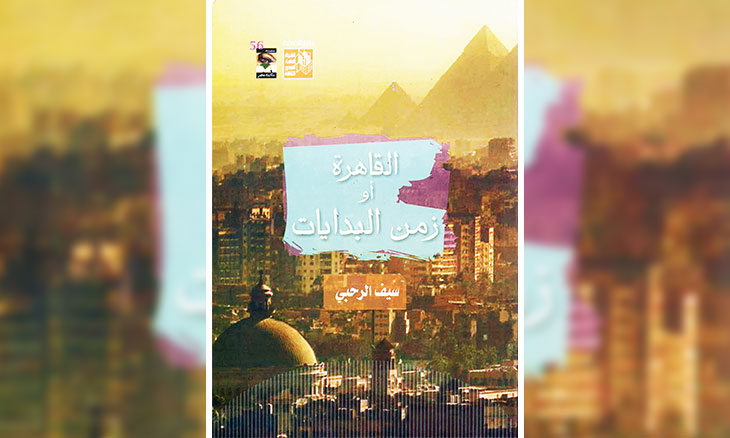
للقاهرة عاصمة المُعز، وعاصمة الغناء العربي وعاصمة التاريخ الميثولوجي، مكانة خاصة في قلوب مرتاديها وزوارها وعشاقها، من مستشرفين لآفاقها، ومستغورين لجمالياتها، ومن باحثين ورواد خيال ومبحرين في متونها وأعماقها وهوامشها. فهذه المدينة المتكئة على كتف النيل، والسارحة بين أهراماتها ودلتاها في النجوع هي أم الدنيا، كما تسمى من قبل أهليها، ومن قبل ساكنيها، ومن قبل مستشرقيها، ومنقّبيها، وطُلاّع أباطحها، من كتّاب وبحّاثة ومترحّلين أوروبيين، وعلماء بحث، وأركولوجيا، ومكتشفي تحف، ومومياءات، ورموز أسطورية، لا تنتهي فوق هذه الارض الحبلى بالكنوز، والآثار، والإحفوريات، واللقى التي لا تقدّر بثمن، فهي أرض معطاء، فيّاضة وقابلة للطرح الجمالي، والمثير، في كل يوم، حين يروم المرء البحث في مسالكها ووديانها ودلتاها وصحرائها الذهبية التي تمتد في الروح المصرية، لترسم ملامحها وبهاءها الإنساني، وخلودها فوق هذا الوجود .
كثيرون كتبوا عن مصر، من عرب وأجانب، وها هو واحد من عشاقها، وساكنيها القدامى، يسجّل بيوغرافيا شعرية، ويوميات، وتدوينات، أعادته إلى تشكل تكوينه البدئي فيها، بدءاً من أيام صباه الأولى، حيث كان يعيش في مطلع السبعينيات، أيام دراسته الأولى في مدارسها العامة. إنه الشاعر العماني سيف الرحبي، فها هوذا يأخذنا في يومياته هذه إلى أيام المراهقة الأولى، والنظرات المتبادلة الأولى، مع بنت الجيران، وإلى تلك الأحلام اليافعة، والخيالات الحالمة بالحب، والكتابة، والثورات الرومانسية التي كان يصنعها ثوار نادرون، لا نظير لهم تاريخياً، كتشي غيفارا وهوشي منه ولينين وجمال عبد الناصر وكاسترو وغسان كنفاني، وغيرهم من الثوريين الحالمين بالتغيير والثورة .
هناك سيرى الشاعر المترحّل القطار والطائرة لأول مرة، وسيرى المدينة الكبيرة المُعمّرة بالمقاهي، ودور السينما، والجسور، والحانات، وأماكن السهر الليلي.
وهناك سيخطو خطوته الأولى، باتجاه الحب العذري الأول، سيذهب مع فتاته إلى السينما والمقهى، والمتنزّهات التي تجمع الهامسين والمحبّين والعشاق الأوائل.
يتملى الرحبي في الشق الأول من مؤلفه أوجه العيش في القاهرة، أيام الدراسة، والطيش، والاندفاع المبكر إلى العالم، بغية الكشف عن خباياه، وجوّانياته، وإزاحة الحجب والأستار عنه، يتملاه بشغف النظرة الأولى، الهائمة والرومانتيكية، المستبطنة للطوايا، وما يختفي عن عين المتجوّل من مدافن فنية غير مرئية .
وما أن تنطوي حقبة الدراسة تلك، وتمضي سنوات من غربة الشاعر، في الجزائر، والمغرب، وبلغاريا وربما هولندا، ودمشق الأثيرة لديه، تلك التي لها حديث آخر لدى سيف الرحبي، فهو شاعر محب لبلاد الشام، مثل أغلب الشعراء العرب، المتولّهين، والمنغمسين بسحرها وطراوتها الحياتية، تلك الحياة الرهيفة، والحانية، والمربتة على كتف الشعراء والكتاب والفنانين العرب. ما أن تنتهي حلقات التشرّد، والبعد، والنأي في المنافي البعيدة، حتى يعود الشاعر مرة أخرى إلى القاهرة، باحثاً عن مكانه الأول، حيث الحب الأول، فالمكان لا يزال قائماً، بينما الحب قد غاب وترحّل، ومرّ مثل أي حب آخر بكوري، بدورات الحياة والزمن وتقلباته الوجودية، ليكون نسياً منسياً، مثل تلك النظرة الفتية الأولى، والشغف الطازج الأول.
سيحط الشاعر في المرة الثانية، بعد أن مرّت عقود على حياته الأولى في هذا المكان، سيحط الرحال في منطقة “المهندسين” ذاتها التي شهدتْ ذلك الحب العابر، حيث الذكرى القوية لهذا الحب، هي التي جاءت به إلى هذ المكان الأنيس، والدافئ، مسترجعاً عبر أفق شمسه، وهوائه، وشجراته التي طالت وظللت الشارع، بعضاً من تلك التهويمات التي بات الشاعر يقتات عليها، كنوع من الذكرى التي لا تزول بسهولة، لقوة ألفتها، وطعم حلاوة تلك الأيام، المتسمة بالسماح، والنشوة، والبراءة.
“هذا أول يوم لك في القاهرة، تلك المدينة التي قدمت إليها تلميذاً، كانت محطة التكوين الحياتي والمعرفي الثانية ….
تستيقظ مبكراً… تمشي وفي رأسك طنين صباحات فاتنة، وسط الشوارع والأزقة والمباني التي سفحت فيها شطراً من عمرك، وثمة ضباب يروز المدينة بأكملها، ضباب لأول مرة تشاهده بهذه الكثافة، كأنما هو رسائل عيد ميلاد رأس السنة، ربما من مدينة هيليوبولس الفرعونية كما سماها الإغريق، أقدم مدينة على وجه الأرض”.
يسرد الرحبي في يومياته، وهي يوميات خفيفة، لا ثقل فكرياً وفلسفياً فيها، بل هي عفوية مثل عفوية أشعاره، غير محملة بغنوصيات وهرمسيات وتداعيات كتيمة، بل هي إشارات يومية روحية لما تهجس به الأعماق، وهي أيضاً صورة مرئية، من الهواجس، والتمتمات الداخلية للنفس، تشير بوضوح إلى أماكن بعينها ومقاهٍ نعرفها، وشوارع قد سلكناها وحانات قد ارتدناها، ولكن لسيف خصوصيته فيها، فهو خير عارف لأسرارها، وحكاياتها، وخير سادن في محرابها، منذ يفاعه وهو يدرج في هذه الطرقات، من أحياء “الدقي” و”المهندسين” و”ميدان التحرير” وساحة “طلعة حرب” حيث مقهى “ريش” و”غروبي” المغلق الآن لدواع غير معروفة، وهو المرتاد لسينماتها، ومسارحها، ومساءاتها البليلة برذاذ النيل، وشواطئه الجميلة، ذات الأشرعة، وقوارب الصيادين، والمعديّات العابرة، بين الجهتين من النيل، والضواحي المتاخمة للشاطئ الغافي على أغاني السيدة أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ورومانسيات عبد الحليم حافظ، ومغامراته في الأفلام المفعمة بالفتنة .
كذلك لا ينسى الرحبي الأهرامات الخالدة، و”فندق مينا هاوس” التاريخي و”الجيزة” العملاقة، وطرقات حي “العجوزة” و”شارع نوال” الذي يتساءل وهو يعبر الطريق في العجوزة باتجاه هذا الشارع عمن سماه وأعطاه هذه التسمية الخالدة.
تخترق كتاب “القاهرة أو زمن البدايات” رسائل ومراجعات أدبية، ذات نفحة تذكارية عن الكتاب الذين سكنوا القاهرة، وتعلقوا بها، مثل الروائي الأردني البارز غالب هلسا، وثمة حديث عن الشاعرين المصريين حلمي سالم وأمل دنقل الذي أرخ بأشعاره البليغة، والمُعبّرة، والصادقة، والعميقة، روح اللحظة المصرية؟
يضم الكتاب كذلك، كما هي عادة الرحبي في الكتابة، نصوصاً شعرية تتناغم وتتسق مع جمال الأوقات التي قضّاها في مصر، جائلاً بين ساحاتها، وأسواقها، وشوارعها الأليفة تلك التي تسكع فيها طويلاً ليل نهار:
” نمرّ على صفّ من محلات الجزارين، وقد علقت الذبائح من عراقيبها، وتدلت الأحشاء والرؤوس، بالأمس كانت ترعى في أريافها الحالمة، لكن إذ كانت عادة الغذاء البشري المتوارثة في هذا المشهد القاسي، فثمة شعوب معلقة هكذا من عراقيبها بدافع الوحشية والافتراس ورغبة الإبادة، فضائل العقل الحضاري وغير الحضاري المعاصرة” .
كتاب سيف الرحبي الجديد، يحتفي بالحياة حيثما وجدت وكانت، فهو أدب رحلة ومزيج من حقول أدبية وفنية أخرى، كالشعر الذي يأتي به سنداً، ودالة، وبرهاناً، كي يؤازر الكتاب ويوضح المسار والمقصد، كقوله في أحد النصوص الشعرية المُعَنْوَن بـ ” القاهرة أو نجمة البدو الرحل “:
نحن الذين وُجدنا فيكِ صغاراً
وكبرنا بعيداً عن رعاية الأبدية،
نحن الذين تسلقنا حواريكِ
باحثين بين مقابرك الألف،
عن فجر هربَ من بين أصابعنا واختفى “
كتب الرحبي كتباً عديدة على هذه الشاكلة تجمع النثر والشعر، ذلك أن هذا التنوع الجمالي، سيجعل القارئ يختار ما يشتهي من مائدة الكتاب، ينتقي ويلوذ بما يقدمه من ذكريات لم تزل طرية، لاسيما بحديثه عن الشاعر المصري الراحل حلمي سالم، القريب من الروح والقلب والشعر، يتذكر أيام اللقاءات الأولى، العابقة بالأدب، والفن، والشعر، والرسم، والحلم الثوري، مع رموزه الكبار في تلك الحقبة، من سنوات الستينيات والسبعينيات، حقبة مفعمة بالأفكار، والجدل المعرفي، والنقد النظري، حيث المنافسة كانت محتدمة، بين الأجيال، والمبدعين، وحتى لو كانت منبثقة من دائرة جيل معين، كما حدث مع جيل السبعينيات مثلاً، فالمنافسة الجمالية كانت قائمة وجارية وماضية إلى ابتكار الأساليب والأشكال الفنية الأجد، والمفاهيم الكتابية الأكثر حداثة، تلك التي كانوا يرونها تتواءم، وتنسجم مع آدابهم وأفكارهم المختلفة والمفارقة للسابقين، الميّالة في آنٍ إلى التحديث، والتجديد والمُعاصرة.
سيف الرحبي: “القاهرة أو زمن البدايات”
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2019
174 صفحة.