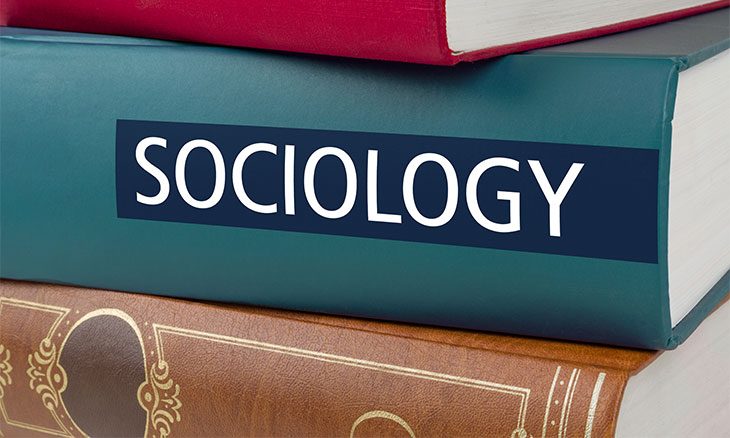
التاريخ والزمن لا يتوقفان عند لحظة معينة، غير أن مجرى أحداث الأول لا تسير دوما بخط مستقيم، وهنا يجب التفريق بالضرورة في فهم العلاقة المجتمعية وجدليتها الدائمة والمتحركة، التي لا تعرف السكون أو الصمت، التفريق بين السيرورة والصيرورة ضروري للموضوع المطروح.
الأولى تعني التقدم والتراكم، ويمكن أن يستعاض عنها بكلمة مسار، التي تعني التقدم إلى الأمام بشكل متتالٍ، لكن هذا لا يتضمن تحولاً نوعيا، بل يتضمن حالة استاتيكية (ثابتة أو آلية) تقوم على مسار باتجاه معين، بدون أن يحمل في أحشائه المجتمعية أي تحوّلات نوعية مهمة للناس. بينما تعني كلمة صيرورة التقدم والتحول معاً، وهو ما يطابق الديالكتيك الفلسفي المادي، حيث أنها تقدّم وتغيّر. لذلك فهي تراكم كمي، وتغير نوعي في آن معا، إنها أبسط قواعد علم الاجتماع الذي لا تستغني عنه أمة أو شعب، إن لم يقوما بمراجعة المتغيرات فيه بين وقت وآخر.
في التفاعلات المجتمعية، سواء على مستوى الدولة الواحدة، أو على مستوى الأمة، هناك الخاص والعام، وفي الأحداث الكبرى التي غالبا ما تجري وتتشابه حدوثا في عدة بلدان عربية معا (كأحداث الربيع العربي عام 2011) يصبح العام هو السائد. نقولها بمنتهى الصراحة والوضوح تنقصنا كعرب، أمة وشعوبا، دراسة المجتمعات العربية فرادى ومجتمعة من زاوية عام الاجتماع (السوسيولوجي)، الذي يدرس المجتمعات والقوانين، التي تحكم تطوره وتغيره، وتعيد أصوله المرجعية إلى عصوره القديمة.
في اليونان حاول ديمقريطس وأرسطو وأفلاطون ولوكريتيوس، تفسير أسباب التغيرات الاجتماعية، والقوى التي تحرك حياة الناس، وأصل الدولة والقانون والسياسة، ونجد في كتابات ابن خلدون وتوما الإكويني ومكيافيللي ومونتيني واسبينوزا وهيوم وجون لوك وجان جاك روسو وهيغل، عناصر مهمة في دراسة المجتمع، ولهذا سار التطور في هذه الدول في مسار مستقيم. كلمة سوسيولوجي كلمة استخدمها أوغست كونت، وإن كان الأخير استبدل علم الاجتماع باسم السوسيولوجيا. هنالك علماء اجتماع يعتبرونه مرتبطا جداً بالفلسفة التي تحدد اتجاهه وطرق بحثه واستنتاجاته، إلا أن علم الاجتماع يتجه في هذا الوقت للدراسات الميدانية والتجريبية، ولم يعد مقتصراً على تأملاته الفلسفية.
في معظم جامعات العالم فإن علم الاجتماع يدرّس كمادة علمية مستقلة، لها كلياتها الخاصة. والحقيقة فإن العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم تدبير المنزل وعلم القانون، إنما ترجع في اصولها إلى الفلسفة الأرسطية، ثمَّ ما زاد عليه الفلاسفة الإسلاميون كالفارابي وابن سينا وابن رشد، وغيرهم، أشياء كثيرة، فمن أراد معرفة هذه العلوم تأصيلًا وتفريعاً، ثمَّ الإبداع العلمي فيها، فلا بُدَّ له من: معرفة النظريات الإنسانية وربطها بأصولها الفلسفية، وما بناه المعاصرون على هذه الفلسفة، أن المجتمع هو عبارة عن أفراد وأسر (بتعبير أفضل) تخضع لتغيير مستمر لا يتوقف. متطلبات الفرد في المجتمع كثيرة وتلبية حاجات تؤدي إلى بروز حاجات أخرى جديدة على المستوى الصحي والمنزلي والمعرفي والثقافي، ما يؤدي إلى الحاجة الملحة من قبل علماء الاجتماع لتطوير مفاهيم هذا العلم، حسب متطلبات الحاجة. علم الاجتماع أصبح من العلوم التي تدخل في كثير من المجالات العلمية والصحية والثقافية، لكونه يبحث عملية سير المجتمع نحو هدفه، وهو بذلك يحاول جعل المجتمع يمشي في المسار الصحيح وفقا لقوانينه ومتبنياته المأخوذة من تجارب المجتمعات السابقة.
تنقصنا دراسة المجتمعات العربية فرادى ومجتمعة من زاوية عام الاجتماع الذي يدرس المجتمعات والقوانين، التي تحكم تطوره وتغيره
منذ أحداث الربيع العربي فإن التفاعلات المجتمعية العربية الفردية في الدول، أو على مستوى الأمة تميل نحو التراجع والانحسار، في مواجهة قضايا كثيرة كالتنمية والتطبيق الديمقراطي والقمع والخطط التنموية وازدياد البطالة والصراعات الطائفية والمذهبية، وأحيانا التناحرية الداخلية والبينية، التي تؤدي إلى التفسخ الوطني الديموغرافي والجغرافي. لكن يبقى أهم أوجه التقصير، هو التقصير الذاتي تجاه الوطن الأم في التحديات والمؤامرات الخارجية، التي لا تستهدف تقسيمه جغرافيا فحسب، بل تقسيمه طائفيا ومذهبيا وإثنيا، لتفتيته ونهب ثرواته لصالح عدو العرب الأول وهو الكيان الصهيوني وأتباعه. هناك خذلان وطني قومي عربي للآخرين من العرب كالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، التي يحاولون تصفيتها تماما واحتلال أجزاء جديدة من الأرض العربية، تارة لأهميتها الأمنية لإسرائيل كهضبة الجولان العربية السورية، والليطاني لأهمية مياهه للكيان، وتارة لأراضي في سيناء لترانسفير الفلسطينيين إليها وإسكانهم فيها عوضا عن أرضهم ووطنهم. كذلك التحديات في العراق ولبنان، واليمن وليبيا والجزائر وغيرها، بصراحة إننا نرى خذلان العربي لأخيه العربي بكل وضوح.
عندما نكتب عن الخذلان العربي نتساءل: هل قرأنا الماضي بأحداثه المخضبة بالخُذلان؟ ننقل عن أرشيف المخابرات البريطانية، ومذكرات ثيودور هرتزل المؤسس الحقيقي لدولة الكيان الصهيوني، في أواخر القرن التاسع عشر، في عهد السُلطان عباس حلمي الثاني: ارتحل عدد من اليهود الأوروبيين إلى مصر، حيث أسسوا عام 1897 جمعية «باركوخيا الصهيونية» التي تولت نشر الفكر الصهيوني، الذي بدأ مع قيام مؤتمر بازل بسويسرا، في عام إنشاء الجمعية بمصر نفسه، وتناول لأول مرة إنشاء وطن قومي لليهود، لتكون مصر هي نقطة انطلاقة المشروع الذي تحوّل لدولة إسرائيل في ما بعد. وقتها لم يكن أحد يعلمُ الوجهة الحقيقية للرغبات الصهيونية. وفي عام 1904 وصل هرتزل الأب الروحي للصهيونية، إلى مصر باستقبال رسمي من الحكومة المصرية، حاملًا مشروعه الطموح بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، أو تجمع مؤقت في سيناء، لينجح بعدها في تأسيس جمعية «ابن صهيون» التي أنشئت في الإسكندرية، وأعلنت تبنيها لبرنامج المؤتمر الصهيوني، الذي عقد في مدينة بازل. وفي عام 1918 وصل إلى مصر حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، واستُقبل بحفاوة رسمية امتدت لتشمل شيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي، الذي لم يكتفِ بالمشاركة في الاستقبال الرسمي، الذي عُزفت فيه الموسيقى اليهودية، بل تبرع أيضًا للمنظمة الصهيونية بمبلغ 100 جنيه مصري، وكانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطاني، الذي أصدر وعد بلفور، متعهدًا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917.
في كتابه «المفاوضات السريّة بين العرب وإسرائيل» يقول المرحوم محمد حسنين هيكل: «زادت أعداد اليهود في مصر مع بداية الاحتلال البريطاني من بضعة آلاف إلى أكثر من 38 ألفًا عام 1907، وطبقًا لإحصاء عام 1927، فإن الرقم تضاعف حتى تجاوز 63 ألفًا». ويضيف هيكل في سطورٍ أخرى: «قررت السلطات البريطانية تسهيل دخول اليهود إلى مصر، لكنّها أرادت أن يكون ذلك بإقناع السُلطان حسين كامل ورئيس وزرائه، وبالفعل وافقوا وأصدروا الأوامر بفتح معسكرات استقبال لهم في الاسكندرية شمال مصر». وبحسب الوثائق البريطانية، فإنّ رئيس الطائفة اليهودية في مصر كان قد طلب من وزير الدفاع البريطاني السماح بتشكيل كتائب يهودية، ضمن جيش الجنرال اللنبي، الذي كان يستعد للزحف على جيش الدولة العثمانية في فلسطين والشام، وسمح أيضًا للجنود بوضع نجمة داود على مقدمة قبعاتهم.
يرى البعض من المهتمين العرب والأجانب (ساري حنفي والفرنسي أرفانيتس) أن نشوء علم الاجتماع في المنطقة العربية، تزامن مع بدء المشروع الاستعماري الكولونيالي الأوروبي، ولذلك برز اتجاهان، الأول الرفض التام للاستعمار وتبعاته. والثاني آثر الاستفادة من بعض ميزاته. ركّز الاتجاه الأول على أقوال ابن خلدون وحديثه عن «الخصوصية» العربية وتمايزها، ونظريته في بناء الدولة.. وتحت تأثير فرانز فانون والاتجاه اليساري المستوحى من فكرة ما بدأت تسميته بـ»العالم الثالث»، انشغل كثير من الاجتماعيين آنذاك (أنور عبد الملك، وعبد الكريم الخطابي وغيرهما) ببراديغم (نموذج فكري) هوية العلوم الاجتماعية إلى أن أضناهم البحث أحيانا، ولذلك لم يكونوا قادرين على إنتاج بحوث تساهم في إحداث شرخ بينها وبين العلوم الاستعمارية. في حين انشغل أنصار الاتجاه الثاني، وهم الحداثيون بتحديث المشروع الوطني، واعتمدوا غالبا نموذجا حداثيا، ونظر لعلم الاجتماع بوصف مهمته الأساسية تكمن في كيفية خدمة الدولة، أو الأمة، أو المشروع الحديث الذي تنفذه الدولة..
دوبريه في كتابه «ثورة في الثورة» خاض تجربة ثورية غنية، خاض النضال في فنزويلا وبوليفيا واعتقل وسجن. وفي الثمانين من عمره يقول: إن إحدى المفارقات أن الثورة تؤدي إلى إبطاء السير، بعد تسارع في البداية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى منظومة مكابح ثقيلة.. غيّرت وجه العالم. هنا تقبع محركات التاريخ الحقيقية الضامنة الوحيدة لتقدم لا رجعة فيه إلى الوراء.
كاتب فلسطيني
شكراً جزيلاً أخي فايز رشيد على هذه معلومات, ينقصني منها الكثير.
هل العرب اليوم هم نفسهم الذين انزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم فيهم وبلغتهم الذين كانت نصرة المظلوم فيهم احدى اهم الصفات فيهم وهم الذين استمرت فيهم هده الصفة الى القرن العشرين والتى قال الشاعر حافظ ابراهيم فيها
اذا ألمت بوادي النيل نازلة. باتت لها راسيت الشام تضطرب
الخذلان ليس من صفات العرب ، وانما غياب الحرية والعدل واستبداد الحكام عن بلاد العرب جعلت الانسان العربي مغطى بقشرة صلبة من خيبة الأمل والضياع والحيرة، وتجاهل صيحة المظلوم
ولكن هذه الصفات دخيلة ، وستزول ان شاء الله ” ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما با نفسهم”