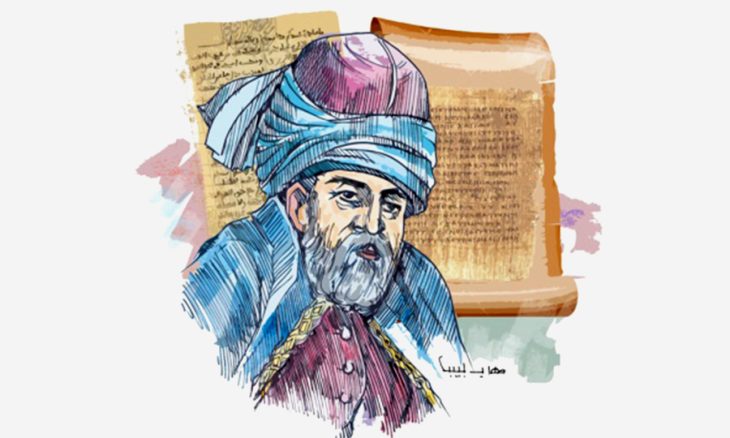
ولِد عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني في بلدة «جرجان» وهي إحدى المدن المشهورة، والواقعة بين طبرستان وخراسان، وإليها جاء نسبه، وقد كان فقيها أشعريا شافعيا ومتكلما أيضا، وتعلّم على يد أبي الحسين بن محمد بن الحسن الفارسي، وهو ابن أخت أبي علي الفارسي اللغوي المعروف، وعُدّ أبو الحسن بين العلماء إماما للنحاة بعد أبي علي الفارسي، وقد عكف عبد القاهر الجرجاني على دروس أبي الحسين الذي نزل في بلدته، ما جعله بارعا في علم النحو، ومن ثمّ ألّف كتابه النحوي «العوامل المئة» وإن كانت شهرته جاءت من خلال مؤلفاته البلاغية وأشهرها «دلائل الإعجاز» و»أسرار البلاغة» وتوفي عام 471 هـ وقيل عام 474هـ.
تميز عبد القاهر الجرجاني بامتلاكه منهجية واضحة في فكره البلاغي التي بلورها في نظرية النظم التي اشْتهر بها، وصاغها في كتابه دلائل الإعجاز نظريا وتطبيقيا، والتي يمكن قراءتها من مداخل عديدة، لكن لا بد من القول، إن أي نظرية نصية، تتوخى اكتمال الطرح والرؤية ودراسة بنية النص ودلالاته، لا بد من أن يكون السياق Contextجزءا أساسيا في تكوّنها، سواء تم التعبير عنه بشكل تنظيري مباشر، أو عبر ثنايا شرحها في أمثلتها وشواهدها وتطبيقاتها؛ فلا يمكن تحليل النص الأدبي عبر بنائه اللغوي فقط، لأن المعنى لا يفهم عن طريق اللغة وحدها، فلا بد من دراسة السياقات المختلفة التي يمكن أن ترتبط بما هو خارج النص، أو في النص نفسه، وأوجه المعطيات الدلالية المتعددة المتولّدة عن التأمل السياقي.
في ضوء هذا، نحاول قراءة جهود عبد القاهر ورؤاه في التنظير البلاغي وتطبيقاته من منظور «السياق» وكيف كان وعيه حاضرا لهذا البعد، الذي هو سمة أساسية في فكر عالم بلاغيٍّ، تعامل مع الشواهد النصية من منظور كلّي، فلم تشغله الجزئيات، ولم تأخذه المصطلحات عن الغوص في سياق الشواهد، ليقتنص ما يمكن اقتناصه على مستوى اللفظة والتركيب والعبارة والفقرة، وهو ما ساهم في تشكّل نظريته، وتدعيمها بأمثلة جعلتها قوية الحجة، ناصعة الرؤية.
وهو ما انعكس في جهود الجرجاني الملموسة في علمي المعاني والبيان البلاغيين، عبر ما سطّره في نظريته العميقة عن النظم القرآني، فقد انطلق من دراسته للجزئيات والمتناثرات والمفاهيم البلاغية مستفيدا من تبحّره في علم النحو، ليصل إلى نظريته الكلية، والتي يمكن البناء عليها وتطويرها لتكون نظرية كبرى في دراسة النص، خاصة أنها نابعة من صميم الثقافة العربية الإسلامية، باستنادها إلى النظم القرآني فهما وبناء وتطبيقا، وذات تأصيل نظري مسبق في علم الكلام، لذا يمكن القول إن الجرجاني في نظريته يمثّل الرؤية الكلية التي يستنبطها العالِم من التأمل الطويل والبحث الدائب في الأمثلة والشواهد، وعلى حد قول الشيخ رشيد رضا في تقديمه لكتاب «أسرار البلاغة» حيث يقول إن «العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك، كما تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة، فإن كان المعنى المنتزع من الجزئيات قانونا كليا يرشد إليها، فهو القاعدة، وإن كان صورة تناسبا وتقربها من الفهم فهو المثل. (ذلك أن) القاعدة الكلية هي صورة إجمالية للمعلومات الجزئية، والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها».
تميز عبد القاهر الجرجاني بامتلاكه منهجية واضحة في فكره البلاغي التي بلورها في نظرية النظم التي اشْتهر بها، وصاغها في كتابه دلائل الإعجاز نظريا وتطبيقيا، والتي يمكن قراءتها من مداخل عديدة.
وهذا سبب تميز الجرجاني، حيث وُفِّقَ في إبداع نظريته مستندا إلى موسوعيته: لغويا وبلاغيا وفقها وتفسيرا ونظريات كلامية، فمصطلح النظم نفسه كان شائعا في بيئة الأشاعرة، إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه، وأن الجاحظ أول من وضع هذا الاصطلاح، وعلل به أوجه الإعجاز، وشاركهم القاضي عبد الجبار في الرأي، مؤكدا أن الأسلوب والأداء والصياغة النحوية للتعبير هي سبب الإعجاز وليس الفصاحة (حسن اللفظ والمعنى) على نحو ما ذكر المعتزلة، وهو رأي ذكره محمد عابد الجابري في كتابه «بنية العقل العربي» (بيروت 1986). ويضيف الجابري أيضا أنه من المعلوم أن المتكلمين اختلفوا في بيان أوجه الإعجاز في القرآن، فهناك من رأوه معجزا بذاته، بمعنى أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان بمثله، وآخرون رأوه معجزا بتدخل الإرادة الإلهية التي منعت العرب وصرفتهم عن الإتيان بشيء مثله، ويعرف هذا الرأي بالقول بالصرفة».
ويُعَدُّ القاضي عبد الجبار مؤصِّلا لنظرية النظم، حيث قال في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر في إفراد لكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمّ» ويكاد يكون مفهوم الضم مساويا في الدلالة للنظم، إن لم يكونا في حقل دلالي واحد، يعني أن العبرة بالصياغة اللفظية المكتملة، والتي يسبقها قصد المتكلم (على طريقة مخصوصة).
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فمن الملاحظ أن هناك تداخلا في بحوث الجرجاني في كتابيه؛ لعلوم البلاغة، البيان والبديع والمعاني في ثنايا مباحثه، دون تفرقة واضحة بين مباحث المعاني والبيان، على نحو ما يقول في «دلائل الإعجاز»: «إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البيان، الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشى، ويصوغ الحلي.. والذي لولا تحفّيه بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة».
ويعود التداخل إلى كون علوم البلاغة (البيان، البديع، المعاني) غير مكتملة بعد في زمنه، على نحو ما تم بعد ذلك في مرحلة متأخرة على يد السكّاكي (ت626هـ) والخطيب القزويني (ت 739هـ) ومن تبعهما، باستقلال علمي البيان والبديع عن المعاني، مع مزيد من التحديد في المصطلحات والمفاهيم.
أيضا، فإن مصطلح «البيان» في الحقبة السابقة لعبد القاهر وحتى عصره كان اسما جامعا ليس فقط لكل ما به تتحقق عملية الإفهام أو التبليغ، بل أيضا لكل ما به تتم عملية الفهم والتلقي، أو ما يمكن تسميته بــ»التبيّن». مما يرسّخ في وعينا المنطلقات الثقافية العربية والإسلامية لنظرية عبد القاهر، وأنه لم يكن معنيا بالتقعيد والتنظير مثلما فعل البلاغيون اللاحقون عليه، وإنما كان مهتما بتحويل طروحات المتكلمين السابقين إلى تطبيق ناصع البرهان على الشواهد من الآيات والأشعار.
كاتب مصري