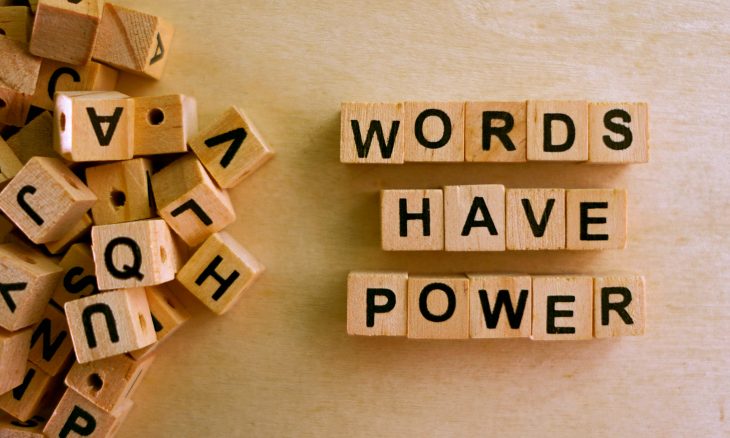
عندما خلق الرب آدم من أديم الأرض وأنزله في حديقة شرق عدن، اكتشف آدم علاقته الأولى مع الأسماء، كان العالم غير موجود بالنسبة له إلى أن علّمه الرب الأسماء، وجرب آدم اللفظة الأولى، اكتشاف آدم لعالمنا هذا لم يبدأ مع رؤية الأشياء، فرؤيتها لا يعني اكتشافها بل بدأ مع تسميتها، أسماء تعلمها وأسماء اخترعها هو لنكتشف مدى انسجامه مع هذا العالم، كانت ماهية العالم الأولى قائمة على الكلمات، ما تسميه تراه، أما الأشياء التي لا تسميها فهي غير موجودة إلا أن تسمى.
ووصلت لنا هذه الأسماء عبر طبقات من التجارب، أسماء تنوب عن أسماء أخرى، وأسماء تعطي العالم تماسكاً مفهوماً نحدد من خلاله قدرتنا على إدراك العالم، فاللغة والتسمية هي التي تحدد هذا العالم وتعطيه شكلاً مفهوماً، فمثلاً اللون الأزرق لم يذكر أبداً في أغلب الحضارات القديمة، ولا حتى في أغلب الوثائق التاريخية، يتحدث وليم غلادستون في بحثه في ملحمة هوميروس، التي تعتبر من أهم ملاحم الإغريق عن غياب اللون الأزرق، مع أن سماءنا زرقاء، كوكبنا اسمه الكوكب الأزرق، وهذا لا يعني عجزهم عن رؤية اللون الأزرق، بل يعني عجزهم عن تسميته لأنه كان موجوداً بينهم، ولكن إدراكهم لا يميز بين الأزرق والأخضر، فامتلك الاثنان الاسم ذاته، وتجاربنا هي التي أعطت للأزرق اسمه، فلولا الاسم لما وجد الأزرق، رغم رؤيتنا لهُ، ومن الطبيعي الآن أنهُ في السماء وفي وجوه الآخرين، وفي مشاعرنا اليومية هناك أشياء غير مسماة رغم وجودها، لربما الحزن هو اجتماع أكثر من شعور غير مسمى يحتاج إلى تسمية ليُفهم أكثر ونستطيع التعبير عنهُ ليدركه العالم بشكل أدق.
عصرنا هو عصر التوغل عميقاً والحفر المضني للوصول للكلمات المناسبة وقراءتها، لأن التسميات التي يطلقها العالم اليوم مشوشة، تزيد من الفوضى، وتقود المشاعر بطريقة مدروسة نحو المزيد من التقسيم والكراهية.
تخبرنا الكلمات ما نحن عليه، وقراءة أنفسنا تعتمد على قدرتنا على فهم ماهية العالم، فلا تكفي التسمية بقدر ما تحدد قراءة هذه التسمية أهميتها، فالعالم اليوم لا يتعامل مع الكلمات كونها أداة للاكتشاف، بل كسلاح لتكريس الفوضى، فإذا أردت قتل شيء في هذا العالم اجعله بلا اسم، أو اختلف حول تسميته، أو سمّه كما تشاء، تقصف اليوم الطائرات مظاهرات الناس، ويسمى ذلك «محاربة الإرهاب»، تعتقل اليوم الحكومة مُصلحاً أو تنويرياً، وتسمي ذلك «القضاء على الفساد»، هذا كله كمثال بسيط جداً، اعتماد الفوضى ينطلق في البداية من اعتماد التسمية، فمن هو ثائر في اليمن مثلاً يعتبر مخرباً في العراق، وترابط أفكارنا وسط هذه الفوضى، يبدأ من إدراك الأسماء الحقيقة للأشياء، ولا نسعى من خلال ذلك إلى محاربة الفوضى، فهي منتشرة ومخيفة، بل السعي الدائم يكمن في جوهر رؤيتها، اكتشاف وجودها المنتشر عبر الشاشات والجرائد والمقاهي، فوضى من تسميات تطلي الكلمات والأحداث بأسماء مخيفة لتقيد إدراك الناس بتعابير محددة تبقيهم على السطح غير قادرين على اكتشاف مشاعرهم الأولى، التي يمكن من خلالها تحديد فهمهم للعالم، مقيدين بكلمات محددة تجعلهم خاضعين لشعور الخوف والخيبة وعدم الأمان، لأن التسمية الصحيحة هي الوحيدة التي تجعل العالم منطقياً ومتماسكاً.
في رواية «مئة عام من العزلة» لغابرييل غارسيا ماركيز، عندما ابتلي سكان «ماكوندو» بما يشبه النسيان الذي انتهى بفقدان تام للذاكرة، غابت عنهم الأسماء، وبسرعة واضحة فقدوا قدرتهم على معرفة العالم وفهمه، ركز الكاتب على مشاعر سكان «ماكوندو»، كان غياب اليقين يسيطر عليهم فلا شيء ثابت في عالمهم ولا يستطيعون تحديد الواقع من الخيال، فتراهم غارقين في الشك، تختلط مشاعرهم بين الخيبة والأمل، عشوائية مخيفة تقود المجتمع، وغياب الخيط الفاصل بين اليقين والسراب.
عصرنا هو عصر التوغل عميقاً والحفر المضني للوصول للكلمات المناسبة وقراءتها، لأن التسميات التي يطلقها العالم اليوم مشوشة، تزيد من الفوضى، وتقود المشاعر بطريقة مدروسة نحو المزيد من التقسيم والكراهية. تغطي الكلمات كلمات أخرى وتغرق التسميات الصحيحة أو تقتل، فلا أحد يستطيع فهم ما لا يمكنه التلفظ به ولا يستطيع مشاركته، ولكن مع ذلك مهمة التسمية هي مهمة كل قارئ، والقارئ هنا لا تعني المثقف، بل تعني الشخص الذي لا يتقـــبل التلقي المحض الذي يفرض عليه، بل يعيد قراءته ليغير الأشياء بتغيير اسمها.
٭ كاتب فلسطيني