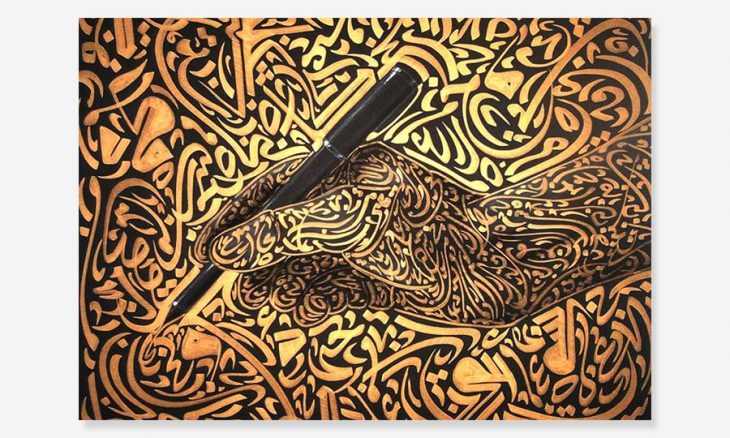
وضع الشعر
طوال العقدين الأخيرين ظلت تتعالى نبرة دعاوى القائلين بأن الشعر خفت صوته وانحسر دوره، أو أنه يمر بأزمة حقيقية تهدد وجوده، أو أنه لم يعد يستأثر بأولوية عند ذائقة المعاصرين، بفعل بروز فنون أخرى أكثر جاذبية وتمثيلا لحركة المجتمع وحاجياته النفسية والمادية، أو أنه يمثل ارتدادا عما تحقق للقصيدة العربية في عصرها الذهبي الحديث. أعتقد أنه من الطبيعي أن نسمع هذا وذاك؛ لأن العصر الذي نعيشه بكل اشتراطاته السياسية والسوسيوثقافية، باتت تحمل إلينا تحولات خطيرة تمس في الصميم جوهر علاقة الإنسان المعاصر بما حوله، وجوهر علاقته بنفسه وموقفه ورؤيته للعالم وكائناته من كل لون ورائحة. وإذا أدركنا أن الشعر بين بقية الفنون ينطوي في داخله على مثل هذا الجوهر وحساسيته التعبيرية كفلسفة وممارسة وشكل رؤية، فإنه يمكن أن نضع تلك الدعاوى في سياقها الافتراضي، لأنها لا تعكس أيديولوجيا مضادة للشعر الحديث، بقدر ما تحرص على أن يكون للشعر دور ووظيفة في عالمنا المعاصر، مثلما كان له ذلك في سالف الأزمنة. الوضع الراهن الذي يحياه الشعر مغاير، وجارف ومتنبئ بالنذر والأراجيف، لهذا، لا يصح أن نتناول تعبيرات الشعر المعاصر بمعزل عن هذا الوضع بتحولاته وانفجاراته وهجراته وإحباطاته وموجات الخوف واليأس والشك والعدمية، التي يشيعها في نفوس بني آدم وشعرائهم، وربما زادت في ذلك ما شهدتها حركة الشعر الحر التي خرجت من حرب عالمية مدمرة؛ وما واجهته من خطاب «سلفي» يُشنع عليها بالازدراء والتشهير. فالاقتراب من شعرنا المعاصر يلزم تغيير زاوية النظر وأدوات تحليل الخطاب على نحو ما يكشف لنا مدى الإضافات النوعية التي تخلقت في رحم التجربة الشعرية الجديدة التي عانقت ـ بمنأى عن تقييم أخلاقي تفاضلي- أفقا جديدا لا عهد للشعرية العربية به، بقدر ما أنها انفضت عن مقولات «الجيل» و»ثنائية الشكل والمضمون» و»ما يطلبه الجمهور» وغيرها من المقولات المتحجرة التي تعمى عما يجرى للشعر وفي نهر الشعر من إبدالات جديدة انعكست على طبيعة لونه ورائحته ومدى عمقه.
تواصل أم انقطاع؟
من خلال ما أتيح لي الاطلاع عليه من مجمل التجارب الجديدة في البلاد العربية، بما في ذلك الهوامش، التي حلت محل المراكز التقليدية، في تونس والمغرب والبحرين والسعودية والسودان وغيرها، أستطيع أن أقول إن شعرنا المعاصر يعرف دورة جمالية جديدة تضطلع بها ـ كما سميته في أكثر من مناسبة – (حساسياتٌ جديدةٌ) يقودها وعي شاب منشق وغاضب ويائس، ومندفع إلى قول ما لا يُقال؛ بما اختطتْهُ هذه الحساسيات من أشكال وأطر فنية، أو أحدثته من لغات وأساليب ورؤى واختراقات جمالية مغايرة تتناسب مع شرط الكتابة المفتوحة، وتستفيد من حوامل الميديا ولا تقع في أسرها، مثلما أنها لا تعدم في برنامجها الاهتمام بشرائح جديدة من المتلقين، حتى لا أقول الجمهور .
وفي المقابل، ليس مقبولا الادعاء بأن ما يقع ضمن هذه التجارب كله «سمن على عسل» بل هناك نماذج كثيرة تُحسب في سربها إلى درجة أن تحجبها، لا تضيف شيئا وتمثل عبئا ووبالا عليها، كما في غيرها من التجارب التي تعرف مرحلة انتقالية، ولاسيما في ظل ازدياد الطلب على اقتراف الشعر في بلدان عربية كثيرة، بما فيها لبنان: يقول شربل داغر: «يعيش الشعر اللبناني بين شعرائه، وفي مباني القصيدة نفسها، ما لا يشبه أو يوازي فقرَ البنية المادية والتحتية للشعر. فأعداد الشعراء تتزايد، بل توقف عد «أجيال» الشعراء ـ لكثرتهم وتدافعهم – بعد «جيل السبعينات»؛ ولا يتورع أكثر من ثلاثين شاعرا شابا عن نشر مجموعته الأولى، متكفلا بكلفتها المادية. بات المشهد متفرقا، فيما يتابع شعراء عديدون، بالتفعيلة أو بالنثر، تجاربهم الخاصة، التي تستند إلى حاصل خياراتهم وتوجهاتهم». فوسط الكثرة المتكثرة داخل المشهد الشعري، ثمة بعض التجارب أن تصنع باختلافها وتوقيعها الخاص، ما تضيفه إلى هذا المشهد على نحو يمكن الحديث معه عن «فردانيات» في التعبير الشعري، وعن مساعٍ اجتهادية في البناء، ما يبعدها عن الاجترار والتقليد، وعن النمط والنموذج، لصالح اجتراح «زوايا» و»نظرات» و»وجهات» في القول الشعري. هذا ما جعل الكثير من الشعر يبحث عن لحظة، عن نافر، عن مختلف، عن «وجيز» عن السردي، عن الحميمي، عن التعريض الساخر بكثير من اليقينيات والاعتقادات.
فهذه الحساسيات تمثل في حد ذاتها قطيعة أخرى ضمن قطائع الشعر العربي التي عرفها منذ بدايات القرن العشرين، وهي استمرار لتراث الشعرية العربية العظيم الذي لا ينقطع، بأي حال، عن حركة التاريخ وإيمانه بجوهر الكلمة في علاقته بالإنسان وخبزه اليومي. صحيح، أن أصحابها لم يعد يهتمون بالقضايا والمعضلات السياسية والاجتماعية التي شغلت نظراءهم في السابق، ولا هم خريجو أحزاب وهيئات أيديولوجية ونقابية ودعوية، ولا كان لهم ارتباط بالتاريخ أو هوس، لكن هذه التفاصيل والهموم الصغيرة التي تحتفي بها نصوصهم وتنفتح عليها، هي تشبههم بلا ادعاء مجد أو بطولة، يستمدون موادها ومتلاشياتها من مفارقات الوجود واختلاطات العالم اليومية. يقول عباس بيضون: «أرى أن الشبان مضوا أبعد مني، أو منا في خروجهم على الفصاحة وفي رجوعهم إلى اليوميات المدينية، وفي مزاوجتهم الغناء والنثر، وفي عودتهم إلى المحكي، وإلى النثريات وإلى الارتجال. أتذكر أن شيئا من هذا كان دعوة لي ولآخرين مثلي، لكن الجدد ساروا في هذا على طرائقهم، وأحيانا بجسارة قد تكون موضع اختلاف كما قد تكون موضع ترحيب. اختلاف لا أدري مكانه، فالشعر ليس طريقة وهو لا يصنع مثالات ولا نماذج نهائية».
ولا يمكن أن نعزل مساهمات الشاعرات عن هذا الوضع الجديد، بما يعنيه من رهان على التجديد والاختلاف، فقد صرن يشكلن رافدا مهما في تجربة الشعر المعاصر، لاسيما بعد التراكم والتنوع الذي عرفه في الألفية الثالثة. تقول راوية يحياوي وهي تستحضر الأفق الجزائري: «ولن نذهب إلى البدايات لأنها شكلت شعر الهواجس الذي هو أقرب إلى الخواطر لأن الضمائر النسوية المستترة التي كان تقديرها «هن» تحولت إلى ضمائر منفصلة وفاعلة «أنا أكتب» فقالت في بداياتها الإصرار على الكتابة الكينونة «أنا أكتب إذن أنا موجودة» أما في الألفية الثالثة فقد شكلت القصيدة النسائية رهانها في التعدد والتنوع أيضا، وأسست لحساسياتها الجمالية أيضا، داخل الأشكال الشعرية المختلفة من قصيدة النثر والومضة والشذرة والهايكو، وراهنت حتى في تحديث القصيدة العمودية لأن الذات الأنثوية اختبرت رهاناتها الإبداعية فذهبت إلى أقصى أسئلة وجودها، فخرجت من الهواجس البسيطة إلى عمق الكينونة، وقالت ذاتها المختلفة، من خلال رؤاها وجسدها إلى درجة ظهور الذات الأنثوية الصوفية كتجربة مختلفة. لذا يمكننا أن نقف عند الرؤيا في الشعر النسائي، لأنها تشكلت وفق أدواتها الخاصة ورؤيتها للعالم والوجود والعبور عبر عوالم مختلفة انطلاقا من الذات التي قوضت السلطة، إلى الذات التي تتذكر متملصة من الاستنساخ، إلى الذات التي تكتب إشراقاتها وجسدها وتجاوزت الوجع والألم إلى كينونة تفلسف هذه الهواجس وتحولها إلى كينونة مُتخلصة من ضعفها، لأنها تستقوى بالكتابة فخلقت عوالم إبداعية بديلة».
مستقبل داهم
قد يُساء الظن لوقت داخل هذه المرحلة الانتقالية، بل ترفع أصابع التهمة والازدراء بشعراء اللحظة الراهنة ومخاصمة نصوصهم نقديا وتأليب المؤسسة عليهم، إلا أن القارئ الذي يسبقه حدس المعرفة وواجبها، يثق فيهم وفي مستقبل مشروعهم. يقول هاشم شفيق: «أما الجيل الأحدث وأعني جيل عام ألفين فما فوق، فهو الاحتياطي الكبير للشعر العراقي، ذلك أن هذا الجيل له أفكاره المختلفة حول الشعر، وإن شابها بعض السهولة، والتأثر بحركة الترجمة العالمية، لكنه ومثل كل جيل عراقي وعربي، سيصفو في النهاية ويلتفت الى تجربته الخاصة. وأهم ما يميز هذا الجيل هو الكتابة بيد جريحة، وروح مكلومة، ومتمثلة للخراب الروحي والنفسي والاجتماعي الذي يُهيمن على مفاصل الحياة العراقية الآن. ثمة أصوات باهرة ومفاجئة في هذا الجيل، صادمة للذائقة العادية، ومخترقة للسائد، والمكرس، والعادي، وهي تحمل شارة مفارقة لما قبلها، لذا فإنها تنبئ بالتطور الذي سوف يحصل في سياق الشعر العراقي مستقبلا، ولسوف تُغني في ما بعد حركة الشعر العربي من جديد، وترفدها بعوالم متحولة، وذات رؤى معبرة، تشي بالتخطي والتجاوز».
لكن أخطر ما يواجه هذا المستقبل هو مأزق التنميط على مستوى الشكل والمفردات وتمثلات البلاغة السائدة، مثل العودة إلى القصيدة العمودية التي فرضت نفسها في وسائل الإعلام، بل نجحت الجوائز في استقطاب عدد كبير من الشعراء الذين «يكتبون وفق مقاييس اللجان، لا وفق مقاييس الشعر» كما يقول فتحي عبد السميع. وإذا كان هناك شعراء، في نظره، «يكتبون عن إيمان بقدرة القصيدة العمودية على استيعاب المتغيرات العصرية، والتفاعل مع التطورات النظرية التي حدثت لمفهوم الشعر، لكن ذلك الإيمان لم يعبر عن نفسه بالشكل المناسب لتلك التطورات». كما احتشد المشهد بمتعاطي النثر بديلا عن النظم، وزُين لكثيرين منهم «اتخاذ قصيدة النثر أفق كتابة يرومون به توسيع ممكنات الشعر واختبار مسالك أخرى في قوله. لكن قلة منهم استطاعوا، في تقدير فتحي الخليفي، أن يبلغوا سقف ذلك المرام بفضل وعيهم النظري العميق بصعاب قصيدة النثر أولا، وما أظهروه من قدرة على إخضاع مختلف مكونات نصوصهم وروافدها لمقتضيات الوظيفة الشعرية في مفهومها العام، لا مفهومها الجاكبسوني الضيق». وتساهم بعض الظروف القاهرة مثل الحصار والحرب في تكريس الكليشيهات على نحو يربك أدوات النقد الموضوعي كما في الشعر الفلسطيني أو السوري مثلا، أو مثل غياب الديمقراطية والرأي الحر في تكريس لغة الرمز والتعمية والإبهام في غير بلد عربي.
كاتب مغربي