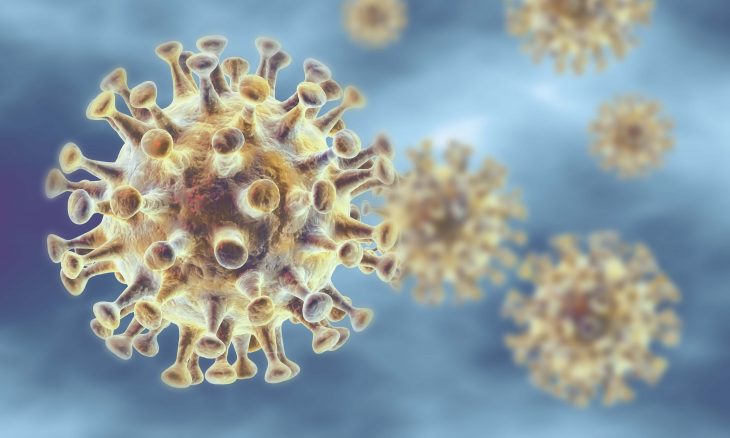
حين كتب البير كامو روايته الشهيرة «الطاعون» وجد في ثيمتها مجالا للتعبير عن فلسفته، وعن لاجدواه وعن إحساسه بالعبث، وعن كراهيته للأيديولوجيا التي تشبه الوباء، وعن رؤيته الغاضبة لعالم مكلوم ومفجوع، خسر الكثير من اطمئنانه الوجودي والثقافي والاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية.
حصل صاحب الرواية على جائزة نوبل، لكنها كانت- أيضا- سببا في مقتله الغرائبي، كما تقول الإشاعات، لأن الرواية كان تخفي في سردياتها أقنعة مؤدلجة، ومتفلسفة، ومواقف صاخبة وملعونة، فيها من الحدوس والتوريات ما توحي بالرعب المقبل مع صعود النزعة الستالينية في فرنسا، وتحالف الاشتراكيين البورجوازيين مع بعض توجهاتها الثقافية.
حديث الرواية قد يصلح اليوم لاستدعاء الكلام عن جائحة «كورونا» التي أعادت إنتاج صورة المدينة المنكوبة، إذ وضعت العالم في قفص واقعي وليس سرديا متخيلا، كما فعل كامو في مدينة وهران الجزائرية، وبقطع النظر عن الزمن السياسي والتاريخي، الذي اقترحه لأحداث روايته، فإن الأحداث الغامضة في مدينة ووهان الصينية ليست بعيدة عن سرديات السياسة، ولا عن حرب البيولوجيا، ولا عن الصراع الصيني الأمريكي، التي تنبأ ببعض تمثيلاته السينمائي ستيف سوديربيرغ في فيلمه «كونتيجن» قبل أكثر من تسع سنوات، الذي لم يترك حينها أثرا فنيا كبيرا، سوى طابعه التخيّلي الذي يربط الأحداث بالمكان الصيني- هونغ كونغ- وبطبيعة الحدث الذي يخصّ غموض تعرّض المكان إلى عدوى فيروسية، مثلما يرتبط بخصوصية البطل الأمريكي الخارق، الذي سينقذ الجميع، ويضع الآخرين في الشرق على طاولة الاتهام دائما، لأنهم يأكلون الخفافيش والأفاعي والغربان، فرغم زحمة النجوم في الفيلم، إلّا أنّ سيناريو الفيلم أراد أن يُقدّم خطابا لا يخلو من التشفير السياسي، الذي مزج فيه المخرج بين واقعة الانتهاك الفيروسي، وجرعة من الخيال العلمي، وهي ثنائية اشتغلت عليها سينما هوليوود في سياق صناعتها للبراديغم الأمريكي ولبطولته واستعراضه.
جائحة «كورونا» أعادت إلى الأذهان أحداث فيلم» كونتيجن» حدّ أن البعض وضعه في سياق الكشف عن ثيمة الوثيقة، التي تدين سياسة الولايات المتحدة، وأهدافها، وعبر تشابه الحدثين القائمين على وجود فيروس قاتل يُصيب الجهاز التنفسي، وله أعراض متماثلة، وكذلك عبر تقارب العلاقة بين المكان السينمائي في هونغ كونغ والمكان الواقعي في مدينة «ووهان» الصينية.
العقل السينمائي والعقل الاستخباراتي
بعيدا عن لعبة المفاهيم، والنظرة التداولية لها، تأخذ العلاقة بين مسميات معينة بُعدا يقوم على فعل الوظيفة، وعلى مدى تأثير هذه الوظيفة في صناعة المفهوم والوثيقة، والفكرة، وفي الترويج لها، وبيان الغاية منها لإحداث الضرر الذي يخصّ دحر العدو، وخلخلة معنوياته، وتفكيك دفاعات منظوماته السياسية والأمنية والأيديولوجية. فما قدّمه فيلمه «كونتيجن» لا يدخل في سياق أفلام الخيال الفيروسي فقط، بل في سياق يشبه إلى حدٍ معين أفلاما ساندة لما سمّي سابقا بـ»الحرب الباردة» أو «حرب الأهداف» إذ كشف الفيلم عن تداخلٍ، ولو سري مع الوظيفة الدعائية، لاسيما مع ما يخصّ العدو الثقافي والتجاري والأيديولوجي، وهو ليس بعيدا عن سلسلة أفلام قدمتها السينما الأمريكية والعالمية خلال السنوات الماضية، مثل فيلم Out break للمخرج وولف جينج بيترسون، والفيلم الكوري الجنوبي The Flu للمخرج كيم سونغ سو، والفيلم الأمريكي «الحرب العالمية زد» للمخرج مارك فوستر، وفيلم «يوم القيامة» للمخرج نيل مارشال، وفيلم «أنا أسطورة» للمخرج فرانسيس لورانس، وغيرها.
في حرب «كورونا» تحولت مدينة ووهان إلى عتبة سردية، تتناص بقسوة، وبخلطة أنثروبولوجية مع ما يعصف بمدن الحداثة، ومدن الفقر والهامش من تحولات ومكاره فاجعة.
لكن أحداث « كورونا» والطبيعة الغامضة التي رافقتها، جعلا خطورتها وكأنها جائحة تجاوزت الذاكرة السينمائية، ولعبة اطمئناناتها المغشوشة، فطريقة العدوى التي حدثت في مدينة «ووهان الصينية» أصابت العالم بالصدمة، تحطمت معها النظم الصحية التقليدية، وصولا إلى ما حدث من كوارث في مدن أوروبا الكبرى في إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفي عديد المدن الأمريكية، التي جعلت الرئيس دونالد ترامب، يُسمّي الوباء بـ»الفيروس الصيني» بنوع من التشفي، ويُعلن إزاءها حالة الطوارئ في أمريكا.
هذه الأحداث الكونية وضعت العقل الثقافي أمام أسئلة مفتوحة، لسرديات العقل السينمائي والعقل الاستخباراتي، إذ يملك كلا العقلين قدرات خارقة، وتخيّلات كبيرة لصناعة العدو والوثيقة والفيروس في قناعه السينمائي، أو في رمزيته الدعائية، وأحسب أنهما يشرعان منذ الآن للتخطيط نحو مرحلة ما بعد الفيروسية، على مستوى توسيع مديات الاستثمارات السينمائية، أو على مستوى احتكار الاستثمارات الدوائية، وهو أخطر ما يمكن التعاطي معه في المرحلة المقبلة، لاسيما أنّ فيلم «كونتيجن» اشتغل على فكرة احتكار اللقاح الخاص بالوباء..
سرديات الحرب المقبلة
تحوّل مدينة وهران إلى مكان مغلق، معزول، كان اللعبة السردية التي أراد من خلالها كامو أنْ يصنع خطابا سرديا لنظرته حول الأيديولوجيا، وأن يضع العالم الخارج من الحرب العالمية الثانية أمام مصير آخر، وحرب أخرى، الأسلحة فيها غير مرئية، والسيطرة فيها تقودها قوى غامضة، تمارس سلطتها في المدينة من خلال الجرذان، حيث يتحول الجميع إلى ضحايا، وفي حرب ملتبسة ضحاياها لا لون، ولا طبقة لهم، ورغم ما في سرديات كامو من رائحة عنصرية في وصفه للمدينة، التي تصورها «بغير حمام ولا أشجار ولا حدائق»، إلّا أن الرواية أثارت أسئلة وجودية كبيرة، ليس عن عبث المصائر، بل عن العزلة والوحشة وعن عبث القوة حين تفرض سطوتها على الإنسان الباحث عن وجوده وحريته..
في حرب «كورونا» تحولت مدينة ووهان إلى عتبة سردية، تتناص بقسوة، وبخلطة أنثروبولوجية مع ما يعصف بمدن الحداثة، ومدن الفقر والهامش من تحولات ومكاره فاجعة. هذا الاشتباك هو ما أعادنا إلى حرب طاعون كامو، الذي يُصاب بعدواه الطبيب واللص ورجل الدين، وكأن قدرية هذه الحروب غير المسيطر عليها، هي التي تحتاج إلى أركيولوجيا فاعلة، ليس لكشف خطابها المُضمَر، بل للحفر في «أنساقها المخاتلة» لتعرية خلل قيم الحداثة الغربية، وتشوه النظام الصحي فيها، وسرائر القوى التي تقف وراءها، وغموض السرديات التي تتعالق بها، وأحسب أن تداعيات هبوط أسعار النفط، وتصدع النظام التجاري العالمي، وانهيار منظومة الشركات العابرة للقارات، هو ما يُبرز مفاعيل تلك السرديات، غير البعيدة عن العقل الاستخباراتي، التي ستجد في قابل الأيام ما يعوض خسائرها في اشتغالات العقل السينمائي، وهو يعيد قراءة الأحداث من زوايا ما يتكشف من الوثائق والأسرار التي تصنع الحرب والفيروس والضحية..
٭ كاتب عراقي