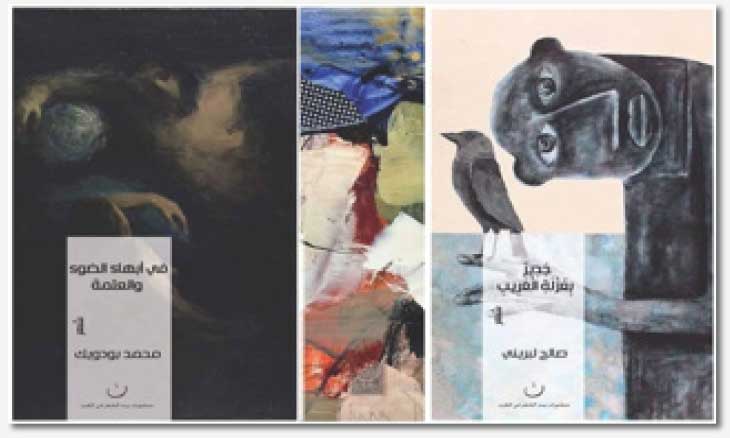
أصدر بيت الشعر في المغرب مجاميع جديدة لشعراء ينتمون، كتابيا وجماليا، إلى اتجاهات وحساسيات متعددة، لكن ما يجمعهم هو الرغبة في كتابة نص مختلف. وهكذا صدر لمحمد بودويك «في أبهاء الضوء والعتمة»، ولمحمد عرش «مخبزة أونغاريتي»، ولسعد سرحان «مرايا عمياء»، ولعبد الإله المويسي «أقرأ جي جاميسون وأفكّر في قابضة السوبر ماركت»، وليونس الحيول «رجلٌ يقرأ طالعَه»، ولمحسن أخريف «مفترقُ الوجود»، ولصالح لبريني «جدير بعزلة الغريب»، ولعبد الله بلحاج «أقفال صغيرة»، ولنادية القاسمي «متلبسة بالتراب»، ولدامي عمر «معابر الحبر»، ولعبد المالك مساعيد «أكف تودع صلصالها»، ولعبد المجيد بنجلون ديوانه بالفرنسية: « seuls comptent pour moi».
نحاول أن نختار من بين هذه المجاميع ثلاثا، وهي على اختلافها وتمايز قيم اشتغالها الجمالي والثيماتي، إلا أن الأفق الذي تتّجه إليه لا يتعارض ومسعى تحديثها للنص الذي تكتبه.
في أبهاء الضوء والعتمة: فضاء الموت
ينتسب محمد بودويك، عمليّا، إلى شعراء الثمانينيات ممن واصلوا سيرورة تحديث الخطاب الشعري في المغرب، ولا سيما حين استعاضوا عن هتافات الخطاب الأيديولوجي بالبحث في كتابة جديدة وجدت متنفّسها في قصيدة النثر، وإن كان قد نشر نصوصه الأولى التي سيضمُّها ديوانه «جراح دلمون» (1997) في منتصف السبعينيات. إلى الآن، راكم هذا الشاعر بحساسية أناه الغنائي الذي يمتحن إيقاع الذات ويعبر طاقات اللغة المتخففة من بهرج البلاغة. والأنا الغنائي ـ كما يذهب إليه الشاعر- هو ذات متلفظة في القصيدة، بالأساس. ومن ثم، يكون مفارقا للواقع، متعاليا على قوانينه، وإنْ نبع وانبثق من الذات الكاتبة، بقدر ما يحتكم في وجوده إلى اللغة ورحابة المتخيل. فالأنا في الشعر، بما هو مقوم غنائي، وضمير نحوي وأجرومي متكلم، لا يحيل بالضرورة على الشاعر، وعلى تجربته الخاصة، وإنما هو «لعبة فنية» لخلق ما يسميه ميكائيل ريفاتير بـ«الوهم المرجعي».
تتجاوب المجموعة الشعرية الجديدة «في أبهاء الضوء والعتمة» مع خواصّ هذا الأنا وتجربته في الكتابة التي تزاوج الشعر بالفلسفة وتضمّ المعين الأسطوري والميتافيزيقي إلى اليومي والعادي على نحو صافٍ وشفيف يؤذي قارئها في الصميم؛ حيث تدور معظم نصوصها حول الموت بما هو حياة أخرى. ولعل مقولة الشاعر والمسرحي الفرنسي جان كوكتو التي صدّر بها العمل، أن تكون مسعفة لنا في فهم أجواء الديوان بعامة. يقول: «للموت اخترت ديكورا مختلفا عما للأموات. إنه تفصيل قد لا ينتبه له كثيرون. فبقدر ما الموت محاط بالأناقة الباردة، هم الأموات محاطون بالفوضى الحارة».
وبما أن فضاء الموت حمّال أوجه بالصورة والنسج، فقد جاءت معظم نصوص المجموعة طويلة على نحو ما ومحكمة البناء، فمن جهة تتكئ على فلسفة رواقية وأبيقورية، ومن جهة ثانية تشتغل على لغة تصويرية لا نخطئ شفافيّتها بقدر ما معاناتها في احتضان المجهول والتجاوب مع أصدائه البعيدة ذهابا وإيابا؛ مثل: خيلاء رتيلاء، خنفساء المشيئة، ما لم يقله غراب إدغار آلان بو، البومة إيميلي، ترانيم الموتى في اليوم الثامن، جزيرة الموتى، أين القبر بالتحديد؟ إلخ.
يتخذ الشاعر من الرتيلاء ـ مثلا- رمزا للحياة القصيرة الذي يتسلل إليها الموت، ومن «لعابها المقدس» يصوره سمّه الزعاف والبارد الذي يهدم أعمارنا شِلْوا.. شِلْوا، ويعطل حلمنا الذي ما انفكّ يسكننا.
يتخذ الشاعر من الرتيلاء ـ مثلا- رمزا للحياة القصيرة الذي يتسلل إليها الموت، ومن «لعابها المقدس» يصوره سمّه الزعاف والبارد الذي يهدم أعمارنا شِلْوا.. شِلْوا، ويعطل حلمنا الذي ما انفكّ يسكننا. إنها ـ والحالة هذه – «رسولة الموت بشعيراتها اللّاتُعدّ». ومثل ذلك يصير للخنفساء صورة مشخّصة للتمزق بين المشيئة المقدَّرة والتحول المستحيل الذي يطلبه أنا الشاعر ولا يصل إليه. وفي تناصّ مع (غراب) الشاعر الأمريكي إدغار آلان بُّو، يعيد تأويل لازمته الشهيرة من خلال دالّ الريح التي تكشف عن سخرية الزمن وعبثه بمقادير الناس، فاتحا في تخاريمها معانيَ جديدة تمتدّ إلى سؤال أبي الهول وعماء النشأة الأولى، عابرا تلك المآسي التي تنضح من سم سقراط ودموع هيباتيا وأقواس لسان الدين ابن الخطيب وضوء طاغور، ومن مناجم جرادة.
من نص إلى آخر، يفلسف الشاعر بغنائيّته الخاصة ثيمة الموت، بل إنّه يبحث داخل فضائه أكثر الأسئلة إلغازا في حياة الكائن الإنساني، وهو يذرع الممرّات الغامضة في فاس وساربروكن (ألمانيا) وفينيسيا (إيطاليا) وسالسبورغ (النمسا)، والوادي كذلك. ويكفي أن نسمعه في آخر نفس من نص مُطوَّل بعنوان «ألبوم وادي شجر الدفلى»:
«لكنني،/ لستُ اليوم كما كنتُ بالأمس./ فقد علّمتني دوّاراتُ الريح،/ ودرسُ السماء المتأخر،/ أن أكون بهلوانا سعيدا،/ أفتضُّ بكارات الأصباح الرمادية،/ وأقلب باطن الأحزان مسرّاتٍ/ كما كنتُ أفعل بمهملات الجوارب./ أنثرُ حَبّ السلوان في قفصي،/ دالفا – من الباب الموارب لعسس السلطان/ إلى خُمّ دجاج يبيض ذهبا/ مثل صبي يضع/ زهرة دفلى ناصعة في شعره،/ ومثل جُنْدب فضّي/ يقفز بين الظل والشمس/ أيها الوادي الذي لا يزال يجري فيّ/ أنا لم أرحل/ أنا لم أعد/ فكيف أقولُ اليوم: أَمْسِ جِئْتُكَ؟».
من عمل إلى آخر، تستحق تجربة الشاعر محمد بودويك، بالنظر إلى جدّتها وغناها المعرفي، أكثر من وقفة لتأملها وبحثها؛ فهي من التجارب النوعية التي تترك لدى قارئها شعورا رائعا بجدوى الشعر في زمن لاشعري.
متلبّسة بالتراب: امرأة من سلالة الأرض
يندرج ديوان «متلبّسة بالتراب» للشاعرة نادية القاسمي التي تكتب نصوصها الشعرية في صمت متأمِّل منذ بداية التسعينيات، ضمن حركة الشعر النسائي في المغرب. وهو يأتي – بعد باكورتها الشعرية «رياح بليلة»- تتويجا لهذه السنوات من الكتابة، بعيدا عن جلبة الأضواء، وقريبا من الشعر الذي اختارته أفقا للتأمُّل في الذات وفي الكون.
من خلال إيحاء العنوان وعبارة التصدير «الأوراق فتنة المقصلة في خريف الانكسار»، تنتمي قصائد الديوان، رمزيّا، إلى شرطها العادي بما ينطوي من أبعاد عادية ومألوفة حينا، وسيريالية غارقة في الفجائعي والغريب حينا آخر، فيما هي تنبني على لغة مقتصدة تنشد العمق في التجربة واستنطاق العلامات التي تحوم حول الجسد والمتخيل في علاقتهما بالبعد السيرذاتي، لكنّها تحرص على ألا تتلاشى داخل الخواطر الشخصية والاستطرادات ومخايل الانغلاق على الذات:
«بلغة ما
تترنّح
العقارب حول نفسها
حين تشمُّ
رائحة التراب»
وتتوزع هذه القصائد بين القصيدة متوسطة الطول التي تُضاعف شرط كتابة الأنا وانكتابها، والمتمفصلة على مقاطع شذرية تعكس تشظي هذا الأنا، وقصيدة الومضة/ اللحظة المسكونة بهاجس التقاط الحالات العصية المنفلتة بقدر ما هي راغبة في اجتراح حياة مطمورة:
«اِرفعْ رأسك،
وابحثْ في كرّاسة يومياتك
عن آلاتٍ موسيقية،
لأميرةٍ مفقودة
شئتُ أن أكونها.
في طرق النازحين،
سأجر بثيابي المهلهلة
عرباتِ الحروف»
إنّ لغة الأنثى تخلّصت من بعدها العاطفي والسنتيمنتالي الذي ناب عن وجودها ردحا من القهر، وما فتئت تقدّم عبر نصوصها النزّاعة إلى القصر والتكثيف رؤيتها الرافضة للواقع، بل إنّها تحجم عنه بخلق واقع لغويّ تبنيه بالمجاز وصور العود الأوّلي والحنين إلى الطفولة. وبالنتيجة، تصير كل كتابة للذات ـ هنا- تخييلا، مثلما أنّ كل كتابة للحياة تصير تخييلا، ولا يبقى في آخر التحليل سوى الأنا على الصفحة وهي تتلامح أمامنا مثل مشروع في طور التشكُّل إلى ما لانهاية.
وعلى العموم، فإنّ تجربة الديوان مبنية على رؤية أنثوية خاصة وقلقة وجوديّا، تتأمل في ما هو ذاتي وسيري، وفي مجرى العلاقات الإنسانية ونداء الكينونات الخافت، وهو ما يعطي لهذا الديوان قيمة مضافة ليس إلى تجربة الشاعرة نفسها وحسب، بل إلى الكتابة النسائية الجديدة.
يثبت الانهمام بالذات في صوتها الخافت والحميم كمرجعية جمالية يترتّب عليها تذويت الملفوظ الشعري، وشخصنة الموضوعات والصور والمواقف من الذات والكتابة والوجود.
جديرٌ بعزلة الغريب: رغبة الانطلاق
عبر مجموعة تحت الاسم نفسه، نتعرف على صوت شعري تخترقه تلفظات الأنا الغنائي الرعوي الذي يبني من متنافرات الحياة المنثورة معمار كتابته الخاصة، ولا يخفي بوحه المسكون بالمعاناة والألم. يقول صالح لبريني:
«وَأَنْتَ سَلِيلَ الرَّبَابَاتِ المنتشية بِصَلَوَاتِ الْبَوْح
خُذْ بِيَدِ الْحَيَاةِ
كَيْ تَسْتَعِيدَ عَافِيَةَ النَّشِيدِ
وتؤرخ لَعْنَةَ الرَّقْصِ عَلَى نَاصِيَةِ الجرح
أَنْتَ الْمَنْذور إِلَى عَاقِبَةِ التيه».
بذريعة التيه والعزلة، يصير بوسع هذا الأنا أن يسرد محكيّه الحياتي، وعبره يضم السجل الأسطوري إلى اليومي جنبا إلى جنب. يحكي بمزيج من الرثاء والسخرية المرة، عن شهوة النساء السامقات، وإيلان، ودمشق، والجنوب، ومحمود درويش، ومتاهات الفلاحين، وسرير بروكست، والوطن الجريح، وعن جسر أبزو حيث جاء إلى العالم أول مرة. ولم يكن يرثي في واقع الحال إلا نفسه وسط مشاهد صخّابة وحية من الحقل الطبيعي المتراحب بما تحتمله من تدفُّق وشهوة وعشق، ومن تنافر الأضداد التي تشع برغبة الحياة التي تعارك خلالها سطوة الموت:
«أيُّهَا الْمَوْت
أَمْهِلْنِي قَلِيلا
كَيْ أرَتّبَ بَقِيَّةَ الْعُمْرِ
أَنْ أُرْسِلَ رَسَائِلِيَ الَّتِي تَعَثَّرَتْ فِي الْبَرِيد
نِكَايَة فِي الْحَبِيبَة
أَنْ أَتَجَوَّلَ فِي الطَّرِيقِ التي تَعْتَنِي بِخطوَاتِي التَّائِهَة
وَأوصِيهَا بِرِعَايَةِ ظِلّي».
لكن الأنا لا يستسلم، بل يصنع من كلماته حكمة الحكمة، بَلْه ذريعة لمقاومة الواقعي وتبديده، ومن ثمّة يرغب في التحرر والانطلاق إلى ما هو جدير بإنسانيّته. وفي هذا السياق، يتصادى صوت الشاعر مع صوتين رافضين، هما: عبد الله راجع وأمل دنقل. يستعير من الأول الحزن الباني، وهو يقول: «وَلِي كَثِيرٌ مِنَ الرهَانِ كَيْ أربَحَ /خَيْبَاتٍ بِحَجْمِ سيولَةِ الْحروبِ/ وَمَكَائِدِ الْحَيَاة/ وَأَكْنِزَ ذَخَائِرَ مِنْ غَيْمَاتٍ». ومن الثاني حكمة الخسارات: «سَادِن الصحْرَاءْ/ أَرْعَى التيهَ فِي خَطْوٍ شَارِدٍ / أبَايِع الْمَدَى مَلِكا عَلَى التيه/ وَأَبْتَسِم مِنْ خَيَالٍ يحرض الْخَيْبَة/ عَلَى الْأَحْلَام/ يبَارك وَهْمَ الْحَيَاةِ فِي ضَرَاوَةِ الْخَرَابِ/ يوَزع وَرْدَ الْمَوْتِ عَلَى الأَحْيَاءِ/ وَيَقِف قُرْبَ الْحَقِيقَةِ شَامِخا /بِخَسَارَاتِي..» يثبت صالح لبريني، من خلال هذه المجموعة الثالثة في مسار تجربته الشعرية، جدارة انتساب صوته إلى إبدال الحساسية الجديدة التي يختبرها راهن الشعر المغربي، فيما هو تواصل مغامرة التحديث الفني واللغوي للمنجز الشعري العربي برمّته.
وإذن، فنحن أمام واقعٍ شعريّ يتسم بالخصوصية الحادّة التي تجترح مفرداتها المؤلمة من واقع إنساني جارف وأعمى، وهي أكثر بروزا، بعد أن كانت متوارية خلف أساليب الرمز والتجريد على نحو ما يمثّل إضافة نوعية للسياق الكتابي.
وفي هذا السياق، يثبت الانهمام بالذات في صوتها الخافت والحميم كمرجعية جمالية يترتّب عليها تذويت الملفوظ الشعري، وشخصنة الموضوعات والصور والمواقف من الذات والكتابة والوجود. وهذا ما أطلق متخيّلات جديدة ساهمت في بروز رؤى شعرية مختلفة ومتنوعة تعكس في مجملها، إمّا وضع الاغتراب واليأس والحزن التي تتملّك الذات، أو استقالة الذات من الواقع ونفض اليد عن إلزاماته وحاجياته، أو الرغبة الطافحة بالحب والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرُّر من القيود، أو التوق لتحقيق التوحُّد مع المطلق، أو فلسفة الموت ضمن معجم حسّي وغنائي عارم.
٭ شاعر مغربي