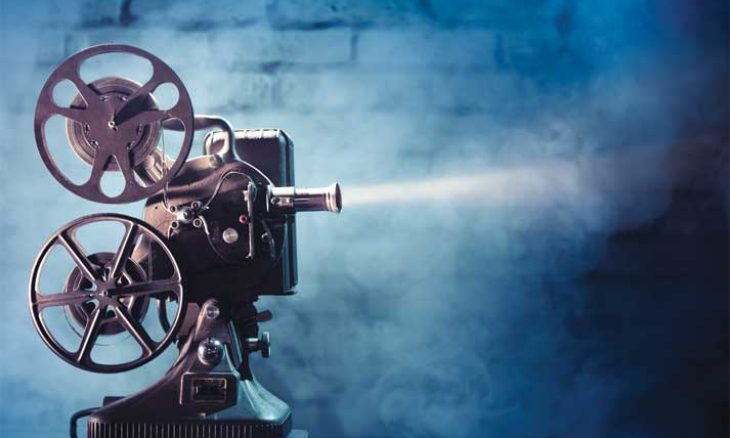
أدين لفيلم فورست غامب أنه أدخلني لعالم الكتابة السينمائية، ونقلني من مشاهد للأفلام إلى محاور لها، لا يعني ذلك أنني لم أكتب عن السينما قبله، فقد كتبت مبكراً عن فيلم للمخرج السينغالي عثمان صمبين «كِدّو»، كنت شاهدته في مهرجان سينمائي في دمشق، كما كتبت عن فيلمين عربيين آخرين من بينهما فيلم «انتبهوا أيها السادة» من بطولة محمود ياسين.
فورست غامب، فتح بوابة أخرى، إذ بعد أن وجدت نفسي أكتب ما يعادل خمس صفحات عنه، وأنشرها، عدت وكتبت عنه 20 صفحة، حين قررت إصدار حصيلة تلك الكتابات في كتاب.
فيلم جميل مختلف لمخرجه روبرت زميكس، عن رواية صغيرة لونستون جروم، وقد ظل هذا الفيلم، ومعه فيلم «ملقى بعيداً»، أو «المنبوذ»، من أجمل ما أخرج زيمكس، وأجمل ما أدى توم هانكس، في ظنّي.
المناسبة الأولى لهذا الحديث هو الاقتباس الهندي للرواية، وتقديمها في فيلم من بطولة عامر خان، بعد تغيير اسم الشخصية بالطبع لتصبح «لال سينغا شادا»؛ وخان ممثل قدّم عدداً من أجمل الأفلام وأعمقها مثل «كالنجوم على الأرض» و «PK» وغيرهما من الأفلام الرائعة الكبيرة، التي تُذرّي ذلك الاصطلاح الفقير الذي يهجو به الناس لدينا أشياء كثيرة، فيصفون حكاية ما، أو واقعة، بأنها «فيلم هندي»!
أما المناسبة الثانية فهي قيام توم هانكس نفسه باقتباس فيلم سويدي شهير عن رواية شهيرة «رجل يدعى أوف» لفريدريك باكمان، أخرجها للسينما هانز هولم وقام ببطولته رولف لاسجارد.
ربما من الجميل أن نتأمل هنا «حال الأصل» وهو يُرحَّل إلى ثقافة أخرى تتشرّبه على طريقتها، ومآل النص الروائي أو السينمائي وهو يُبدِّل جلده ومعارفه وخلفيته الثقافية في سعيه لأن يكون أصلاً ثانياً، دون أن يتنازل عن قلبه وروحه بالطبع.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا: هل يمكن أن يكون الأصل أصلاً ثانياً وهو يُرحَّل إلى فضاء آخر؟
ليس هذا الأمر مقتصراً على اقتباس أفلام من السينما العالمية، فالرواية العربية وجدت نفسها أحياناً في أفلام أخرى، بعد أن كانت أُنتجت عربياً، مثل رواية «زقاق المدق» لنجيب محفوظ، التي تحولت إلى فيلم مكسيكي، وقبلها بعامين رواية «بداية ونهاية».
ويمكن أن نتتبع عشرات المسرحيات التي حوِّلت إلى أفلام في أماكن كثيرة وارتدَتْ أفقاً جديداً ونحن نرى أعمال شكسبير تتحول إلى أفلام يابانية، أو روسية، أو يتم نقلها من زمنها الذي تدور فيه أحداثها إلى زمن آخر، كما فعل المخرج باز لوهرمان وهو ينقل «روميو وجولييت» إلى نهايات القرن العشرين، وحدث ذلك لمسرحية «هاملت» أيضاً وغيرهما.
لكننا سنبقى بين سؤال الأصل والنسخة، والعامل المشترك بينهما هنا هو توم هانكس.
لقد كان تحدياً كبيراً له أن يذهب إلى فيلم سويدي شهير، وناجح، ليقوم بأمركته، بخاصة أن تجارب «سرقة الجمال» الأمريكية كما وصفتها ذات يوم، لم تستطع أن تحقق النجاح الذي حققته الأفلام الأصلية مثل: الإسباني «افتح عينيك»، رغم وجود توم كروز في الفيلم الأمريكي واستعارة بنولوبي كروز من الفيلم الإسباني أيضاً، وليس السيناريو وحسب، والفيلم اللاتيني «السرّ في عيونهم»، رغم وجود نيكول كيدمان في الإنتاج الأمريكي وكذلك وجود روبرت دي نيرو في النسخة الأمريكية من فيلم «الجميع بخير» الذي قام ببطولته مارتشيلو ماستورياني.
لقد اقتضت كتابة هذه الكلمات مشاهدة الأفلام الأربعة لتوم هانكس واستعادة رواية «رجل يدعى دوف»، ولعل أجمل ما في هذه الرواية قدرتها على أن تمنح كاتب السيناريو خيارات كبيرة كثيرة، بحيث تتمنى لو أن هذا المشهد أو ذاك لم يهمله السيناريوهان.
يصيبنا الفيلم الهندي المأخوذ عن «فورست غامب» بخيبات أمل متتالية، لعل من أهمها فهم الشخصية من قبل مؤدّيها، ففي وقت يظهر هانكس في الفيلم في صورة البريء الحكيم، يظهر خان –بمبالغته في أدائه الجسدي- أشبه بالغبي الذي يقول كلاماً عميقاً بين حين وحين، لذا، ليس غريباً أن معنى الجملة الواحدة على لسانَي الممثلين تتغير أبعادها باختلاف أدائهما الذي تمت الإشارة إليه.
هذا الأمر ينطبق على تسطيح شخصية الحبيبة، وهي شخصية مُحرِّكة بقوة لمسارات الأحداث وأشجانها، ففي فورست غامب تبدو الحبيبة في ثوب الثائرة على وضع سياسي واجتماعي تجلى في ثورة الستينيات، في حين تبدو الحبيبة في الفيلم الهندي غارقة في الطموح الشخصي الذي ينحدر بها إلى المتاجَرة بجسدها.
على المستوى العام، يبدو الفيلم الأول أكثر شمولية وعمقاً وهو يتنقل بين الأحداث الكبرى، في وقت يقع فيه الفيلم الهندي في فخ عدم التمييز بين تجسيد عنف الشخصية لحماً ودماً والحديث عن عنف المجاميع التي يفترس بعضها بعضاً في الشوارع من أديان ومذاهب مختلفة، ولذا كان من الطبيعي أن ينكسر حسن النوايا التي سعى إليها الفيلم وهو يقترب من الإسلام؛ ببساطة، لأنه جسّد الشخصية التي تمثله، وجعلها واحدة من الشخصيات المركزية، التي يتفضل عليها السرد بغفران خطاياها، بل واحتضانها، وهذا فخ تجاوزه خان بأعجوبة مذهلة في تجربة أخرى، لا أظن أن فيلماً وصل إليها وهو يتحدث عن الأديان، كما في فيلمه PK.
.. وبعيداً عن الدخول في مسارات أخرى، أخفقت النسخة الثانية كثيراً وهي تحاول أن تنسينا الأصل، وهذا ما لم يحدث مع «رجل يدعى أوف» الذي تحولت نسخته إلى فيلم «رجل يدعى أوتو»؛ إذ يمكن الاختلاف على مستوى النسخة والأصل، لكن هوامش الاختلاف تبدو هنا قليلة، بوجود توم هانكس الذي ساهم في إنتاج الفيلم، والسيناريو المتقن الذي عزز عمق الشخصيات الثانوية، وبخاصة الجارة، ولا أخفي أنني حين شاهدت هذا الفيلم السويدي خطر لي سؤال: ماذا لو أدّى الدور جاك نيكلسون؟ مدفوعاً بدور نيكلسون الرائع في فيلم «عن شميدث» وبحبي له، لكن هانكس كان مذهلاً هنا، ويمكن أن نعتبر هذا الدور واحداً من أدواره الكبيرة، وأحد دورين بارزين أداهما خلال عام واحد مع دوره في فيلم باز لوهرمان الأخير عن الفس بريسلي.
وبعــد:
تحرص الماكنة السينمائية الأمريكية عادة على عدم إتاحة الفرصة للسينما العالمية أن تنتشر، ولذا، بدل أن تروّج لها، تقوم بشراء حقوق إعادة إنتاجها وتقديمها بغلاف جديد وتقنية جديدة ووجوه جديدة، وليس هذا غريباً، فأمريكا لا تتعامل مع السينما وحدها من هذا المنظور، بل تتعامل مع كل بارقة جمال أو علم في العالم بالطريقة نفسها.
مثلما الصّدى ارتداد موجي للصوت الأصليّ ضمن مسافة ( 34 متر للذهاب والإياب ) كذلك الصورة ممكن أنّ تكون انعكاسًا للأصل.أليس الظلّ مشتقّ من الشاخص بوجود الضوء.المهم وجود { ناقل } وسيط بين الصورة والأصل…
أما من الناحيّة { الفكريّة } فنجد أنّ ثمة تباينًا بين الرّواية بعد تحويلها إلى سيناريو فلم.لأنّ الأصل { الرّواية } مكتوبة ضمن زملكان خاصّ بالكاتب؛ أما السيناريو فهو : قصّة تروى بالصور؛ على حدّ تعريف سد فيلد أستاذ السيناريو في هوليوود.لهذا لم نجد الرّوائيّ نجيب محفوظ يعترض على المخرج والسيناريست الذين { يقلبا } روايته إلى فلم.
عزيزي إبراهيم، أنت تقول في نهاية الفقرة المخصَّصة للمناسبة الأولى واضعا اللوم على الناس (العرب) وملمِّحا إلى ذلك الاصطلاح الذي يهجون به في مجتمعاتنا أشياء كثيرة، فيصفون حكاية ما، أو واقعة ما، على أنها «فيلم هندي»! كان عليك، إذن، أن تضع اللوم كله على أنظمة الاستبداد “العربية” في الحيِّز الأول، وليس على الشعوب مطلقا، هذه الأنظمة التي لم تكن تسمح إلا باستيراد الأفلام الهندية التجارية البخسة بوصفها “بهاراتٍ” قادمة من الشرق الهندي يمكن إضافتها إلى طريقة أو طرائق إلهاء هذه الشعوب وإبعادها عن أيما تصرُّف تمرُّدي أو حتى تفكير ثوري – فلا تثريبَ البتة، في هكذا قرينة، على الشعوب المقهورة التي ليس لها إلا أن تتلقَّى ذلك التلقّي السلبي مدروسا بعناية شديدة من قبل أذناب السلطة العاملين بمثابة كلاب حراسة في هيئات رقابة السينما على وجه التحديد !!؟
يمكن اعتبار هذه السطور بمثابة إضافة موضوعية إلى الملاحظات النقدية الهامة التي أبداها الأخ باقر العسفة العتفة والشكر موصول له سلفا! أخ إبراهيم، أراك تتكلم هنا بسخرية وتهكُّم مبطَّنَيْن عن تجارب «سرقة الجمال» الأمريكية كما وصفتَها ذات يوم بأنها لم تستطع أن تحقق النجاح الذي حققته الأفلام الأصلية كمثل الفيلم الإسباني «افتح عينيك» (وبالمناسبة، ممثل أمريكي عنصري شوفيني تافه من مثل توم كروز ليس مقياسا مطلقا، في هذه القرينة، حتى تقول متحجِّجا «رغم وجوده في النسخة الأمريكية»، إلى آخره)! هل تعلم يا عزيزي أن جل، إذا ما قلنا كل، الأفلام “العربية”، وخاصة الأفلام “المصرية” منها، إنما هي بشكل أو بآخر سرقات من الغرب الأمريكي و/أو الأوروبي بامتياز شديد؟ ولكن هناك، والحق لا بد من أن يُقال، بعض الاستثناءات التي نجحت في “أصلنة” النسخ العربية على نحو لافت للنظر، ولا ريب في هذا – فمثلا لا حصرا، في حال مشاهدتنا للفيلمين الشهيرين «سونيا والمجنون» و«الإخوة الأعداء» حين كنا صغارا، لم نكن نشعر أيَّامَئذٍ بتَّةً بأنهما منسوخان عن الفيلمين الأصلين (الروسيين)، ذينك المأخوذين عن روايتي دوستويفسكي الأشهر «الجريمة والعقاب» و«الإخوة كارامازوف» على التوالي تحديدا / مع التحية للجميع !!؟